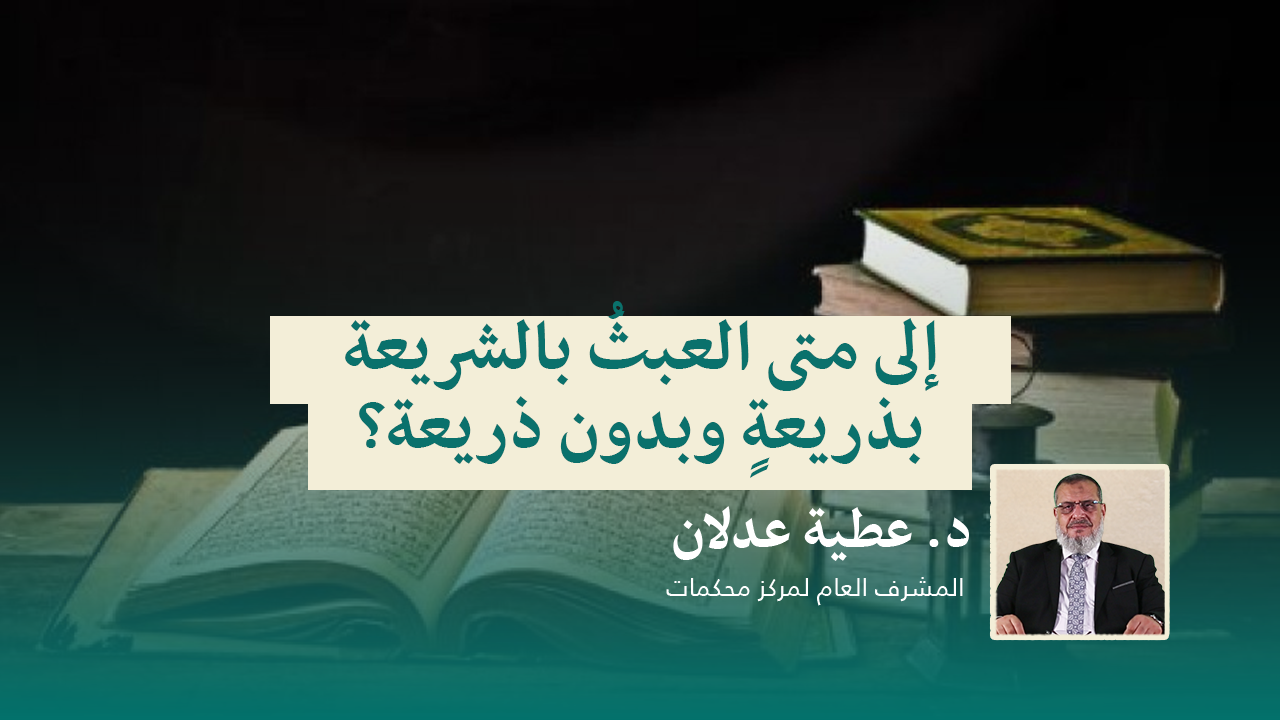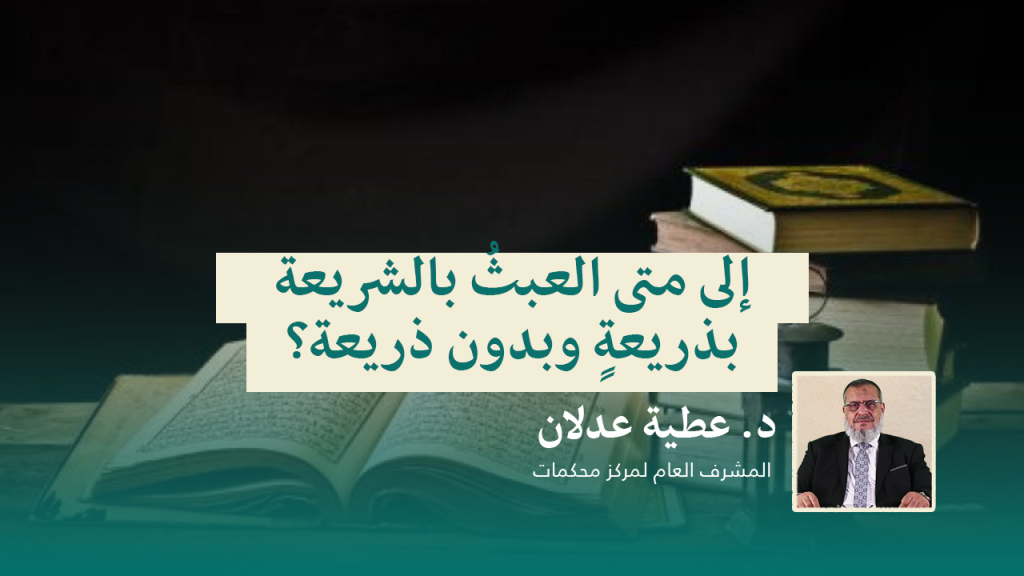
ليس من الحكمة الجريُ وراء المبطلين في كل فجّ سلكوه، لكنّهم عندما يقرعون الثوابت بمطارق الشبهات، من فوق منابر لها طنين مريب؛ وجب التصدّي لهم وكشف زيف ما يدَّعون، ومن هنا كان طبيعيًّا إلى أبعد مدًى أن ينسى المسلمون الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن، وأن ينصرفوا عنه إلى ما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم، وكان طبيعيًّا كذلك أن يلتفتوا إليه ويقذفوه بتعليقات ملؤها القرف والازدراء؛ عندما يعتلي منبرًا أقلّ ما يقال فيه أنّه لا يسعد بالمهنية، ومن فوقه يطلق كمًّا من الترهات والمغالطات التي لا يتحملها عقل ولا يطيقها منطق ولا يقرها شرع ولا دين؛ فإلى متى يعبث هؤلاء بشريعة الإسلام بذريعة التجديد تارة وبحجة مجاراة العصر تارة أخرى؟
ماذا أحدثَ سعدُ الدين الهلالي؟
عندما سأله المحاور عن ميراث الأنثى مع أخيها، أجابه بسؤال مضاد: هل الميراث واجب أم حقٌّ؟ وقبل أن يجيب المحاور عاجله: بل حقّ؛ وصاحب الحقّ أحقّ ببيانه، الناس هم من يقررون ما يريدون، إنْ أرادوا – عن طيب نفس منهم – التسويةَ بين الذكر والأنثى فهل في ذلك ظلم؟ الناس لهم سيادة (وكلّ إنسان ألزمناه طائره في عنقه)، وبالتالي يجوز للحاكم أن يجري استفتاء للناس على هذا؟ وإن اختلفوا فحكم الحاكم يرفع الخلاف، فلمّا واجهَهُ ببيان مجلس جامعة الأزهر طفق يراوغ داخل جمل لولبية لا طرَفَ لها يمكن الإمساك به، ولمّا جابَهَهُ بسؤال عن الحجاب والآيات الواردة فيه ردّه إلى قلبه وفهمه قائلا: استفت قلبك، وإن سألتْك ابنتُك فرُدَّها إلى فهمها وقلبها؛ لأنّه لا وصاية على النصِّ، هذا مجمل ما دار الحوار عليه بين محاور بَدَا مندهشا وشيخ تجلّى منتعشًا منتفشا، وهناك شبهات كثيرة اعتمد عليها سنتعرض لها بإيجاز، وإن كانت لا تستحق الاهتمام، ولكن للضرورة أحكام.
هل يُستفتى الناس على حكم الله؟
هل للعباد رأيٌ تجاه أمر ربّهم؟ وهل النصّ الإلهيّ متروكٌ لكل إنسان يفهمه كيف يشاء؟ وهل للإنسان سيادةٌ في هذه المساحة؟ لا يوجد في دين الله كلِّه من لدن آدم عليه السلام إلى محمدٍ خاتمِ الرسْلِ الكرام شيءٌ من ذلك على الإطلاق، بل إنّ المعلوم من دين الله كلِّهِ بالضرورة يقضي بأنّ الإنسان – الذي كرّمه الله وجعله في الأرض خليفةً وسخر له ما في السماوات والأرض – ليس له في هذا المقام إلا الانقياد والاستسلام: (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً)، ولا علاقة لما أثاره من مغالطة – في هذا المقام البالغ الإحكام – بآية: (وَكُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فِي عُنُقِهِ)؛ لأنّ طائره هو عمله خيرًا كان أم شرًّا، وهذا موضعٌ يكون فيه الإنسانُ مسئولًا لا سائلًا ومحكومًا لا حاكمًا، وليس للناس – منفردين أو مجتمعين – خيارٌ تجاه أمر الله: (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ)، ولو كان النصّ القرآنيّ متروكًا للناس يفهمه كلّ أحد بحسب ما يمليه عقلُه؛ لما كان القرآن بيانًا ولا تبيانًا ولا فرقانًا ولا هدى للعالمين، بل لم يكن لنزوله قيمة؛ لأنّه لو كان كل عقل له الحق في فهم النص كما يشاء لكان الأولى ألا ينزل من السماء نصٌّ أصلا، ولفُوِّضَ الأمر لعقول الناس.
المحكم والمتشابه في آيات المواريث
لم يحالفْهُ التوفيقُ؛ إذْ راح يمارس التأويل فيما يُضرب به المثل لما يستعصي على التأويل، فإنّ الأصوليين إذا ضربوا للمحكم من النصوص مثالًا لم يجدوا أوضح ولا أظهر من آيات المواريث، وطفق يمارس التلاعب بالثوابت، فمثلًا: يدعي أنّ آيات الميراث لم يُعمل بظاهرها إلى نهايتها، لمجرد أنّ خلافًا يسيرًا وقع على استحياء في جزئيتين غائصتين بين جبال المحكمات الراسية، الأولى في نصيب الأم إذا لم يكن للمورث إلا أب وأم وأحد الزوجين (المسألة العمرية)، هل لها ثلث التركة أم لها ثلث ما بقي بعد أحد الزوجين، والجمهور على أنّ لها ثلث ما بقي؛ لأنّها إن أخذت ثلث التركة كلها وكان الوارث مع الأبوين زوج، فإنّ نصيبها سيكون ضعف نصيب الأب، وهذا عكس القواعد العامّة، فوجد عمر في الآية ما يؤيد فهمه ويؤيده القياس، وهو أنّ الله لم يقل في هذا الموضع (مما ترك)؛ فكان لها الثلث ولكن ليس ثلث ما ترك المورث وإنّما ثلث ما بقي للوالدين، الجزئية الثانية في نصيب البنتين، فقد قال تعالى: (فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا مَا تَرَكَ)، وهنا يكاد الإجماع ينعقد على أنّ الإثنتين حكمهما حكم ما فوق الإثنتين، لولا ما روي عن ابن عباس، وهي روايةٌ حَكَمَ ابن رشد وابن عبد البر وغيرهما بعدم ثبوتها، وقد استدل العلماء على ذلك بأنّ الله ذكر هنا نصيب البنات فوق اثنتين، وذكر في ميراث الأخوات نصيب الاثنتين فقط: (فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ)، وثبَّتَ الثلثين في الحالتين؛ ليُستدَلَّ على نصيب البنتين بالقياس على نصيب الأختين، ويستدل على نصيب ما فوق الاثنتين من الأخوات بالقياس على نصيب ما فوق الاثنتين من البنات، وهذا من التربية العقلية في كتاب الله تعالى.
ارفعوا أيديكم عن المرأة
وعبثًا حاول الرجلُ أن يتخذ من ميراث الإبنة مع الابن مدخلًا لإثارة الجدل، ونقول له ولأمثاله: لا تنسوا أنّ الإسلام هو الذي انقذ المرأة وانتشلها من الضياع، وهو الذي أنصفها في كل شيء، بما في ذلك الميراث، فلقد كانت المرأة تحرم من الميراث في الجاهلية؛ فأعطاها الإسلام حقها: (لِلرِّجَالِ نَصِيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ)، بل إن المرأة كانت ذاتُها تورث كما يورث المتاع، فنهى القرآن عن ذلك: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا)، ولم يكن هذا الانحراف قاصرا على جاهلية العرب وحدهم، وإنما عمَّهم وغيرَهم من الجاهليين، فكان القانون الإنجليزي حتى عام 1805 يبيح للزوج بيع زوجته، ويحدد لها ثمنًا “تسعيرة”!
اقرأ أيضا