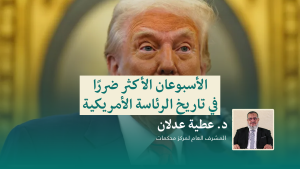بدا لي وأنا أفكر في كتابة هذا المقال أن أتَّجه به إلى المقارنة بين الفكر الإسلاميّ والفكر الغربيّ في موقف كل منهما من الحرية، بل إنَّني سطرت عنواناً بهذا النصِّ: “الحرية بين الفكر الإسلاميّ والفلسفة الغربية” غير أنَّني رغبت في وضع المقارنة على نحو آخر، فبادرت بالعدول إلى هذا العنوان: “الحرية والحرية المضادة”؛ لأسباب تتعلق بالواقع الإنسانيّ وبالممارسة البشرية، ولئلا تفضي المقارنة على نحو يهمل الفطرة الإنسانية العامَّة إلى الوقوع في مغالطة فكرية تقود إلى معاظلة كلامية.
والشعور الذي يملأ كياني – ولعله وثيق الصلة بفكرتي – هو أنَّ الحرية فطرة إنسانية، وهبة ربَّانية، لا تملك حضارة مهما بلغت من المجد أن تدَّعي أنَّها هي التي أنجبتها وحملت بها وأرضعتها، إلا إذا اجترأت على الزعم بأنَّها هي التي وهبت الإنسان الحياة وعبرت به الحدود والسدود من العدم إلى الوجود؛ ذلك لأنَّ الإنسان – جنس الإنسان – وُلِدَ والحرية في لفافة واحدة؛ فإذا وُجِد مستعبداً التقت على استنكار وضعه كل الثقافات والحضارات؛ فتعانقت فوق مفرق رأسه صيحة (الفاروق) مستنكرةً: “متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم احراراً” مع صيحة (روسو) ناعيةً باكية: ” يولد الإنسان حراً، ويوجد الإنسان مقيدا في كل مكان، وهو يظن أنّه سيد الآخرين وهو يظل عبدا أكثر منهم”([1]).
والقناعة التي تملأ عقلي ووجداني أنَّ دين الله الذي جاء به الأنبياء والمرسلون أجمعون من لدن آدم إلى خاتم الأنبياء محمد – عليه وعليهم جميعاً أفضل الصلوات وأزكى التسليمات – بريء من كل ما يناقض فطرة الإنسان أو يخدش حريته، وما عانته الشعوب الأوربية من استبداد وعسف مارسته الكنيسة باسم المسيح، ومارسه الملوك باسم التفويض الإلهي؛ الإله والمسيح منه بريئان، وما عاناه المسلمون كذلك – وإن كان أقل بكثير مما عانته أوربا – بسبب عسف الحكام الذين اتخذوا من البيعة الشكلية ذريعة للتسلط والاستبداد؛ الإسلام والنظام الإسلاميّ منه بريئان.
تقلبات
وما دعاني إلى التفكير على هذا النحو هو ما لاحظته من عبث الفلسفة الغربية – في تقلباتها مع شروط التحولات التاريخية – بمعنى الحرية، فرأيت الحرية في أيدي المدارس المختلفة عصفوراً جميلاً يعشق التحليق في الفضاءات الرحيبة؛ قد وقع في أسر الأيدي البليدة، فإذا به يتنقل من قفص إلى قفص، وقصارى ما تقدمه له هذه الأيدي الآثمة أكوام من المطاعم والمآكل، وهو عن كل ذلك عازف وفي التغريد والشدو زاهد، لأنَّه فضائيُّ المزاج والهوى، ولأنَّ روحه والهواء الطلق كعاشقين اتخذا من الأرض وطاءً ومن السماء غطاءً.
لقد كانت الحرية في أشعار (بترارك)([2]) وغيره – على ما فيها – وفي نثر (الإنسانيين) في بواكير عصر النهضة شذىً لا يُعَرَّفُ ولا يُكَيَّف، كانت وروداً باسمة وأزهاراً ناعمة تُدِلُّ على النسيم وتنفث عطرها في روحه الممتدة المنسابة، فتستنشقها الشعوب في أنحاء القارة الأوربية وتأخذها كما هي بلا تفسير ولا تأويل، حتى جاء (توماس هوبز) فقطفها من بستانها، وضربها مع العقد الاجتماعي في (خلاط) الفلسفة؛ فإذا بالحرية والحكم المطلق كضُرتين أُرغمتا على العيش تحت سقف واحد، تشرب كل منهما من كأس الغيرة وهي لائذة بالصمت.
وعلى هذا النحو ظلت الحرية المسكينة تمزقها الاتجاهات المتعارضة؛ فيُغَرِّبُ بها مِلْ وبنثام وسميث وتوكفيل، ويُشَرِّقُ بها هيغل وإنجلز ونيتشه وماركس، فإذا اجتمع شملها يوماً واتحدت قواها ساعة امتطى الإمبرياليون أصحاب الأهواء وأرباب الأموال والسلطة ظهرها بغرض استعمار البلاد واستحمار العباد، وإخراج الخلق من الأمن إلى الخوف ومن الطمانينة إلى الفزع؛ باسم التحرير والتنوير، وبذريعة: “التحول الديموقراطي!”
قلتُ إنَّ دين الله -كله – من كل هذه الممارسات بريء، وهكذا كان الإسلام، بل إنَّه لمن البخس والوكس أن يكون غاية ما نصف به الإسلام هو مجرد البراءة مما ينافي حرية الإنسان؛ إنَّ الإسلام في جوهره تحرير للإنسان، وإنّ كلمة الإخلاص التي هي رأس الدين هي الحريّة في أسمى مراتبها؛ ذلك لأنَّ الإنسان خلق ليكون عبداً؛ فلا سبيل لتحرره إلا بعبوديته لمولاه وحده بلا شريك، ومن هنا لم يجد المسلمون صعوبة في استلهام هذا المعنى البسيط، ولم يجدوا غضاضة في إطلاقه في سماوات الدنيا بهذه النصاعة: “الله ابتعثنا؛ لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة”
وما شرع الجهاد في الإسلام إلا لهذه الغاية: “الحرية” (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ) (البقرة 193) (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) (الانفال 39).
والفتنة ليست إلا هيمنة الطغيان على الإنسان، وما يترتب على هذه الهيمنة من الحرمان، حرمان العباد من الحرية الحقيقية التي هي الباب الأوحد لدخولهم في دين الله.
القهر على الاسلام
لذلك لم تكن الشعوب في يوم من الأيام هدفاً لسيف الجهاد، ولم يكن قهرها على الإسلام غاية من غاياته، وإنَّما كان المستهدف دوماً هو قوى الطغيان التي تحول بين العباد وبين ربهم بالحيلولة بينهم وبين الحرية؛ لذلك – وبمجرد سقوط قوى الطغيان – يُرْفَع سيف الجهاد، ويتوقف العمل بآياته، ويقال للناس عندئذ: (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ) (البقرة 256) ويبدأ العمل بآيات الحرية التي لم تنسخ قط: (فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ) (الكهف 29) (فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ؛ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ) (الغاشية 21-22) (وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ) (ق 45).
هذه الحرية حقٌّ أعطاه الخالق للعباد؛ فهي من ثمَّ جزء من طبيعته؛ إلى حدِّ أنَه لا يملك التنازل عنه وهو في وضعه الطبيعيّ الذي فطره الله عليه، كما يقول روسُّو: “تَنَزُّل الإنسان عن حريته يعني تَنَزُّلا عن صفة الإنسان فيه، وتَنَزُّلا عن الحقوق الإنسانية … وتَنَزُّلٌ كهذا يناقض طبيعة الإنسان”([3]) ومن ثمَّ تكون الطبيعة الثانية المكتسبة بطول المكث في أغلال العبودية قد غلبت على الطبيعة الأولى التي فطر عليها الإنسان، وهو وضع بطبيعة الحال مقلوب، وكما يقول جون ديوي: ” فالاعتراف بأنّ الناس قد يدفعهم طول العهد بالعبودية والرق أن يحبوا أصفادهم التي تقيدهم اعتراف بأن الطبيعة الثانية – أي الطبيعة المكتسبة – أقوى فعلا من الفطرة الأصلية”([4])
هذه هي الحرية الحقيقية، وهي ذاتها التي استلهمتها من الفطرة الإنسانية روحُ النهضة المعاصرة، في أول بزوغ لشمسها على شواطئ البحر الأدرياتيكي، وفي أصقاع مقاطعات الأرض الواطئة مثل لمبارديا، وفي مدن جنوة وفلورنسا وفينسيا وميلان، ولعل تلك المناطق شرفت بريادة حركات التحرير لكونها كانت حلقة الوصل بين بلاد الإسلام وأوربا، ويشهد مونتجمري وات أنَّه: “في القرن العاشر الميلاديّ نشطت التجارة بين أوربا الغربية والعالم الإسلاميّ، وكان أغلبها يقوم به الإيطاليون ولا سيما المدن القريبة من السواحل مثل جنوة وغيرها”([5]) غير أنَّ دور الفطرة الإنسانية في تفجير عشق الحرية في نفوسهم كان ظاهراً ظهوراً قوياً كذلك.
ومما يؤكد انبعاث هذه الحركة المبكرة عن الفطرة الإنسانية تلك الكلمات التي انبعثت من أحد زعمائها ومفكريها (ليوناردو بروني) وهو يمتدح شعب فلورنسا على جهاده ضد الطغاة: “مواطنونا يبتهجون ابتهاجا عظيماً بحرية جميع الشعوب، لذا فهم الأعداء المطلقون لجميع الطغاة”([6])
هذه هي الحرية الحقيقية، وهي ذاتها التي هتفت بها شعوبنا العربية في الميادين في موجة الربيع العربيّ، وهي ذاتها التي تفور الآن في الصدور وتعتمل في النفوس، برغم الكبت والقهر، وتنتظر اليوم الذي تبرق فيه شرارة الموجة الثانية من موجات ثورة الشعوب المسلمة، لتعبر عن نفسها في أجواء أنقى من الأجواء التي هبَّ فيها الربيع العربيّ، وإنَّه لقريب قرب الفرج الإلهي من العبد الواقع في براثن الشدة والضيق.
الحرية المضادة
أمَّا الحرية المضادة فهي تلك التي عبثت بها المدارس الفلسفية؛ حتى آل الأمر في القرن التاسع عشر إلى أن أخذ معنى الحرية منحى أكثر مادية، وهو حرية الفرد بالنظر إلى كونه كائنا اقتصاديّا، وهو معنى أبعد عن القيم الإنسانية وأقرب إلى القيم النفعية الكمية، وهو المعنى الذي كرّس للرأسمالية العاتية([7]).
وفوجئت الإنسانية المعذبة بأنّ ثورتها وحريتها وقعت فريسة حفنة من المرابين، يملكون الثروة والسلطة، ويسخرون آلات الإعلام لإعادة تفسير الحرية فلسفة وعملاً، حتى آل الأمر إلى أن تصبح المنافسة الاقتصادية هي منتهى أحلام الحرية، والغريب أن يتم ذلك بصورة علمية! ” فإنَّ النظريات الرأسمالية تؤكد أنَّ تأثير المال أمر ديمقراطيّ في آخر تحليل؛ إذ إنَّ جميع الناس يستطيعون في ظل نظام التنافس أن يحصلوا على الثراء وأن يمارسوا به تأثيراً سياسياً، فذلك معنى الكلمة التي قالها (غيزو) رداً على أولئك الذين كانوا يعيبون على الأغنياء أنَّهم يحتكرون السلطة السياسية: “عليكم بالاغتناء”([8]).
وهي ذاتها الحرية المضادة التي سبح فوق أمواجها أصحاب القوارب الخاصة، الذين ما إن سقط مبارك حتى رأيناهم يغدون ويروحون وكأنَّهم هم صناع الثورة ومفجروها، وكأنّ الحرية نَبْتُ حقولهم ونَسْجُ آلاتهم، ولست – للحقّ – أفرق في هذا بين إسلاميين وعلمانيين، ولا بين ليبراليين ويساريين، فالكل امتطى وادعى، وامتشق – بعد انقشاع غبار المعركة – سيفاً من خشب أو رمحا من قصب.
ولست هنا أتعرض لتقييم المشاريع في ذاتها، فقد يكون بعضها بريئاً مما صنعه أصحابه، ولكنَّني أقصد اللحظة التاريخية التي ولدت ووئدت فيها الحرية في آن واحد، اللحظة التي وقع فيها الاختطاف، وإنَّها – لعمر الحقّ – جريمة إنسانية كبرى، وإنَّه لإثم يجازى ببعضه الجميع اليوم، وهو يتمثل على وجه الدقة في تقديم الفرع على الأصل، والأصل الذي قامت عليه الثورات، بل والذي نزلت به الرسالات هو “الحرية” فكان ينبغي أن نحققها وأن نحتاط لها وأن نؤمنها قبل كل شيء.
ولا يزال لديَّ الكثير مما أريد أن أقوله في هذا المقام، ولعل الله يقدر لنا خيراً في مستقبل الأيام، والسلام.
([1]) العقد الاجتماعي – جان جاك روسو – ترجمة عادل زعيتر – مؤسسة الأبحاث العربية – بيروت لبنان – ط الثانية 1995م صــــ 29
([2]) راجع: قصة الحضارة – وِل ديورَانت ت: زكي نجيب محمُود وآخرين – دار الجيل بيروت لبنان – ط: 1988م 18/4-13
(3) العقد الاجتماعي – جان جاك روسو – ترجمة عادل زعيتر – مؤسسة الأبحاث العربية – بيروت لبنان – ط الثانية 1995م صــــ 37
(4) الحرية والثقافة – جون ديوي – ترجمة أمين مرسي قنديل – مطبعة التحرير – مصر – ط 2003م صـــــــ 8،9
(5) راجع: فضل الإسلام على الحضارة الغربية “تأثير الإسلام في أوربا خلال العصر الوسيط” – مونتجومري وات – ترجمة حسين أحمد أمين – دار الشروق بيروت لبنان – ط 1983م صــــــــ 30-31
(6) انظر: أسس الفكر السياسي الحديث (عصر النهضة) الجزء الأول – كوينتن سكنر – ت: د. حيدر حاج إسماعيل – المنظمة العربية للترجمة – توزيع مركز دراسات الوحدة العربية – بيروت – لبنان – ط أولى 2012م صــــــــــــ 164
(7) نقد الليبرالية – د. الطيب بو عزة – ط مجلة البيان – ط أولى 2009م صـــ 151 بتصرف
(8) مدخل إلى علم السياسة – موريس دوفرجيه – ت: سامي الدروبي وجمال الأتاسي – دار دمشق – القاهرة – بدون تاريخ – صــــــــ 174