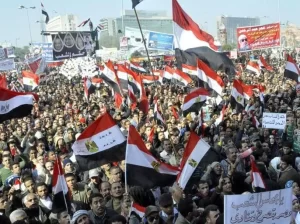يسر الإسلام حجة على الأنام (2)
الدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى على أنبيائه ورسله واحد، هو الإسلام، هو الإسلام والاستسلام والانقياد والاذعان والطاعة والدنيوية لله تعالى بلا شريك، هو عبادة الله وتوحيده.
قال تعالى ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ ﴾[1].
وقال ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾[2].
أما الشرائع العملية التي جاء بها المرسلون فقد تختلف بعض الاختلاف من أمة لأخرى.
قال تعالى: ﴿ لكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً ﴾[3].
ولعل الحكمة في اختلاف هذه الشرائع السماوية هي المرونة ومناسبة الأحوال المختلفة وملاءمة الأزمان والظروف والأطوار التي تمر بها البشرية.
ومن هذا الاختلاف أنك تجد في بعض الشرائع السماوية شيئًا من الشدة والآصار والأغلال – بخلاف شريعة الإسلام – والمثال الظاهر في القرآن وشريعة موسى عليه السلام التي فيها شدة وآصار على بني إسرائيل.
وهذه الشدة بخلاف الأصل في التكاليف الربانية والتشريعات الإلهية.
وذلك لعموم قوله تعالى ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ وِإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴾[4].
فتحريم الله تبارك وتعالى على اليهود كل ذي ظفر -مثل الإبل- وبعض الشحوم كان عقابًا رادعًا على بغيهم، وهذا المفهوم من قوله ﴿ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ ﴾.
وكذلك عقب الله تعالى على ابتلاء أصحاب السبت بظهور الحيتان يوم السبت شرًّعًا بارزة طافية. وهو اليوم الذي حُرِّم عليهم فيه الصيد – بقوله ﴿ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾[5].
فالحكمة إذن من الآصار العارضة هي الابتلاء والعقاب لقوم فسقوا وبغوا وتعدوا حدود الله بعد أن أنعم الله عليهم بالنعم الكثيرة، الابتلاء والعقاب الذي يأخذ بني إسرائيل بالتربية الشديدة التي تناسب وتلائم طبائعهم الملتوية ونفوسهم المنطوية على غش وخداع والتواء.
هنا يبدو الفارق الكبير بين شريعة موسى عليه السلام وشريعة محمد – صلى الله عليه وسلم.
فشريعة موسى عليه لاسلام فيها شدة وإغلال وآصار على بني إسرائيل وشريعة محمد – صلى الله عليه وسلم – هي الحنيفية السمحة كما أخبر بذلك تصريحا عندما قال: ((بعثت بالحنيفية السمحة)).
وما أجمل قول الإمام ابن رجب الحنبلي في كتابة الجامع ” جامع العلوم والحكم” معلقًا على قول النبي – صلى الله عليه وسلم – “الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء”[6].
قال رحمه الله “وأما الصبر فإنه ضياء، والضياء هو النور الذي يحصل معه نوع حرارة وإحراق كضياء الشمس، بخلاف القمر فإنه نور محض فيه إِشراق بغير إحراق” قال الله عز وجل: ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاء وَالْقَمَرَ نُوراً ﴾[7]. ومن هنا وصف الله شريعة موسى عليه السلام بأنها ضياء، ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاء وَذِكْراً لِّلْمُتَّقِينَ ﴾[8].
• وإن كان قد ذكر أن في التوراة نورًا فقال ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ﴾ [9]- ولكن الغالب على شريعتهم الضياء لما فيها من الآصار والأغلال والأثقال. ووصف شريعة محمد – صلى الله عليه وسلم – بأنها نور لما فيها من الحنيفية السمحة؛ قال تعالى ﴿ قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ﴾ [10]. وقال تعالى ﴿ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ ﴾ [11] ا.هـ.
ولذلك نجد سورة الأعراف التي تتحدث حديثًا طويلاً عن بني إسرائيل وعن قبائحهم وفضائحهم، نجدها في آية منها تتحدث عن النبي الأمي محمد – صلى الله عليه وسلم – الذي يجدون صفته عندهم في التوراة وعند النصارى في الإنجيل، تتحدث عنه وعن شريعته السمحة التي تحل الطيبات وتحرم الخبائث بأسلوب فيه إغراء وتشويق لهم ليدخلوا في نور الإسلام المشرق الهادئ الوديع، ويفيئوا إلى ظل الإسلام الوارف الندي.
وفيه أيضًا تلويح بالجائزة الثمينة التي يظفرون بها إن هم فاءوا إلى الحنيفية السمحة، وهذه الجائزة الثمينة وهذا الكسب الرابح هو ان الله تعالى يضع عنهم- بدخولهم في الإسلام- الآصار والأغلال التي كانت عليهم.
قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾[12].
إن هذه الآية التي تلوح لأهل الكتاب بالميزة الكبيرة في الإسلام وتغريهم بالدخول في سماحته لتُصَوِّر الجمال والكمال والباسطة واليسر في هذا الدين العظيم.
هذا الدين الذي يحل الطيبات ويحرم الخبائث.
هذا الدين الذي يضع عن الناس الآصار والأغلال والأثقال.
هذا الدين الذي جاء من عند الله نورًا يهدي من اتبعه سبل الفلاح.
فحقيق بنا نحن أن نفيء الى ظله الوارف من حرِّ المعاصي عندئذ نفلح.
نفلح في الدنيا والآخرة.
وحقيق بنا أيضًا – بل واجب علينا – أن نَهُش على البشرية الضالة في متاهات الملل المحرفة والمذاهب المخرفة، ونسوقها إلى حياض الإسلام العذبة وظلاله الوارفة.
﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ ﴾[13]
[1] النحل 36.
[2] الأنبياء 25.
[3] المائدة 48.
[4] الأنعام 146.
[5] الاعراف 163.
[6] جزء من حديث رواه مسلم عن الحارث بن عاصم الأشجعي.
[7] يونس 5.
[8] الانبياء 48.
[9] المائدة 44.
[10] المائدة 15.
[11] الأعراف 157.
[12] الأعراف 157.
[13] آل عمران 110.