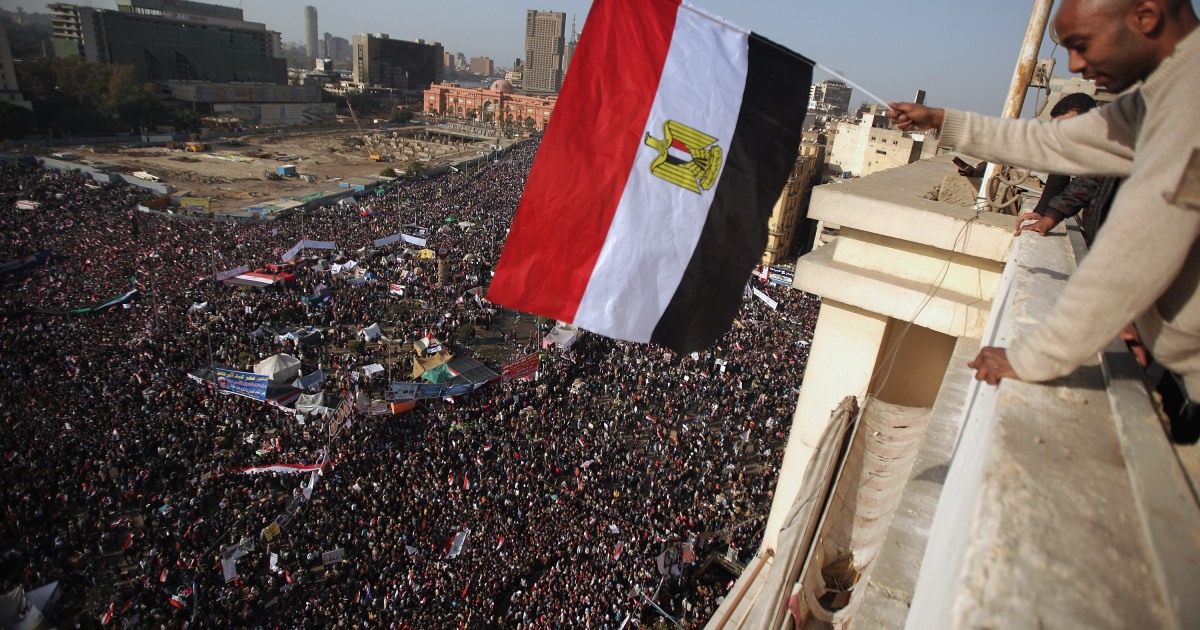هل يجوز أن يجريَ التصالحُ بين الثورة وبين النظام الذي قامت عليه؟ سؤال يبدو للكثيرين مخيفًا وملغومًا ومفخَّخًا؛ لأنّ الإجابة عليه تضع المتطوع بالإجابة والمبادر إليها في مرمى أحد الفريقين اللاذعين في نقدهما: الحالمين المحلقين في فضاءٍ يوشك أن يضيق -على سعته- بأحلامهم الوثّابة، والواقعيين المبالغين في الواقعية إلى الحدّ الذي يكاد الواقع يَخِرُّ من واقعيتهم هدًّا؛ فالأولون يرمون كل من يستخدم مادة (ص ل ح) بالخيانة والعمالة وبيع القضية، والآخَرون ينتقدون كل من يتوقف أو يتحفظ أو حتى يتحوط بالتجاهل لآلام الناس والتجافي عن واقع البلاد واللامبالاة تجاه معاناة المعتقلين وأُسَرِهم.
وقد يكون الحديث عن المصالحة من كافّة الأطراف أحد أسباب الغلو في الاتجاهين المتناقضين الذاهبين إلى أقصى التطرف، فغالب الذين يتحدثون عنها سلبًا وإيجابًا ليسوا في وضع يسمح لهم بالمصالحة مع النظام ولا حتى بالحديث عنها؛ لأنّهم لا يملكون ما يصالِحون به أو يصالَحون عليه، حتى “الجماعة” الكبيرة ولاسيما بعد انقساماتها المتوالية مضطربة في هذا الشأن، فهم ما بين مُتَشَوِّفٍ للمصالحة متهافتٍ عليها، يطرحها في كل مناسبة وبغير مناسبة، وهو خاوي الوفاض مما يفاوِض به أو يفاوَض عليه، لا يستحيي من الردّ والرفض والتجاهل مرة بعد مرة، وآخر مُتَتَرِّسٍ بالتَّمَنُّع من المصالحة؛ ليس لأنّه مناضل مجاهد له رؤية ومشروع تغييريّ حقيقيّ، وإنّما فقط من باب المزايدة والتظاهر بالمحافظة على القيم والثوابت؛ إذْ لم يتبق له ممَّا يحفظ له مقام بين “الأتباع” إلا هذا!!
القواعد الشرعية
لذلك سوف أكتفي بذكر قواعد عامّة شرعية وسياسية؛ تُرَشِّدُ التفكير وتسدد التدبير، وتهيئ لاتخاذ القرارات الصحيحة، دون أن أبادر إلى حسم القضية بالقبول أو الرفض، ليس تحاشيا لسهام الفريقين الغاليين، ولا ضنًّا بالحقيقة التي ربما لم تحسم عندي بشكل كامل، وإنّما لسبب موضوعيّ جدًا، وهو أنّ النَّظر في قواعد التفكير والتدبير واتخاذ القرارات لابد أن يكون سابقا لا مسبوقا، فما هي القواعد العامّة التي تساعدنا على تحديد موقف رشيد من هذه القضية الشائكة المتشابكة؟
أولًا، وقبل كل شيء: ينبغي أنْ نُحَرِّرَ المصطلح مما قد يَعْلَقُ به أو يُحَمَّلُ عليه من المفاهيم التي ليست مقصودة هنا، وربما لا تكون مقصودة كذلك لدى من يطرح اقتراح المصالحة بجدّية، فالصلح مع النظام لا يعني الرضا به ولا بما يفعله، ولا يعني الاندماج في برنامجه أو التحول إلى وجهته، ولا يُقصد به التخلي عن القضية أو إطراحها بشكل مطلق، وإنّما يعني عندنا وعند الجادين في طرح مقترح الصلح، يعني تسوية سياسية على نحو ما؛ بما تتحقق به مصالحُ للطرفين المتنازعين، يصعب تحقيقها إلا بمثل هذه التسوية، أمّا الصلح الذي يُقْصَدُ به ابتداء -أو الذي يفضي إليه انتهاء- ليس التخلي عن القضية، أو الانقلاب على المبادئ والقيم، أو الدعم والتعضيد للباطل وأهله؛ فهذا الصلح ليس مطروحا من حيث الأصل لأنّ فساده ظاهر؛ لمخافته لأصل الفطرة والشِّرْعة.
وثَمّ حقيقة شرعية -وسياسية أيضا- ينبغي أن نُفصح عنها ونبينها بلا تزوير ولا تحوير، وهي أنّ الصلح -في أي سياق أتى وعلى أيّ صورة بدا- لا يكون الحكم عليه بالنظر إلى أنّه صلح، وإنّما بالنظر إلى شروطه وضوابطه وإلى إمكان وروده من حيث الأصل، فالصلح يجوز أو لا يجوز حسب شروطه وبنوده وما تناوله من مواد حاكمة، أمّا بالنظر إلى ذات الصلح فقد أباحت الشريعة -وكذلك السياسة- الصُّلحَ في سياقات عديدة ما دام قد استوفى الشروط وسَلِمَ من الموانع والمبطلات.
وقد عَقَدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلحًا مع قريش، وهو رأس الإسلام وهم رأس الكفر؛ لذلك اتفقت المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، ومعهم الزيدية والإمامية والإباضية؛ على جواز الصلح بين دار الإسلام ودار الحرب، ولولا خلاف الظاهرية وعلى رأسهم ابن حزم لكان إجماعًا، والجواز الذي اتفقوا عليه مشروط بشروط أربعة، لم يختلفوا في واحد منها اختلافا حقيقيًّا، إنّما ورد خلاف يسير في بعضها، أغلبه منقولٌ نقلًا خاطئا ومُتَصَوَّرٌ تصورا خاطئا كذلك، وسوف نستصحب هذه الشروط ونستفيد بها، ولاسيما الشرطين الذين لم يرد فيهما أدنى خلاف.
القاعدة الأولى: “لا يصالح إلا من يصارع”، ولا يجلس على طاولة مفاوضات إلا من تنغرس قوائمُ كرسيه في أرض صلبة لا تمور من تحته، وبغير هذا يكون الصلح صلح إذعان، وعقود الإذعان باطلة وساقطة في الشرع والعقل، وهذا ما يمكن أن نطلق عليه شرط الإمكان، بمعنى أن يكون الصلح ممكنا وواردا، وهو مقدم على شرط المصلحة الذي هو رأس الشروط المصححة للصلح والمانعة من فساده وبطلانه؛ لأنّ المصلحة المتوخاة من صلح الإذعان تكون متوهمة وغير حقيقية، أو مظنونة غير معلومة على وجه يورث الطمأنينة، أو مرجوحة بمفاسد تقابلها أربى بكثير منها، ومن هنا لابد من دراسة مدى إمكان وورود الصلح الذي لا يكون إذعاناً.
القاعدة الثانية: “لا صلح إلا حيث تكون المصلحة ظاهرة وحقيقية”؛ لذلك التقت كلمة جماهير العلماء القائلين بجواز الصلح على اشتراط ظهور المصلحة وتحققها في هذا الصلح، فإذا علمنا أن الظاهرية قالوا بأنّ المهادنات والموادعات كلها منسوخة؛ تحصًّل لدينا إجماع على أنّه لا يجوز صلح حيث تهدر المصلحة، وقد صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا على وضع الحرب عشر سنين، وعلى بنود أخرى اعترض عليها الصحابة، لكنّ الصلح كان فتحًا كبيرًا؛ حيث سمح للدعوة بالانتشار في الأقطار، إضافة إلى مصالح سياسية وعسكرية تحققت؛ فقد كان الصلح بمثابة اعتراف رسميّ بالدولة الإسلاميّة الشابة، وكان تحييدا لقريش ريثما يفرغ المسلمون من خيبر التي كان بينها وبين قريش تواطؤ.
القاعدة الثالثة: “إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا” وهذه القاعدة جزء من حديث نبويّ، أناط مشروعية الصلح بشرط عدم اشتماله على ما يخالف الشرع، والشروط الفاسدة مخالفة للشرع؛ لذلك كان من الشروط المجمع عليها عدم اشتمال الصلح على شرط فاسد، ومثاله في معاهدات السلام العربية الإسرائيلية الشرط الذي يقضي بإهدار أيّ اتفاق سابق يضر بالمعاهدة؛ مما ترتب عليه إهدار أغلب بنود ومواد اتفاقية الدفاع العربيّ المشترك، الذي أقرته جامعة الدول العربية.
والشروط الفاسدة التي يمكن اشتراطها كثيرة، منها: الشهادة على الثورة بأنّها فتنة لا يجوز لمواطن أن يخوض فيها، أو الشهادة لنظام العسكر بأنّه نظام شرعيّ لا يجوز الثورة عليه، أو أيّ شرط آخر يحرم الحلال ويحل الحرام ويبدل الشرع، أو يطمس القيم والمبادئ ويتنكر لها، أو ما شابه ذلك، أمّا الشروط التي تتعلق بالاستطاعة، مثل اشتراط حلّ الجماعة أو الحزب، أو اشتراط عدم المشاركة السياسية والنيابية لمدة معينة أو ما شابه ذلك؛ فإنّه يجوز ويسوغ إذا دعت إليه ضرورة؛ لأنّه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
القاعدة الرابعة: “سِلْم المؤمنين واحدة” وهي عبارة واردة في أول إعلان دستوري في تاريخ الإسلام، في صحيفة المدينة، التي تفرقت موادها في الكتب التراثية وقام بجمعها “حميد الله” في “مجموعة الوثائق السياسية”، وهي تعني -أو تقتضي- أنّه لا يصح أن يفتئت أحد على الناس فيصالح عنهم وهو لم تجتمع عليه كلمتهم، كما لا يصح أن يصالح البعض دون تحسس وتلمس آراء الآخرين، ولا أن ينفرد البعض به؛ بدعوى أنّهم الفصيل الأكبر، أو بدعوى أنّهم أكثر تضررا من غيرهم؛ فالأمة كلها تضررت، بل ربما كانوا هم مصدرا من مصادر هذا الضرر وسببا في وقوعه على دنيا الناس ودينهم، صحيح أنّ الإجماع عزيز، لكنْ -على الأقل- لابد من موافقة أغلبية الناس.
القاعدة الخامسة والأخيرة: (التفريق بين العموم والخصوص) فهذا الذي نتكلم فيه أمر عام وشأن عام، لكن إذا تعلق الأمر بشخص من الأشخاص المتضررين بالأسر أو المطاردة أو غير ذلك؛ فرأى أنّه يريد أن يترخص؛ ليعود لحياته الطبيعية؛ فهذا شأنه، وهو مخاطب بالشرع كذلك، ومحكوم بقواعده وأحكامه، غير أنّ فرصة الترخص عنده أوفر، هذا هو الفارق الأول، والفارق الثاني أنّ الفتوى تختلف من شخص لآخر حسب حاله، والفارق الثالث: أنّ تصرفه يدور في دائرة أحكام الضرورة، التي تنظمها قواعد الضرورة، مثل قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات، وقاعدة: الضرورة تقدر بقدرها، وقاعدة إذا سقط المانع عاد الممنوع، أمّا التصرف العام فهو في دائرة المصلحة التي تنظمها قواعد السياسة الشرعية، مثل قاعدة: اختيار أهون الشرين وارتكاب أخف الضررين، وقاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور، وما لا يدرك كله لا يترك جله، وقاعدة: إذا تعارضت مصلحتان روعيت أعلاهما بتفويت أدناهما، وإذا تعارضت مفسدتان، روعي أشدهما بارتكاب أخفهما، وقاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
وأخيرا فإنّ من علامات الصلح الصحيح شرعا وعقلا وسياسة أن يأتي في أطار فنّ إدارة الصراع، وفي سياق الإعداد لمواصلة النضال، ومن علامات صلح الإذعان أو صلح المخادنة أن يعكس نزعة التولي والإعراض، وأن يترجم روح النأي عن القضية وإيثار القعود، والله المستعان.