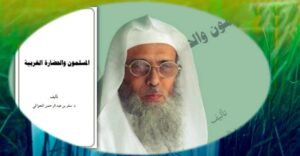لم يرد عن أحد من علماء الأمَّة، سلفهم أو خلفهم، على اختلاف مذاهبهم وتباين مشاربهم، ما يمكن أن يكون مُتَمَسَّكاً للتشكيك في هذه الحقيقة الراسية، وهي أنَّ الجهاد فريضة محكمة. ولا أحسب أنَّ أحدًا من المسلمين الواعين لخطاب القرآن أو المطلعين على هدي خاتم المرسلين وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم يمكن أن تخالجه ريبة أو يراوده شك في أنَّ الجهاد واجب على المسلمين. ومع ذلك نجد أنفسنا مضطرين لتكرار ما قرره العلماء ودونوه؛ فلذلك نتحدث هنا عن حكم الجهاد.
وحكم الجهاد – الذي هو القتال في سبيل الله – أنَّه فرض لازم وواجب محتم؛ “ودليله الأوامر القطعية”[1] الواردة في محكم التنزيل، والقاضية بالوجوب، بدلالات لا تردد في قبولها والعمل بها، كل دليل منها يقترب من القطع في دلالته على الوجوب، لكنها في مجموعها تفيد القطع واليقين وتورث العلم الضروري، وكم من قضية في كتاب الله تعالى حُسِمت وقُطع عنها الشك والارتياب بتعانق الآيات وتضافر دلالاتها، وإن كانت الآية الواحدة منها كافية في الدلالة على المقصود وفي ترتيب العمل والتكليف، وهكذا سنة القرآن الكريم مع المسائل العظام، التي لها بالغ الأثر في أمَّة الإسلام.
ولو أنَّه لم ينزل في كتاب الله تعالى إلا هذه الآية من سورة البقرة لكانت كافية في إلجام المخَذِّلين وإفحام المثَبِّطين، وهي قول الله تعالى: {كُتِبَ عَلَيكُمُ القِتَالُ وَهُوَ كُرهٌ لَكُم وَعَسَى أَن تَكرَهُوا شَيئًا وَهُوَ خَيرٌ لَكُم وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُم وَاللَّهُ يَعلَمُ وَأَنتُم لَا تَعلَمُونَ} (البقرة 216)، فبإيجاز شديد وإنجاز مفيد: (هذا هو فرض الجهاد)[2]؛ فهذا الخطاب الرباني الواضح الصريح (يدل على فرض القتال؛ لأنَّ قوله: {كُتب عليكم} بمعنى: فُرض عليكم، كقوله: {كُتب عليكم الصيام} [البقرة: 186][3]، والإشباع يتجلى في إدغام الأمر المفيد للوجوب داخل سياق يناقش بموضوعية وواقعية مبررات الوجوب، فالله تعالى في هذه الآية (أمر بالجهاد وهو مكروه للنفوس، لكن مصلحته ومنفعته راجحة على ما يحصل للنفوس من ألمه، بمنزلة من يشرب الدواء الكريه لتحصل له العافية، فإن مصلحة حصول العافية له راجحة على ألم شرب الدواء)[4].
وبرغم قوة الدلالة في الآية السابقة؛ أرى أنَّ الأقوى منها دلالة على الوجوب، والأشد منها دفعًا إلى العمل وسرعة الاستجابة هذه الآية العجيبة: {فَقَاتِل فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفسَكَ وَحَرِّضِ المُؤمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا} (النساء 84)، فما أقواها وما أجداها؛ حيث تدل على فرضية الجهاد ووجوبه من وجهين: “أحدهما: بنفسه؛ بمباشرة القتال وحضوره، والآخر: بالتحريض والحث والبيان”[5].
وعظمة القضية تتجلى في أنَّ التكليف بالقتال هنا لا يرتفع وإن انفرد المكلف؛ لأن “في الآية إيماء إلى أنه صلى الله عليه وسلم كُلِّف قتالَ الكافرين الذين قاوموا دعوته بقوتهم وبأسهم وإن كان وحده”[6]، فكأنَّ الآية تقرر الأصل الذي يجب أن يُستصحب ما لم يأت من الله ما يغيره، وهو أنَّ المسلم مكلف ولو كان وحده بالقتال؛ ليكف الله به بأس الذين كفروا، لكن رحمة الله الواسعة اقتضت إدخال الرخصة على هذا الأصل؛ فيُعَلَّق وجوب الغزو إلى حين الاستطاعة، مع بقاء واجب الإعداد له.
وَمَنْ تَفَرَّسَ في السياق علم أنَّ الخطاب إنما هو للرسول ولمن وراءه، يقول ابن عطية: “هذا أمر في ظاهر اللفظ للنبي عليه السلام وحده، لكن لم نجد قط في خبر أن القتال فرض على النبي صلى الله عليه وسلم دون الأمة مدة ما، المعنى- والله أعلم- أنه خطاب للنبي عليه السلام في اللفظ، وهو مثال ما يقال لكل واحد في خاصة نفسه، أي أنت يا محمد وكل واحد من أمتك القول له فقاتل في سبيل الله لا تُكلف إلا نفسك، ولهذا ينبغي لكل مؤمن أن يستشعر أن يجاهد ولو وحده، ومن ذلك قول النبي عليه السلام «والله لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي» وقول أبي بكر وقت الردة: «ولو خالفتني يميني لجاهدتها بشمالي» …”[7].
وهذه آيات ثلاث، جاءت في سورة التوبة التي تأخر نزولها إلى العام التاسع؛ فلم يُنسخ منها حكمٌ، ولم يُقَدَّمْ على ما ورد فيها من أوامر أمرٌ، جاءت متوالية لم يفصل بينها إلا آية تعهد فيها الحق تبارك وتعالى بنصرة رسوله ولو تخلى عنه كل الناس، وهي هذه الآيات البينات: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُم إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلتُم إِلَى الأَرضِ أَرَضِيتُم بِالحَيَاةِ الدُّنيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الحَيَاةِ الدُّنيَا فِي الآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ} (التوبة 38)، {إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبكُم عَذَابًا أَلِيمًا وَيَستَبدِل قَومًا غَيرَكُم وَلَا تَضُرُّوهُ شَيئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ} (التوبة 39)، {انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَموَالِكُم وَأَنفُسِكُم فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُم خَيرٌ لَكُم إِن كُنتُم تَعلَمُونَ} (التوبة 41).
ولقد تنوعت دلالات الوجوب في هذه الآيات وتقاربت، وتعانقت وتضافرت؛ لتنتج حزمة من الإلزامات الجازمة الحاسمة، فمن الاستنكار للقعود والتوبيخ عليه، إلى التهديد على ترك النفير والتوعد الشديد عليه، إلى الأمر المتناول لما خفَّ وثَقُلَ، باستقصاء لا يكاد يترك فسحة للاستثناء، والسبب في نزول هذه الآيات – وهو لا ريب يسهم في فهم المراد وإن كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب – هو ما روي عن ابن عباس أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم استنفر حيًّا من العرب، فتثاقلوا عليه؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية[8]، ولعل هذا كان في غزوة تبوك، لذلك قال المفسرون إنَّها نزلت في الحثَّ على غزوة تبوك[9]، وقد “أورد المفسرون عن السلف أقوالًا في تفسير {خفافا وثقالا}؛ فقال بعضهم: كهولًا وشبانًا، وقال بعضهم: أغنياء وفقراء، وقال آخرون: مشاغيل وغير مشاغيل، وقيل: نِشاطًا وغير نِشاط، وقيل: ركبانًا ومشاةً، وقيل: ذا ضَيعَة، وغير ذي ضَيعة”[10] ، لكنك إن عرفت طريقة السلف في التفسير وجنوحهم إلى ضرب الأمثلة التي يقاس عليها تأكد لك أن جميع هذه الأقوال داخلة في المعنى، واستطعت أن تسحب المعنى ليكون أكثر شمولًا، كما فعل الطبريّ؛ فبعد أن ساق الأقوال قال: “وقد يدخل في [الخفاف] كل من كان سهلًا عليه النَّفر، لقوة بدنه على ذلك، وصحة جسمه وشبابه، ومن كان ذا يُسرٍ بمالٍ وفراغ من الاشتغال، وقادرًا على الظهر والركاب، ويدخل في [الثقال] كل من كان بخلاف ذلك، من ضعيف الجسم وعليله وسقيمه، ومن مُعسِرٍ من المال، ومشتغل بضيعة ومعاش، ومن كان لا ظهرَ له ولا ركاب، والشيخ وذو السِّن والعِيَال”[11].
وكثيرًا ما يتردد أنَّ الآية أو السورة إذا تكرر نزولها – وإن لم يتكرر ذكرها في المصحف- يكون تكرار نزولها هذا دالًّا على جلالة الأمر الذي انطوت عليه، كسورة الفاتحة مثلًا، فكيف إذا كانت الآية قد تكرر نزولها، وتكرر ذكرها بنصها وحروفها في المصحف؟! هذه الآية هي هذه التي تكرر ذكرها بنصها الواحد في الموضعين: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الكُفَّارَ وَالمُنَافِقِينَ وَاغلُظ عَلَيهِم وَمَأوَاهُم جَهَنَّمُ وَبِئسَ المَصِيرُ} (التوبة 73)، {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الكُفَّارَ وَالمُنَافِقِينَ وَاغلُظ عَلَيهِم وَمَأوَاهُم جَهَنَّمُ وَبِئسَ المَصِيرُ} (التحريم 9)، والأصل في الأمر أنَّه للوجوب، مالم ترد قرينة صارفة، والأصل في الخطاب الموجه للنبيّ صلى الله عليه وسلم أنَّه له ولعموم أمته، ما لم يرد ما يقيده أو يخصصه، ولا قرائن قط من أي نوع في هذا الموضع ولا غيره؛ فلا مناص من الوجوب العام الدام المستمر.
والأمر هنا يتسع؛ ليشمل مع الكفارِ الصرحاء المنافقين الخبثاءَ؛ لكونهم تهديد للإسلام ودعوته أشد من تهديد الكافرين، وإن اختلف العلماء في الوسيلة التي يجاهَدُ بها المنافقون؛ أهي القتال أم الجدال، ولعل الأمر – وليس ههنا موضع البسط- يختلف من حال لآخر، فإن لم تقم بينات مادية ينبني عليها قضاء، وكان نفاقهم يُعرف بالمواقف المحتملة، وبفلتات الألسنة والأقلام، وبالتفرس بآلياته المختلفة؛ اكتُفِيَ في جهادهم بالجدال، وإذا قامت بينات يقوم بها قضاء فالحكم عندئذٍ هو حكم الزنديق الذي يُقتل دون أن يستتاب، وإذا كانوا متترسين بشوكة ومَنَعَةٍ وجب قتالهم كطائفة ممتنعة، وإن ثبت أنَّهم ليسوا سوى وكلاء لأعداء الأمة محتلين لبلاد المسلمين بالوكالة وجب قتالهم – حال الاستطاعة وتوقع الظفر – كقتال الكفار؛ ولعل هذا يفيد في توجيه اختلاف العلماء وفي تنزيله على الواقع المختلف زمانًا ومكانًا، وبهذا يمكن التعامل مع اختلاف العلماء في تفسيرهم “قال بعضهم: أمره بجهادهم باليد واللسان، … وقال آخرون: بل أمره بجهادهم باللسان … وقال آخرون: بل أمره بإقامة الحدود عليهم)[12].
وبآية السيف نختم الاستدلال من القرآن – وإن لم تكن آخر الأدلة – ففي صدر سورة براءة التي أرسل بها النبيَّ صلى الله عليه وسلم عليَّا إلى أبي بكر ليؤذن بها في الناس وردت هذه الآية المحكمة: {فَإِذَا انسَلَخَ الأَشهُرُ الحُرُمُ فَاقتُلُوا المُشرِكِينَ حَيثُ وَجَدتُمُوهُم وَخُذُوهُم وَاحصُرُوهُم وَاقعُدُوا لَهُم كُلَّ مَرصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُم إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (التوبة 5)، وبعدها بقليل جاءت هذه الآية متممة ومؤكدة: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِاليَومِ الآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حَتَّى يُعطُوا الجِزيَةَ عَن يَدٍ وَهُم صَاغِرُونَ} (التوبة 29)، وهاتان الآيتان وغيرهما- مما ورد في هذه السورة حاملًا الأمر للمؤمنين بقتال المشركين وأصناف الكافرين- لم تُنسخ قطعًا، والخلاف فقط إنَّما هو في مسألة: هل هي ناسخة لما قبلها من المراحل ومقررة للمرحلة الأخيرة فقط، أم إنها ليست ناسخة ولا منسوخة، وأنَّ العمل ماضٍ بكل آية في الواقع المشابه للمرحلة التي نزلت بتشريعها، والراجح – حسب ما عليه المحققون – الثاني دون الأول؛ إذ لا دليل على النسخ، ومجرد الترتيب الزماني واختلاف تواريخ النزول لا يكفي في القول بالنسخ، ولاسيما في جلائل الأمور.
وعلى التوازي تمضي مع الآيات أحاديث تفيد ما تفيده الآيات؛ ليتكامل الوحيان في إنضاج المحكم وتقريره وترسيخه، فهذا حديث ابن عمر في الصحيحين مرفوعًا: «أُمِرتُ أَن أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشهَدُوا أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُم وَأَموَالَهُم، إِلَّا بِحَقِّ الإِسلَامِ وَحِسَابُهُم عَلَى اللَّهِ»[13]، وقريب منه في الدلالة على ما نحن بصدده ما روي عن أنس بن مالك مرفوعًا: «أُمِرتُ أَن أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا وَصَلَّوا صَلَاتَنَا وَاستَقبَلُوا قِبلَتَنَا وَذَبَحُوا ذَبِيحَتَنَا، فَقَد حَرُمَت عَلَينَا دِمَاؤُهُم وَأَموَالُهُم إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُم عَلَى اللَّهِ»[14].
والمعنى في الحديثين أبين من أن يفتقر إلى بيان، عدا قوله «وحسابهم على الله» فالمقصود بها: حسابهم موكول إلى الله (فيما يستسرون به دون ما يُخِلُّون به من الأحكام الواجبة عليهم في الظاهر)[15]، وكذلك قوله: «إلا بحقها» وهذه فسرها الصديق للفاروق في حديث أبي هريرة الذي يدعم هذين الحديثين في أصل ما يدلان عليه؛ حيث قال له: «فإنَّ الزكاة حقّ المال» وذلك عندما قال له عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أُمِرتُ أَن أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمَن قَالَهَا فَقَد عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ»[16].
وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرًا، ثم قال: «اغزُوا بِاسمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مَن كَفَرَ بِاللَّهِ اغزُوا، وَلَا تَغُلُّوا وَلَا تَغدِرُوا وَلَا تَمثُلُوا وَلَا تَقتُلُوا وَلِيدًا، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ المُشرِكِينَ، فَادعُهُم إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَو خِلَالٍ فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ، فَاقبَل مِنهُم وَكُفَّ عَنهُم ثُمَّ ادعُهُم إِلَى الإِسلَامِ، فَإِن أَجَابُوكَ، فَاقبَل مِنهُم وَكُفَّ عَنهُم ثُمَّ ادعُهُم إِلَى التَّحَوُّلِ مِن دَارِهِم إِلَى دَارِ المُهَاجِرِينَ، وَأَخبِرهُم أَنَّهُم إِن فَعَلُوا ذَلِكَ، فَلَهُم مَا لِلمُهَاجِرِينَ وَعَلَيهِم مَا عَلَى المُهَاجِرِينَ، فَإِن أَبَوا أَن يَتَحَوَّلُوا مِنهَا، فَأَخبِرهُم أَنَّهُم يَكُونُونَ كَأَعرَابِ المُسلِمِينَ يَجرِي عَلَيهِم حُكمُ اللَّهِ الَّذِي يَجرِي عَلَى المُؤمِنِينَ، وَلَا يَكُونُ لَهُم فِي الغَنِيمَةِ وَالفَيءِ شَيءٌ إِلَّا أَن يُجَاهِدُوا مَعَ المُسلِمِينَ، فَإِن هُم أَبَوا فَسَلهُمُ الجِزيَةَ، فَإِن هُم أَجَابُوكَ، فَاقبَل مِنهُم وَكُفَّ عَنهُم، فَإِن هُم أَبَوا، فَاستَعِن بِاللَّهِ وَقَاتِلهُم»[17]، وعَن أَنَسٍ مرفوعا: «جَاهِدُوا المُشرِكِينَ بِأَموَالِكُم وَأَنفُسِكُم وَأَلسِنَتِكُم»[18]، وعن أبي هريرة مرفوعا: «مَن مَاتَ وَلَم يَغزُ وَلَم يُحَدِّث بِهِ نَفسَهُ مَاتَ عَلَى شُعبَةٍ مِن نِفَاقٍ»[19].
هذه الأدلة من الكتاب والسنة جعلت العلماء من كافة المذاهب ينصون نصًا على الوجوب[20]، وجعلت الكثيرين ينصون على الإجماع؛ ليكون دليلًا يضاف للآيات والأحاديث يقطع التشغيب ويورث التسليم، فقد نقل القرطبي عن ابن عطية قوله: “والذي استمر عليه الإجماع أن الجهاد على كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم فرض كفاية، فإذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقين، إلا أن ينزل العدو بساحة الإسلام فهو حينئذ فرض عين”[21]، ويؤكد ابن رشد ذلك قائلًا: “فأما حكم هذه الوظيفة فأجمع العلماء على أنها فرض على الكفاية”[22]، ويدعم الخطيب الشربيني بالنقل عن القاضي عبد الوهاب، فيقول: “وَحَكَى القَاضِي عَبدُ الوَهَّابِ فِيهِ الإِجمَاعَ”[23].
لذلك وغيره لم يُلتفت إلى ما ورد عن بعض العلماء -وهم قلة- أنَّ الجهاد تطوع لا فرض؛ لا لأنَّهم لا يستحقون الالتفات عن أقوالهم، فهم علماء أجلاء وخلافهم إن كان حقيقيًا يعوق الإجماع، لكن لأنَّ العلماء فهموا من كلامهم أنَّهم يعنون أنَّ الجهاد الذي هو فرض كفاية يكون تطوعًا في حق الباقين من المسلمين؛ إذا انعتق الكافَّة من عهدته بتحقق الكفاية بمن قام به منهم، لذلك وجه الإمام الجصاص قولهم هذا فقال: “يعنون به أنه ليس فرضه متعينًا على كل أحد كالصلاة والصوم، وأنه فرض على الكفاية”[24]، وفي موضع آخر قال: “وقد ذكر أبو عبيد أن سفيان الثوري كان يقول: ليس بفرض، ولكن لا يسع الناس أن يجمعوا على تركه، ويجزي فيه بعضهم على بعض، فإن كان هذا قول سفيان فإن مذهبه أنه فرض على الكفاية”[25]، وإلى قريب من توجيه الجصاص ذهب الكمال بن الهمام؛ حيث قال: “ويجب حمله إن صح على أنه ليس بفرض عين”[26]، وبعض العلماء لهم توجيه آخر بحمل كلامهم على حال أخرى: “وأما النافلة من الجهاد فإخراج طائفة بعد طائفة وبعث السرايا في أوقات العزة وعند إمكان الفرصة والأرصاد لهم بالرباط في مواضع الخوف”[27].
والحكم بالوجوب فصَّله العلماء، وبَيَّنوا أنَّه تارة يكون فرض كفاية وتارة يكون فرض عين، فالأصل أنَّهم إذا تكلموا عن الجهاد وعن وجوب القتال وجوبًا كفائيًا فإنَّما يعنون بذلك الغزو، أي يقصدون جهاد الأعداء ابتداء، وهو ما يسميه الفقهاء جهاد الطلب، أمَّا الوجوب على التعيين فهو في حالات أهمها الدفاع عن بلاد المسلمين إذا غزاها الأعداء.
يقول الإمام الشافعيّ مبينًا ومفصلًا للنوع الأول الذي فرض على الكفاية: “فَدَل كِتَاب اللَّهِ عَز وَجَل وَسُنة نَبيه صَلى اللَّه عَلَيهِ وَسَلم عَلَى أَنَّ فرض الجهاد إنما هو على أن يقوم به من فيه كفاية للقيام به؛ حتى يجتمع أمران: أحدهما: أن يكون بإزاء العدو المخوف على المسلمين من يمنعه، والآخر: أن يجاهد من المسلمين من في جهاده كفاية حتى يسلم أهل الأوثان، أو يعطي أهل الكتاب الجزية، فإذا قام بهذا من المسلمين من فيه الكفاية به؛ خرج المتخلف منهم من المأثم في ترك الجهاد وكان الفضل للذين ولوا الجهاد على المتخلفين عنه، قال الله عز وجل {لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة} [النساء: 95]”[28].
ويقول ابن قدامة المقدسي مبينًا النوع الثاني الذي يجب على الأعيان، ومفصلًا الحالات التي يتعين فيها الوجوب: ويتعين الجهاد في ثلاثة مواضع؛ أحدها: إذا التقى الزحفان، وتقابل الصفان؛ حرم على من حضر الانصراف، وتعين عليه المقام؛ لقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا} [الأنفال: 45]، وقوله: {واصبروا إن الله مع الصابرين} [الأنفال: 46]، وقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار} [الأنفال: 15]، {ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله} [الأنفال: 16]، الثاني: إذا نزل الكفار ببلد، تعين على أهله قتالهم ودفعهم، الثالث: إذا استنفر الإمام قومًا لزمهم النفير معه؛ لقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض} [التوبة: 38]، الآية والتي بعدها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم «وإذا استُنفِرتم فانفروا»[29].
ولمزيد البيان نخص جهاد الطلب والابتداء ببعض البيان؛ حيث أساء البعض فهمه والتعامل معه، إلى الحدّ الذي زعم فيه المنهزمون نفسيًا أنَّ الجهاد لم يشرع إلا لرد العدوان، وهذا كلام غريب عن الفقه الإسلامي غرابة الكلاب الضالة في بيوت الله العامرة بالرُّكَّع السُّجود، ولو أنك تصفحت كتب الفقه قاطبة ما وجدت لهذا الزعم متكأً، بل إنَّ الأصل أنهم جميعًا إذا تحدثوا عن الجهاد لم يقصدوا إلا جهاد الطلب والغزو؛ بدليل أنَّهم يتبعون الكلام عن الجهاد بالحديث عن دفع العدوان، وبعد إثباتهم أنَّ الجهاد فرض كفاية ينثنون إلى بيان الحالات التي يتعين فيها؛ فيذكرون ضمن ما يذكرون الدفع للأعداء إذا أغاروا على المسلمين، والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصر.
وسوف نفرد لجهاد الطلب مقالا آخر يتسع لإيراد الأدلة والرد على الشبهات المثارة، لذلك نكتفي بهذا العرض لأصل الفريضة، ونرجئ الحديث عن جهاد الطلب والغزو والفتح إلى مقال آخر إن شاء الله تعالى، راجين من الله التوفيق والسداد. (يتبع)[30]
الجزء الأول، الجزء الثاني، الجزء الثالث، الجزء الرابع
الهامش
[1] البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ومنحة الخالق وتكملة الطوري 5/ 76.
[2] تفسير القرطبي 3/ 38.
[3] أحكام القرآن للجصاص، ط: العلمية، 1/ 389.
[4] الفتاوى الكبرى لابن تيمية 3/ 14.
[5] المصدر السابق 3/148.
[6] تفسير المراغي 5/107.
[7] تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 2/ 86.
[8] تفسير ابن أبي حاتم، محققًا 6/ 1797.
[9] تفسير البغوي، طيبة، 4/ 48.
[10] راجع: تفسير الطبري= جامع البيان، ت: شاكر، 14/ 263-266.
[11] تفسير الطبري 14/ 269.
[12] تفسير الطبري = جامع البيان، ت: شاكر، 14/ 358 – 359.
[13] متفق عليه: رواه البخاري (24)، ومسلم (36).
[14] رواه البخاري (382).
[15] معالم السنن 2/ 11.
[16] متفق عليه: صحيح البخاري 2/ 105 برقم (1399)، صحيح مسلم 1/ 51 برقم (20).
[17] رواه مسلم (3267).
[18] رواه أبوداود في السنن (2147)، والدارمي في السنن (2356)، وأحمد (13375).
[19] رواه مسلم (3540).
[20] راجع: الدر المختار وحاشية ابن عابدين رد المحتار 4/ 122، الكافي في فقه أهل المدينة 1/ 462، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي 2/ 173، الذخيرة للقرافي 3/ 385، الأم للشافعي 4/ 170، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 6/ 8، المغني لابن قدامة 9/ 196، المحلى بالآثار 5/ 340، وغيرها.
[21] تفسير القرطبي 3/ 38.
[22] بداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/ 143.
[23] مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 6/ 8.
[24] أحكام القرآن للجصاص، ط: العلمية، 3/ 147.
[25] أحكام القرآن للجصاص، ط: العلمية، 3/ 146.
[26] فتح القدير شرح الهداية محمد بن عبد الواحد المعروف بالكمال ابن الهمام 5/437، دار الفكر، بيروت، ط: ثانية.
[27] الكافي في فقه أهل المدينة 1/ 463.
[28] الأم للشافعي 4/ 176.
[29] المغني لابن قدامة 9/197.
[30] الآراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن “المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية”.