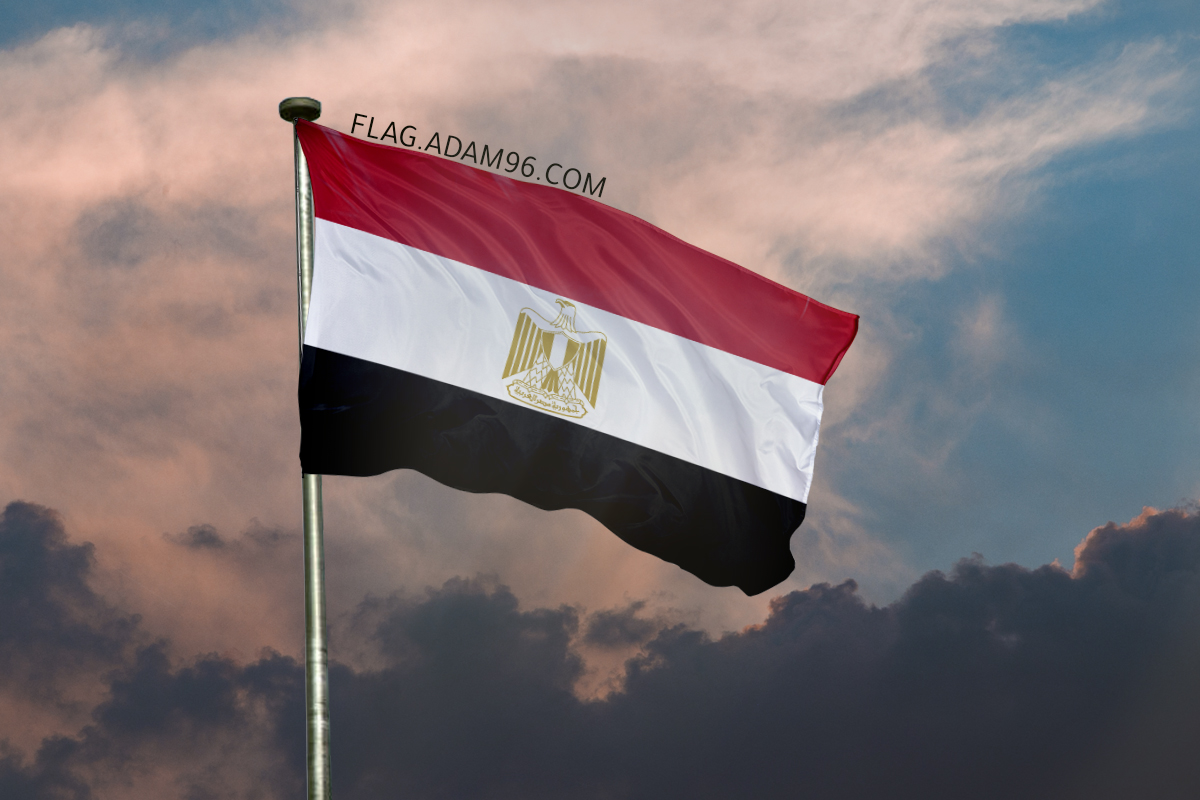اليوم – وبعد خراب الديار وانتشار الدمار – يتجدد بقوة سؤال كان يُطْرح على استحياء: هل كانت ثورات الربيع العربيّ مؤامرةً وخدعة؟ وهل كانت كل هذه الأحداث مصنوعةً موضوعة؛ لإخراج البلاد العربية من أوضاع نكدة إلى أوضاع أنكد منها وأكدر، ونقل الشعوب المسلمة من حياة يفقدون فيها الحرية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم؛ إلى حياة يكفرون فيها بذلك كله لفقدانهم الحياة والأمن وكسرة الخبز؟ وللعدل والإنصاف: ليس على من اعتقد ذلك لوم إذا نظر إلى المشهد العام نظرة كلية فرأى المنطقة برمتها يظللها الموت وتنعق الغربان فوق أطلالها المتهدمة!!
ومع ذلك فالحقيقة تختلف كثيرا عمّا يبدو لكثير من الناس، والحقيقة كذلك أننا نستدعي وعيا حاضرا بأثر رجعيّ ثم نبالغ في جلد الذات، ولو أنّ المشهد بكل فصوله تكرر ألف مرة لما تغير موقفنا في مرة واحدة منها عن موقفنا الذي وقفناه من قبل سواء في أول الطريق أو آخره، ففي أول الطريق سعادة غامرة بالثورة وتلقي لها بالبشر والسرور، وفي آخر الطريق تعاسة طامرة بالثورة ودعوات عليها وعلى الثائرين بالويل والثبور؛ هذه هي طبيعة الأمور، فالثورة إلى أن تستقر وترسو مراكبها على شاطئ النصر والتمكين تمضي في موجات متتابعة، كل موجة منها تعلو وتهبط، فإذا علت وأقبلت ارتفعت همة الخلق واغتبطت قلوب العباد، وإذا هبطت أو أدبرت هبط بهبوطها العزم وإدبر بإدبارها المضاء والحزم.
إنّ الثورة التي رأيناها ورآها العالم ليست من الأحداث التي يمكن أن تُصنع أو تُطبخ في دهاليز المؤامرات والمخابرات، ولو فُرض أنّ الذين أشعلوا فتيلها كانوا مدفوعين إلى ذلك بصورة ما – ولا أحسبهم كذلك أيضاً – فإنّ الثورة بعد إضرامها كانت ثورة شعب، ولا يضرها بعد اشتداد أوارها أن عود الثقاب كان مستعاراً، فليس القول بأنها مؤامرة مصنوعة إلا ضربا من ضروب الخرص والتخمين، إن لم يكن استجابة لدعاوى الشيطنة لكل حركة والمباركة لكل سكون وركون واستكانة، فلنضرب الذكر صفحاً عن هذه الوساوس؛ لنخلص إلى ما يجب أن نخلص إليه.
إنّ الذي صنعه أعداء الأمة ليس صناعة الثورة من أجل تشكيل شرق أوسط جديد كما يقال، وإنما هو على وجه الدقة حسن استثمار للحدث بما يخدم مشروعهم ويعجل بمراحله التي كانت آجلة، وهذا نجاح يحسب لهم وفشل يحسب علينا، ولعل هذا هو طرف الخيط الذي تتدحرج عليه حلقات الفرص الضائعة، فالحدث مادة خام، والكبار هم الذين يرتبون لاستثمار الحدث وتوجيهه، فأين كان الكبار عندما سنحت هذه الفرصة فأهدروها وضيعوها؟ أين كان يعيش العلماء والصلحاء والدعاة والهداة؟ أين كان يتواجد السياسيون الوطنيون والإعلاميون المهنيون والأكاديميون البارزون؟ أين كان كبار الأمة وأهل الحل والعقد منها؟ هذا هو السؤال الذي يكشف عن العلة وراء الفرصة الضائعة، والإجابة عليه يمكن أن تنشئ فرصة أخرى ويجعلها متاحة سانحة.
إنّ الثورة عندما هبت رياحها فاجأت الجميع؛ فإذا هم ينظرون إلى الأحداث فاغرين أفواههم محدقين أبصارهم شاردين بألبابهم، لا رؤية لديهم ولا مشروع، لا مائدة تجمعهم ولا وثيقة توحدهم، وما إن أفاقوا من هول الصدمة حتى وجدوا أنفسهم يسيرون في فضاء الحرية التي هبطت عليهم من السماء كل في طريق، بينما صناديد الباطل قد نظموا صفوفهم وألقوا خلافاتهم خلف ظهورهم وشمروا عن ساعد الجد وأخذوا يرتبون ويخططون ويفعلون؛ لنتحول نحن بكل تحركاتنا إلى رد فعل فقط!!
كان يمكن أن تنتهي الثورة في وقت مبكر، وربما لو كان أعداؤنا يعلمون حالنا لأجهزوا علينا جميعا في عشية أو ضحاها، ولكن الله سلم، فسنحت لنا فرصة ثانية، ها هي الثورة مستمرة في الميادين، ولم تفلح جموع البلطجية في فض الميدان عشية موقعة الجمل، وها هي جموع الشعب تعترف لنا بالفضل والسبق، وتؤكد بكافّة أبواقها على حقيقة نسيت اليوم وما كان لها أن تنسى، وهي أنّ الإخوان المسلمين أنقذوا الثورة في ساعة العسرة، والفرصة هي الالتحام بالشعب وتقوية اللحمة بالشباب؛ ألم نكن نعلم من قبل أن معركتنا مع الأنظمة إنما هي على هذا الشعب؟ ها هو الآن معنا كريش الطاووس حول جسده؛ فلماذا خسرناه، ولماذا بعد سقوط رأس النظام آثرنا أن ننحاز للعسكر؟! لقد كان خطأً فاحشاً أن نخسر من لا ربح لنا بخسرانه، وهذا الخطأ اضطرنا إلى الانجرار إلى خطأ آخر وهو التعجيل بالمسار السياسيّ قبل إتمام الثورة على الأرض، فضاعت الفرصة وخسرنا القوة الوحيدة التي كنّا نملكها وهي الحالة الثورية.
ومع ذلك تداركتنا رحمة الله تعالى، فذهبنا بعد لأي إلى الانتخابات، ولا أستبعد أن يكون ثبات الشباب الذين أسلمناهم في واقعة (محمد محمود) كان سببا في نزول العسكر على رغبتنا لتعجيل الانتخابات التي كانت عرضة للتأجيل والتسويف، وذهب الناس الى صناديق الاقتراع ليصوتوا للإسلاميين، وليمنحوهم فرصة ليست قليلة ولا ضئيلة، فإذا هم يشكلون غالبية المجلس الذي سمي يومها برلمان الثورة، فوالله لو شاء البرلمان لامتلك زمام الأمور ولقاد مرحلة من الثورة داخل أروقة الدولة ومؤسساتها، ولكنه لم يشأ، وظل على مدى ستة أشهر يسن قوانين يعلم أنه لن يملك القدرة على تنفيذها، ويجلد حكومة يعلم أنها ليس لها من الأمر شيء، ونسي أنه برلمان الثورة وعاش دور برلمان الدولة التي اختزلت يومها في العسكر؛ فعصف العسكر بالبرلمان في عشية واحدة عبر مؤسسة هي أعرق مؤسسات الدولة العميقة (المحكمة الدستورية).
لكن شبابنا الذين أُفْرِدوا في الشوارع بعد ضياع اللحمة الشعبية تحملوا عنّا هذا الوزر، ومرة أخرى تتداركنا رحمة الله تعالى؛ ليأتي رئيس للدولة منَّا نعرف صدقه وأمانته وحسبه ونسبه، فماذا فعلنا؟ لا يستطيع أحد أن يحاسبه الآن بعدما صعد شهيدا وأخذ معه أسرار حكمه وقصره، لكننا نستطيع أن نحاسب أنفسنا: ألم نكن جميعاً على علم بما يجري من حولنا؟ ألم يكن الجو من حولنا يظلم يوما بعد يوم؟ لماذا لم نتحرك بصورة ما؟ أين وحدتنا وإعدادنا وقوتنا الاجتماعية؟ لقد كان بوسعنا أن نفعل الكثير في وقت كانت الشرعية لنا والحكم في يدنا.
وهذه فرصة ثالثة أهدرناها، لا تقل الآن إننا أخطانا من الأصل بدخولنا سباق الرئاسة؛ لأننا جميعا إن عاد بنا الزمن للوراء ألف مرة فلن نصنع في كل مرة إلا ما صنعناه أول مرة، لا تقل هذا لأنه وعلى فرض أننا أخطأنا في الخيار فقد كان بالإمكان أن نحول الخطأ إلى صواب والإخفاق إلى نجاح؛ لأن الوصول لرئاسة دولة ليس أمرا سهلا ولا عبثياً، فكم من رئيس استطاع بمفرده من منصبه أن يوسع لنفسه؛ فكيف إذا كان الرئيس وراءه قاعدة شعبية عريضة ومتماسكة؟! كان ينبغي إذ جاء منّا رئيس – بغض النظر عن الخطوة أهي صواب أو خطأ – أن نحكم بأدوات الحكم، وأن نستثمر الظرف في نقل البلاد ونقل أنفسنا معها إلى وضع يعقد الأمور على المجرمين.
وبما أنّ الزمام قد أفلت من أيدينا وصرنا بالحكم على حافة الهاوية ورأينا الأمور تزداد تعقيدا يوما بعد يوم؛ فلماذا لم نخرج على الناس بالدعوة لانتخابات مبكرة ونخرج من أوسع الأبواب وأسلمها؛ لنعود إلى بيوتنا الدعوية والعدو لا يزال لم يكتشف ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على خلق الله أجمعين؟ لماذا أهدرنا هذه الفرصة أيضا والحرب كرٌّ وفرّ؟ وإذ آثرنا المضيّ في طريق (الصمود!) فلماذا لم نتخذ له عدته؟ أو لماذا اخترناه من الأصل إذا لم يكن لنا عدة؟ ومع ذلك فإن رحمة الله تداركتنا فجاءت رابعة على خلاف ما كنا نتوقع وما كان العالم كله يتوقع عددا وقوة واستعدادا للموت في سبيل الله؛ فما الذي صنعناه بهذا المخزون الاستراتيجي الهائل؟ جلسنا نغني ونخطب في ميدان رابعة؟!
فرص تلو فرص ضائعة، فلو أنّ قطيعا من البشر مثلنا كان يتقاضى رواتب من أعداء أمتنا مقابل أن يضيع علينا كل هذه الفرص ما أفلح في صنع ما صنعناه بأنفسنا لأنفسنا؛ فما أحلم الله علينا! وما أشد قسوتنا على أنفسنا وعلى أتباعنا!! والعجيب أننا لا نزال قادرين على تضييع الفرص وإهدار المكاسب، ولا نزال نمارس عن عمد هذا الإهدار وهذا التضييع، ولكن العجيب أننا لا نزال نملك من الفرص الكثير؛ فهل سنضيعها مثلما ضيعنا ما قبلها؟!
لقد خرجنا من مصر ومكثنا في تركيا وقطر وماليزيا وغيرها من بلاد الله ننعم بالأمن والسكون، فلم نفلح في أخذ الخطوة الأولى، التي لا نجاح ولا فلاح إلا بها، وهي أن نجلس معا فندرس أخطائنا ونضع رؤيتنا ومشروعنا لنبدأ بالحركة، ومرت السنون الآمنة المطمئنة، وهبت على الدنيا رياح أخرى منذرة بكثير مما نخشاه في المهجر، ومع ذلك الفرصة سانحة، وما دام في المسلم نفس يتردد فالفرصة أمامه متاحة، نستطيع في غربتنا هذه أن نتوحد إن شئنا وأن نتكتل إن أردنا وأن ننطلق في العمل إن توفرت لدينا النية الصحيحة، وساعتها سوف يفتح الله لنا الأبواب المغلقة.
إننا أمّة صاحبة رسالة عالمية تستهدف الفطرة الإنسانية وتتناغم معها، وإن ديننا هو دين الفطرة، وإن قضيتنا قضية عادلة لا يتردد عاقل عادل في التجاوب معها، وإن الجسد المصري في الخارج ممتد من أقصى الأرض إلى أقصاها، ونستطيع بهذه الإمكانيات الجبارة أن نحول الكوكب الأرضي إلى غربة مظلمة على هذا النظام، وأن نحوله في هذه الأرض إلى قطعة من الخردة ملقاة في فلاة، والعالم الآن لا يعيش في جزائر منعزلة، وليس على وجه المعمورة شعب يعيش منفردا ولا حكومة تحيا كما تشاء دون أن يكون لها شرعية ولو مزيفة، فإذا نجحنا في إحراج القوى الدولية التي تدعم النظام الانقلابي أمام شعوبها فسوف نستطيع فعل الكثير والكثير.
وساعتها يمكن أن يصل صوتنا للداخل، ومع تفاقم الأزمات نستطيع أن نحرك الشعب، وإذا كانت الفرص التي سنحت عند بيع تيران وصنافير أو عند قرارات رفع الأسعار أو غير ذلك فلا يزال النظام غارقا في مؤهلات الفشل والإخفاق، فهل سنستطيع فعل شيء؟ أم إننا سنستمر في إهدار الفرص إلى أن يأتي الاستبدال؟ ونسأل الله العافية، والكلام هنا للكبار، ولاسيما في الخارج، فاللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. آمين