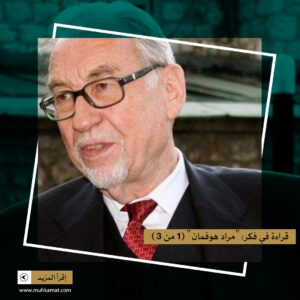بعد هذه الجولة التى تناولنا فيها حقيقة يسر الإسلام في المقالات السابقة، وطفنا فيها على مظاهر هذا اليسر، وقرعناها مظهرًا مظهرًا، ووقفنا عند كل واحد منها متأملين، وبسطنا القول وأسهبنا فى العرض، نعود إلى ذلك السؤال الذى طرحناه بين يدى هذا الموضوع في البداية.
هل ثمً رابط بين ذينك الحديثين: حديث الرجل الذى وقع على امرأته فى رمضان، وحديث الرجل المسئ فى صلاته؟
أما الحديث الأول فهو صورة جلية من صور اليسر الذى بسطنا القول فيه بمقالات سابقات.
فهذا الرجل عجز عجزًا كاملاً عن كفارة خطيئته التى أوجبها الشرع، فلا هو يملك رقبة يعتقها، ولا هو يقدر على صيام شهرين متتابعين، ولا هو يستطيع إطعام ستين مسكينًا. وقد جاء تائبًا وبدا عليه الصدق فى التوبة والندم على السقطة.
وهنا تتداركه – رحمة الله تعالى – هو وأشباهه إلى يوم القيامة. وينطق الرسول – صلى الله عليه وسلم – بحكم السماء، ويقضى بإسقاط الكفارة عمن يقعد به العجز دون القيام بها. ولا يبقى على هذا العاجز إلا ما لا يمكن أن يعجز عنه وهو إخلاص التوبة وصدق الأوبة.
وقد سكب النبى – صلى الله عليه وسلم – على الرجل من فيض الرحمة والتسامح والحلم والترفق والكرم والبشاشة ما أطفأ لظى الخطيئة وجعله ينقلب إلى أهله بأوسق من الثقة والطمأنينة وانشراح الصدر مع أوسق التمر التى رفعها النبى – صلى الله عليه وسلم – على كتفه.
هذا هو الحديث الأول: صورة عملية جلية ليسر الشريعة الإسلامية.
وأما الحديث الثاني فهو صورة لمزية أخرى من مزايا الإسلام بل من مزايا كل دين نزل من عند الله – تعالى، ولا يجهل الناظر المتأمل ما بينها وبين الميزة السابقة من وثيق الصلة.
هذا الحديث الذي يسمية الفقهاء عادة (حديث المسئ فى صلاته) صورة صادقة للجد. الجد الذي لا يدع للهزل أو العبث مكانًا.
هذا الرجل صلى وكأنه لم يصل، نسى أنه فى صلاته يقف بين يدي الملك الجليل، وغفل عن معنى الصلاة ومغزاها، وجهل ركنها الجوهري الذي به تصح، وعليه تعرج إلى آفاق القبول، فراح ينقرها نقرًا بلا طمأنينة ولا خشوع. فلما انصرف من صلاته وهو يظن أنه صلى أقبل على النبى – صلى الله عليه وسلم – يسلم، فرد عليه السلام ورده إلى الصلاة. وتكرر ذلك ثلاث مرات مما يؤكد أن الجد هو طابع هذا الدين الذي به يكون؛ وبغيره لا يكون.
فالجد الصارم فى شريعة الإسلام وفى كل شريعة نزلت من عند الله هو الحقيقة التى يصورها أصدق تصوير حديث الرجل المسئ فى صلاته.
وبين اليسر الذى يتمثل فى الحديث الأول، والجد الذى يتمثل فى الحديث الثانى سبب متين ورابط وثيق.
إن اليسر والجد فى الشريعة الإسلامية صنوان لا يفترقان ولا يختلفان.
اليسر مقدمة للجد، والجد مقتضى لليسر:
اليسر مقدمة للجد، يسقط عذر المعتذر، ولا يدع للمتعلل بابا يدلف منه إلى الانحلال والانفلات، ولا يترك لضعيف الهمة ثغرة ينفذ منها فارا من الجد إلى الهزل والميوعة.
والجد مقتضى لليسر؛ لأن الحمل إذا ثقل ساغ لحامله أن يتحسس مسالك الهروب ويطرق ابواب الانفلات. أما الحمل الخفيف السهل الذى يطاق فلا يستساغ معه الانفلات والهروب، ويكون الانفلات عندئذ موضع الجد واستخفاف بأبعد الأمور عن الهزء.
هذا هو الرابط الوثيق بين الحديثين، قد اتضح، ولم يعد رابطًا بين حديثين وإنما أصبح رابطًا بين حقيقتين كبيرتين وميزتين بارزتين: اليسر والجد.
وقد تحدثنا فيما سبق عن يسر الإسلام بما نحسبه يفى فى هذا المقام، وبقى أن نتحدث عن مقتضى هذا اليسر وهو الجد والإلتزام.
إن الغاية التى من أجلها خلق الإنسان لم تكن إلا عبادة الله – عز وجل -: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [1] وإنها لغاية عظيمة، صبغتها الجد الحازم الذى لا يأتيه الهزل من بين يديه ولا من خلفه. وما أنزل الله الكتب ولا أرسل الرسل ولا شرع الشرائع إلا لتحقيق هذه الغاية وإخضاع العباد لربهم وحده بالدينونة والطاعة ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾[2] وهذا الدين الذى شرع لتحقيق هذه الغاية العظمى بتعبيد الناس لربهم بلا شريك لم يأت إلا من عند الله، ولم يكن له مصدر إلا خالق السموات والأرض. ليس فكرة ينشط لها من ينشط ويقعد دونها من يؤثر القعود، ولا فلسفة تقنع بأذهان تحصلها ولا تطمع فى واقع تتجسد فيه. ولا قانونًا بشريًا يخضع لما تخضع له قوانين البشر من التغيير والتبديل والنسخ والتأويل ويجوز عليه ما يجوز عليها من العصيان والخروج.
كلا لا يكون هذا الدين أبدًا في صورة من هذه الصور ولا غيرها من الصور التي لا تستنكف عن الهزل والعبث.
وإنما هذا الدين هو دين الله من له وحده على عباده السلطان التام والسيادة المطلقة هو دين الملك الجليل الذي تذل له الأعنان وتخضع لأمره الإفلاك ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴾ [3]
فكان لزامًا على عباد الله لأن يأخذوا دينه بقوة، وأن ينشطوا له وينهضوا به بهمة، وأن يلتزموا به بجدية لا يقصمها لهو العابثين ولا يحل عقدتها تراخي المستهزئين.
وإننا نجد أن الله تعالى – برغم ما كان في شريعة موسي عليه السلام من الآصار والأحكام الشاقة التي شاء الله بحكمته أن يقوم بها اعوجاج بني إسرائيل – لم يرض من بني إسرائيل إلا أن يأخذوا هذه الشريعة بقوة العازم على القيام بها بلا تملل ولا تحلحل. فلما التووا نتق الله – عزوجل – الجبل فوقهم حتي وأواه كأنه ظلة وجاءهم الأمر الصارم أن ﴿ وَإِذ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُواْ مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾[4] فكيف إذا كانت شريعة الله – تعالى – يسر لا عسر فيها ولا آصار، سهلة لا شدة فيها ولا حرج؟ إن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – الذي حث على التيسير وحض على التبشير، وشدد في النهي عن التشديد والتنفير، وقبح التنطح وعاب على المتنطعين، لم يرض التهاون ولم يسكت على التفريط. وهذا المسلك من أوضح الأمور في منهجه. والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى، فلا يكاد يخلو منها باب من أبواب الدين حتى صارت طابعًا عامًا، والطابع العام لا يستدل عليه بأجزاء متفرقة أو نتف متنأثرة اللهم إلا على سبيل التمثيل.
فهذه أمثلة تساق بلا اجتهاد في البحث ولا عناء في التنقيب لفرط ظهورها وتبديها:
ألقى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – نظرة ألمت بالمصلين وعادت بخبر المتخلفين عن صلاة العشاء في جماعة. فسرى الغضب في وجهه الشريف، وهم بأمر لم يفعله ولكنة أعلنة على ملأ الحاضرين في مسجدة فقال: ” والذي نفسي بيده لقد هممت أن أمر بحطب فيتحطب، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أخالفه إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم ” [5]
ولما رفع إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – أمر المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده، وثبت عليها هذا الصنيع أمر بقطع يدها. فجاء أسامة بن زيد ليشفع لها عند رسول – صلى الله عليه وسلم-، ولم تكن هذه الشفاعة في هذا المقام محمودة لأنها تخل عقدة شدها الإسلام حفاظًا على المجتمع من أسباب الفساد، ولأنها توهن الحكم الإسلامي وتضيع هيبته وتفتح أبواب التلاعب بأحكام الله تعالى، وهذه لمحة من الجد الذي تتميز به الشريعة الإسلامية أما الشفاعة المقبولة فتكون قبل رفع الأمر إلى الحاكم المسلم أو القضاء الشرعي؛ وتكون بالتعافي والتناصح وستر العورات وإقالة العثرات بين السملين بعضهم البعض، وهذ لمحة من اليسر الذي يوضع في الكفة الأخرى اتجاه الجد ليستقيم الأمر على الجادة والصواب ولذلك قال – صلى الله عليه وسلم -:” تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب”[6].
فلما كلم أسامة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في المرأة المخزومية قال له النبي – صلى الله عليه وسلم – في لهجة حاسمة ” يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ ” ثم قام في الناس خطيبًا ليعلن على ملأ المسلمين أن أحكام الله – تعالى – لا تحابي أحدًا ولا تتملق أحدًا، فقال في رنة عالة علو الحق الذي يعلنه ” إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ” [7] وقطع النبي – صلى الله عليه وسلم – يد المخزومية ألا إنه الجد فوق مفرق الشريعة الغراء تاجًا يعلن عن الوقار وينبئ عن الصرامة.
أما موقفه – صلى الله عليه وسلم – من المخلفين في غزوة تبوك وما تبع ذلك من الوحي السماوي الذي يؤيده في بعض المواقف ويصحح له بعض الاجتهادات فهو من أدل الأمور على أن دين الله – عز وجل – أجَّل من أن يصير قلادة يتحلى بها الإنسان متى أحب ويخلعها ويطوح بها متى كره!
فقد جاء المخلفون من المنافقين يتعللون بعلل واهية ويستأذنون رسول الله – صلى اله علية وسلم – فى القعود فأذن لهم، فلما عاد توافدا عليه يحشدون بين أيديهم المغادير ويسوقون إلية الأيمان المغلظة فقبل منهم رسول الله – صلي الله علية وسلم – علانيتهم ووكل سرائرهم الي الله – تعالى – واستغفر لهم، وينزل الوحى بالبت والقطع والحسم والجزم وقطع الالتواء والميوعة عند هؤلاء.
فقال – تعالى – مصححًا اجتهاد رسوله – صلى الله عليه وسلم – فى الإذن لهم بالقعود قبل أن يبتليهم بالأمر الصارم بالخروج ليفتضح أمرهم ﴿ عَفَا اللّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ ﴾ [التوبة: 43] [8] وقال معلقًا على استغفار نبيه لهم ﴿ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ ﴾ [9] [التوبة: 80] فهؤلاء لن يصح لهم عزم فى أخذ شريعة الله والقيام بها؛ فبم يستحقون المغفرة وهم في هذا الهزل غارقون؟!
وخبر الثلاثة الصادقين الذين خلفوا عن عزوة تبوك أوضح في الدلالة – هؤلاء الثلاثة: كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع – لم يكن لهم عذر في القعود، وإنما قعدت بهم هممهم دون الخروج مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لشدة الحر أو لبعد الشقة أو لكلفة السفر، ولكنهم كانوا في سائر أمور دينهم من الصادققين الجادين، فلما رجع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – صدقوه ولم يستندوا على كذبة يلفقونها ولم يعتمدوا على أيمان باطلة يحلفونها، فماذا كان موقف رسول الله – صلى الله عليه وسلم منهم؟ كان موقفه موقف المربي الذي يريد أن يطبع أمته على الجد والالتزام ويغرس فيها تعظيم شعائر الله.
أمر باعتزال هؤلاء الثلاثة؛ فاعتزلهم الناس حتى تنكرت لهم جلودهم وجنوبهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وشعروا بأن الكون كله يوشك أن يلفظهم من جوفه ويطردهم من بين دنباته، ومرت الأيام تزحف فوق قلوبهم زحف السلحفاة الهرمة خمسون يومًا لا يبش لهم وجه ولا يفتر لهم ثغر ولا يسمعون كلمة تطفئ نار الوحشة التي تأججت في صدورهم، حتى إذا تقلبوا على جمر الندم وتجرعوا الألم تنزل الآيات كأنها غيث تدارك زرعًا أوشك أن يصير هشيمًا: ﴿ وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لاَّ مَلْجَأَ مِنَ اللّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ [10].
ثم يختم الحديث عن أحداث تبوك في سورة التوبة بهذا العتاب الذي يُلِّح في طلب المخلفين عن نصرة دين الله – عز وجل – في كل مكان وزمان: ﴿ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ الأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ اللّهِ وَلاَ يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ ﴾[11].
هذه بعض الأمثلة التي تشير إلى أن هذا الدين طباعه الجد وصبغته الحزم والصرامة، ولكننا في أمس الحاجة إلى أن نتملى هذه الحقائق ونستشفها بعمق حتى تملأ ما بين حوائجنا ثم تؤول الطاقة إلى حركة مباركة.
إن يسر الإٍسلام حجة علينا وعلى سائر الأنام، وما رفع الله – تبارك وتعالى – عنا العنت والحرج إلا رحمة بنا ولكي ننهض بهمة من لا ينوء كاهله بإصر ونسعى بنشاط من لا يعوقه غل ونرتقي ارتقاء من الله عليه بالاجتباء والاصطفاء وهذا المعنى نلحظه من قول الله – عز وجل -: ﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [12].
إن كثيرًا من المستهزئين الغارقين في الغفلة يغترون باليسر الذي يحرفونه عن موضعه ويضيعون الأمر والنهي ويلهثون وراء الفتاوى الرسمية التي شوهت وجه الدين ويتبعون كل ناعق ينعق بما لا يسمع ويهرف بما لا يعرف ويدعوا إلى الانفلات والانسلاخ بحجة أن الدين يسر لا عسر.
هؤلاء المخدوعون يحسبون أنهم مهتدون ويتهمون غيرهم بأنهم ليسوا على شيء ويسمون الالتزام تطرفًا وتشددًا وتنطعًا. ويا ليت شعري هل كان الرسول – صلى الله عليه وسلم – متطرفًا أو متنطعًا – وحاشاه – عندما وجد تمرة في الطريق فقال ” لولا إني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها” [13] أم كان الصديق متشددًا عندما وضع يده في فيه فقاء كل ما في بطنه عندما أخبره غلامه أن هذا الطعام من مال تكهن به في الجاهلية؟![14] أم كان سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأهل القرون المفضلة متنطعين عندما هجروا الغناء هجرهم الخمر ونبذوه نبذهم للأنصاب وسموه (مزمار الشيطان) و (قرآن الشيطان) و (رقية ابليس) إلى غير ذلك من الأسماء التي تدل على استقباحهم له؟!
كلا… ما كانوا متنطعين ولا متشددين ولا متطرفين، وإنما كانوا جادين في التزامهم بالأمر والنهي، معظمين لشعائر الله وحرمات الله.
شعارهم:
﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾[15] ﴿ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ ﴾ [16]، وكانوا يضعون نصب أعينهم ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [17] ولا يكون الالتزام بالحق والدعوة إليه تطرفًا وإرهابًا إلا على مذهب فرعون؛ قال – تعالى -: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ﴾ [18] وما التطرف إلا الوقوف – على الطرف – بعيدًا عن التوسط والاعتدال، والتوسط والاعتدال هو بعينه أحكام الإسلام، فمن زاغ عنها فهو المتطرف حقًا مهما نهق في وجه الملتزمين أو اتهمهم بالتطرف.
وما أوسع البون بين الالتزام والتنطع، ومن أراد نموذجًا للتنطع يقيس عليه؛ فليطَّلع على خبر الثلاثة الذين تحدث عنهم أنس – رضي الله عنه، حيث قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي – صلى الله عليه وسلم؛ يسألون عن عبادة النبي – صلى الله عليه وسلم – فلما أخبروا بها كأنهم تقالوا وقالوا: أين نحن من النبي – صلى الله عليه وسلم – وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدًا، وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا. فجاء النبي – صلى الله عليه وسلم – فقال ” أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟! أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني”[19].
هذا هو التنطيع غلوٌ يخرج العبادة عن حقيقتها كما يخرجها كعنها التفريط والتقصير، لأن الزيادة أخت النقصان كلاهما ينتهي بالدين إلى التغيير والتبديل والتحريف.
أما الالتزام بالأحكام والجدية في أخذ شريعة الإسلام وتعظيم الأمر والنهي فهو التوسط والاعتدال بين الإفراط والتفريط وهو الحق المتزن بين الغلو والتقصير.
إن اليسر الذي قامت عليه الشريعة الإسلامية يستوجب الشكر، وعلى المسلم أن يشكر الله على نعمة الإسلام وعلى نعمة اليسر في شريعة الإسلام، قال تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [20].
ولا يتحقق الشرك بكلمات تقال، وإنما يكون شعورًا يملأ القلب ويترجم إلى وقائع، يكون كله شكرا لله – عز وجل -:
يبدأ الشكر بالاغتباط الذي يملأ القلب ويستقل ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴾[21] ويتولد من هذا الاغتباط تعظيم لشعائر الله – عز وجل -: ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ [22] ثم يتفرع عن الاغتباط والتعظيم حزمة من المشاعر السامية.
يتفرع عنهما الشعور بالرضا والتسليم لكل من أحكام الله – عز وجل – وهذا شعور ضخم يضعه الحق – تبارك وتعالى – شرطًا لتحقيق الإيمان فيقول: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ [23] وتتفرع مشاعر أخرى تتشابك وتتلاحم كلها لتكون البناء النفسي السوي للمسلم الصالح، كشعور الولاء لهذا الدين، والبراء من كل دين غيره، وشعور الاستعلاء بهذا الدين على كل ما تعج به حياة الناس من مذاهب زائفة واهتمامات ساقطة إلى غير ذلك من المشاعر التي يكون بها المسلم في جوهره مسلمًا.
وليس من طبيعة هذه المشاعر أن تنطوي عليها صفحات القلب دون أن يكون لها في واقع الحياة أثر، بل أن أثرها في الواقع هو الدليل الوحيد على وجودها وصدقها. فإذا لم يوجد لها في الواقع أثر فإما أن تكون كاذبة خادعة وإما أن تكون من الأصل معدومة لا أثر بها.
لابد أن تنبعث هذه المشاعر كما تنبعث الأشعة من الشمس، فتملأ الحياة حركة جادة في كل اتجاه حركة جادة تتمثل في مجاهدة النفس وحملها على منهج الله – عز وجل – وتتمثل في مجانبة الفتن والفرار الدائم من مساخط الله عز وجل، وتتمثل في السعي الرشيد إلى إقرار منهج الله – تعالى – في الأرض وتحكيم شريعته وتتمثل في القيام بواجب البلاغ والبيان، هذا الواجب الكبير الذي أشار اليه الحق – تبارك وتعالى – بعد الامتنان على أمة الإسلام بنعمة الإسلام ﴿ وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ* وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [24].
ليس في شريعة الإسلام السمحة مكان للعبث، وليس في ظلالها الرحبة متسع للهزل، ولا يسع الناس إذا اعتنقوا الإسلام دينًا إلا أن يخرجوا من التميع والانحلال الى الجد والالتزام. وإلا فليسألوا أنفسهم، هل خلق الله السموات والأرض وما بينها إلا بالحق؟! وهل خلق الله الناس عبثًا أو تركهم سدى؟! وهل يترك الله – عز وجل – في حياة الإنسان صغيرة أو كبيرة دون أن يحصيها ويقيدها ويحاسب عليها؟
إننا قادمون على أهوال يتبع بعضها بعضا، والقطار يمضي بنا سريعًا لنركب طبقًا عن طبق، ونسلك المراحل بعد المرحلة، فليس أمامنا إلا الاعتصام بمنهج الله والتعلق بحبله – سبحانه – والاستمساك بالعروة الوثقى التي لا تنفصم ﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ﴾ [25]
[1] الذاريات 56.
[2] الانبياء 25.
[3] الحج 8.
[4] الأعراف 171.
[5] رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه.
[6] رواه أبو داود والنسائي والحاكم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
[7] رواه أحمد والنسائي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
[8] التوبة 43.
[9] التوبة 80.
[10] التوبة 118.
[11] التوبة 120.
[12] الحج 78.
[13] رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه.
[14] رواه البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
[15] الحج 32.
[16] الحج 30.
[17] النور63.
[18] غافر 26.
[19] متفق عليه.
[20] البقرة 185.
[21] يونس 58.
[22] الحج 32.
[23] النساء 65.
[24] آل عمران 103-104.
[25] لقمان 22.