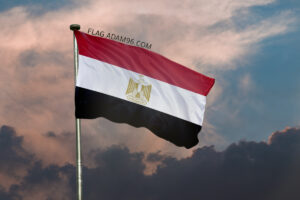لكي نبصر المشهد بتمامه ونلتقط الصورة بكمالها؛ يتحتم علينا أن نأخذ زاوية بعيدة إلى حدِّ ما، وأن نضبط “الزوم” بعض الشيء. ونحن – ولا شك – أحوج ما نكون إلى رؤية واسعة وعميقة؛ لأننا منذ الخامس والعشرين من يناير نجري بلا توقف، فلم ندع جحر ضب إلا ودخلناه ونحن لا نلوي على شيء؛ فلم نصل إلا إلى ما نحن فيه الآن.
انظروا إلى المشهد من أعلى لتروا صاحب الحقِّ الوحيد في كل هذا الزحام قابع في السجن؛ يوشك أن يفقد بصره من شدة المرض ومن تدهور الحالة الصحية، لا لشيء؛ إلا لأنَّ كل هؤلاء الذين يغص بهم المشهد تعاونوا وتواطؤوا على نهب ما في يده والعبث به على هذا النحو الذي تشاهدونه، فما أبعد ما بين طرفي المشهد! وما أعجب حال من لا يرى هذه المفارقة المغرقة في العجب والغرابة!
لن نبصر طريقنا حتى نتوقف لحظة عن الجري واللهث خلف كل مُشَرِّق ومُغَرِّب.. لننظر حولنا؛ فلعلنا نجد مَعْلَماً يهدينا الطريق.. انظروا وردّدوا النظر في حال هذا الرجل الفذّ، واسألوا السؤال الذي نتجاهله وكأنَّ نتيجته أحد مكتسباتنا الطبيعية: أليس من حقِّه أن يأخذ بالرخصة – ولا سيما بعدما انسدت كل الآفاق – فيقبل بما يعرض عليه ليجد نفسه – على أقل تقدير – مستريحا في محبسه آمنا على حياته؟! ما هي القيمة التي تجعله يصبر ويصمد ويستعلي بصبره وصموده على كل المحن؟!
إنَّها الشرعية التي يعرف هو قيمتها ويتحمل وحده أمانتها.. إنَّها المبدأ والمكتسب الذي لم يتحقق لبلد واحد من بلاد العرب قاطبة على مدى قرون عديدة، تشكل في مجموعها ما يسمى بالعصر الحديث! إنَّها الوديعة التي تلقاها على غير رغبة فيها ولا حرص عليها، فعرف قيمتها ووعى قدرها.. إنَّها العقد الذي لم يشأ أن يفصمه من جهته؛ ليلقى ربه وهو مقيم لأمره: “يا أيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود”.
وانظروا في المقابل؛ إلى هذه الضباع التي تتعادى وتتعاوى ويقتل بعضها بعضاً على صيد ما أوجفت عليه ظفرا ولا حافرا.. فهذا غِرٌّ محمولٌ على جناح النزق والطيش، يزيح ويطيح بأوتاد أعتى من صناديد عاد، وليس له ولا لهم ولا لآبائهم وأجدادهم في الحكم أدنى حق، وهذا غراب البين عائد إلى الذل والهوان بعد هجرة دامت سنوات، فلا “عمرة!” قضى ولا كرامة أبقى، وليس هو ولا من تلقاه بالترحيب والترهيب ممن يصلح لقيادة غنيمات في شعب من شعب سيناء المكلومة. وأخيرا، وبعد عمر مديد ركب فيه على ظهر أمته حتى أفناها وأفنى رصيدها في البر والبحر والسهل والوعر؛ يطلع علينا هذا الرجل جثة معبأة في ملحفة، بعد أن أردته رصاصة من “شرذمة حوثية!”، فما بكت عليه حبة رمل بائسة ولا نبتة عشب ضامرة في صحراء بلاده التي حل بها الخراب واليباب.
إنَّ السجن قد وارى خلف جدرانه بدراً افتقدته شعوبنا المنكوبة في هذه الظلماء المدلهمة، وإنَّه لمن أدنى درجات العدل والإنصاف أن نرفع المرفوع وأن نخفض الموضوع، وهذا الحدّ الأدنى لا يتحقق إلا بأن نفارق طريق هؤلاء المردة المفسدين، وأن نلزم غرزه ونكمل الدائرة معه، بأنّ نحيي ثورتنا لاسترداد شرعيتنا، ولا نلتفت لتلك المغريات الزائفة التي يلهينا بها أعداؤنا عن طريقنا.
إنّ مجرد الالتفات إلى ما يسمى بانتخابات الرئاسة؛ خصم من رصيدنا الكبير الذي يحرص الرئيس عليه، ومن شدة حرصه عليه يفرط في نظره وصحته وحياته من أجل ألا يفرط فيه، وإنَّها والله لعبة خبرناها وتمثيلية عركناها، وإنِّهم والله أجمعين لقوم سوء فاسقين؛ فلا تشاركوهم في مسير ولا تلتقوا معهم في طريق، ولا تتعجلوا الوصول، فإنّ الحق لا يستقيم للخفيف العَجول.
إنَّ طريقنا هو الثورة وحسب، بآلياتها التي تفرضها معطيات كل مرحلة، وبمقوماتها التي تبدأ بالثبات على المبدأ وتنتهي بالتضحية من أجله، وهي الطريق الوحيد الذي يوصل إلى المقاصد وإن طال وبعدت، ونحن لا زلنا مرتبكين لا نريد أن نضع أقدامنا عليه ولا نرغب حتى في الخطوة الأولى منه؛ وما ذاك إلا لأنَّنا كثيراً ما تغرينا تقلبات الأحداث فنرجو “السَّمْنَ من ثدي القَمْل”.. فهلا تريثنا فلم نلهث وراء كل ناعق؟!