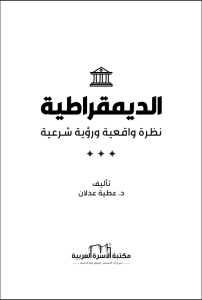الحمد لله .. والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد ..
لا أتوقع أن يقف الدكتور سعد الدين العثماني مكتوف اليدين أمام سيل الانتقادات والاتهامات الموجهة إليه من قِبَلِ علماء الأمة وعامَّتها على السواء؛ فالرجل قد أوتي جدلا ولم يتعود السماع من الآخرين فضلا عن الإصغاء لنصائحهم، وأغلب الظنّ أنّه سوف يستمر في التجديف العنيف الذي درج عليه مدافعاً عن مذهبه الجديد في التطبيع، ولن يعجز عن حشد ما كتبه الأصوليون من قواعد وفرائد ليقوم بضخها في حلزون الحيل، وسوف يحفظ الناس عنه كما حفظوا عَمَّن ركبوا المنزلق قبله قاعدة: “لا ينكر اختلاف الأحكام باختلاف الأزمان”! ولو يعلم القرافيّ والشاطبيّ وابن عاشور رحمهم الله أنّ قواعدهم الكبرى سيتم التلاعب بها بهذه الطريقة الهزلية لما سطروها ولا سهروا الليالي في التأصيل لها! ولتركوها غائمة في سحائب النسيان!
إنّ ما جرى اليوم هو النتيجة الطبيعية لما جرى بالأمس، والحمد لله أن المسافة بين الأمس واليوم، أو بين المقدمات والنتائج لم تطل كثيرا؛ وإلا لطال الالتباس على الناس، فطبيعي جدا أن يؤول التطويع إلى التطبيع؛ لأنّ التطويع منتهى التلاعب بالدين والتطبيع منتهى التلاعب بمصير المسلمين، وأعني بالتطويع ممارسة التأويل لثوابت الدين ومحكماته من أجل إخضاع الإسلام بنظمه وأحكامه لهيمنة الحضارة المعاصرة؛ بذريعة التجديد، وما هو بالتجديد ولكنه التضييع والتبديد، أمّا التطبيع فجميع المسلمين ينظرون إليه بالعين التي ينظر بها الموقوف على منصة الإعدام إلى حبل المشنقة وهو يتدلى إلى عنقه.
ولقد كان لي مع الرجل لقاءات في مناسبات مختلفة، فلم يكن يضيع مناسبة واحدة دون أن يتحدث عن نظريته التي يلح في نشرها وإذاعتها وإقناع الناس بها عبر الكتب والمقالات والندوات والمحاضرات، ولم أستبح لنفسي مرة واحدة أن أسكت عمّا ينسجه من ترهات وما يلفقه من أغاليط، ففي مؤتمر (الدولة المدنية) الذي عُقِدَ في “كوالالمبور” في المدة من 11 إلى 13 نوفمبر 2014م برعاية مهاتير محمد، قدم ورقة قرأها بالنيابة عنه أحد المعجبين بفكره، وكانت بعنوان: “الدولة الإسلامية المفهوم والإمكان”، وكان من قَبْلُ قد عرض بعض ما ورد في هذه الورقة من أفكار في مؤتمر: (الدولة والمجتمع نظرة مقاصدية) وذلك في اسطنبول، وبين ذينك اللقائين وقبلهما وبعدهما كانت هناك مناقشات على هوامش ندوات واجتماعات؛ فكنت دائما منتصبا لمواجهته ودفع مزاعمه؛ حتى ملّني وإن كان قد معي حافظ على شعرة معاوية.
حتى انتهى بي المطاف إلى وضع كتاب صغير لا يجاوز المائة صفحة في الرد عليه، وهو كتاب: (نظرية الدكتور سعد الدين العثمانيّ في السياسة والدولة عرض ونقض) وطبع الكتاب في دار الأصول العلمية باسطنبول، وقبل أن أبدأ بالكتابة جمعت كتبه ومقالاته واطلعت عليها بشكل عميق ودقيق، ومن أبرز كتبه تلك كتاب “تصرفات الرسول بالإمامة الدلالات المنهجية والتشريعية” وكتاب: “المنهج الوسط في التعامل مع السنة” وكتاب: “جهود المالكية في تصنيف التصرفات النبوية”، وله مقالات كثيرة تدور حول هذه القضية التي انبرى لتقريرها وقضى سحابة شبابه في نشرها.
وفحوى هذه النظرية المشئومة أنّ جميع تصرفات النبيّ صلى الله عليه وسلم السياسية سواء بالقول أو الفعل ليست تشريعية؛ بما يعني انتفاء حجيتها، وانتهاء التأسى والاقتداء بانقضاء عصر النبوة، وبما ينتج هذه النتيجة الغريبة: أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كان – إلى جانب النبوة – رئيسا لدولة مدنية! وأن تصرفاته السياسية كلها لا عصمة لها، ومن ثم يسعنا الخروج عن هديه وسنته في هذه الشئون جميعها.
من اللحظة الأولى لم أرَ فرقا بين طرحه وطرح العلمانيين إلا في الشكل، وفي جلسة جانبية على هامش أحد المؤتمرات قلت له بعد نقاش حول مآلات نظريته: ما الفرق – إذْ لَوَّحْتَ لي في هذه الجلسة الخاصة بتاريخية الأحكام – بين نتيجة ما تقول وبين ما طرحه نصر حامد أبوزيد، ثم مازحته قائلا: “مع العلم أن المحكمة في مصر حكمت بالتفريق بينه وبين زوجته” فابتسم ساخرا وقال ما معناه: إنّ مصيبتنا في ممارسة القمع لحرية التعبير، فما الفرق بيننا وبين الأنظمة القمعية؟!!
اعتمد العثماني في تقرير نظريته على جمل انتزعها من السياق انتزاعا، هذه الجمل استقاها من كتب الأصول والمقاصد، ولاسيما كتب الإمام القرافيّ رحمه الله، وكان هذا الإمام العظيم قد اعتمد تقسيما جيدا لتصرفات النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ بغرض ضبط التعامل معها وتنظيم التنزيل لها، فَمَيَّزَ بين تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم بالفتوى وتصرفاته بالقضاء وتصرفاته بالإمامة أو السياسة، فأمّا تصرفاته بالفتوى والبلاغ كأحكام العبادات والمعاملات والأسرة وغيرها مما لا يحتاج الناس في تنفيذها إلى قاض أو إمام فلكل مسلم أن ينفذها دون الرجوع إلى قاض أو إمام، وأمّا تصرفاته بالقضاء كإقامته الحد على الزاني وجلده لشارب الخمر فهذا لا يسع آحاد الرعية أن ينفذوه إلا بالرجوع إلى قاضي الوقت، وأما تصرفاته بالسياسة كعقد الأحلاف والمعاهدات مع الدول فلا يملك أحد من آحاد الرعية القيام بها إلا بالرجوع إلى إمام الوقت، هذه النظرية قررها الإمام القرافيّ رحمه الله في “الفروق” وفرع عليها في “الذخيرة”، وأسهب في تقريرها وبيانها في كتابه الفذّ “الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام”.
وضرب الأمام أمثلة فرعية على ذلك، منها حديث: “من أحيا أرضا ميتة فهي له” فقد اختلف الفقهاء حيال هذا التصرف النبوي، فأمّا الحنفية فاعتبروا الحديث تصرفا بالسياسة والإمامة فاشترطوا للتملك بالإحياء إذن الإمام، وأما الشافعية فاعتبروا الحديث تصرفا بالبلاغ والفتوى فلم يشترطوا للتملك بالإحياء إذن الإمام، وهكذا استمر الإمام يسرد الأمثلة التي يتضح بها قصده من نظريته، إلا أنّ العثمانيّ على طريقته انتزع الكلام من سياقه، وزعم أن هذا التمييز يترتب عليه أن تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم بالسياسة خارجة عن إطار الحجية، وأنّها جميعا ليست تشريعية.
إنّ هذه المحاولات التي تستهدف تطويع النصوص والأحكام؛ لتوافق المنتج الفكري المعاصر وتنضوي تحت هيمنته، تلك المحاولات التي بدأها الترابي وانتهى بها العثماني، محاولات بائسة أفضت بالتجارب إلى واقع أبأس منه، فإذا كانت نظرية الترابي في تمييع الدين قد أفضت إلى فهم متميع وواقع متميع أنبت فسادا متسربلا بالإسلاموية، حتى انتهى الأمر ببعض من تغذوا على فكره أن يلقوا بأنفسهم وبالبلاد معهم في أحضان الصهاينة؛ فإنّ نظرية العثماني أخذته وفريقه بصورة أسرع من التطويع إلى التطبيع.وبرغم أنّ حكم التطبيع مع الصهاينة لا يحتاج إلى بيان لفرط ظهوره وتبديه ولمصادمته الصريحة الصارخة لمحكمات الإسلام وثوابت الملة؛ فإنّ أمثال العثماني وبن بيه وعلماء السوء الدجاجلة أوجبوا علينا التصدي والبيان، فالتطبيع هو إقامة علاقة طبيعية مع العدو الصهيونيّ الذي يحتل الأرض الإسلامية ويطرد منها أهلها المسلمين، ويحاصر المقدسات ويظللها بحكمه الطاغوتي العاتي، ويربض في هذه النقطة المركزية المحورية في كبد الأمة يتربص بها الدوائر ويمثل رأس حربة لأعداء الإسلام في قلب الجسد الإسلاميّ؛ فإذا كانت آيات القرآن الكريم قد أفاضت في إيجاب الجهاد على المسلمين لدفع غائلة المعتدي، وأفاضت في بيان وجوب البراءة منهم وحرمة الموالاة لهم، فكيف والأمر لم يقف عند حد تعطيل الجهاد حتى تعداه إلى جعل العلاقة طبيعية بين المسلمين ومن اعتدى عليهم من الكافرين؟
ولعل الجميع يدرك مخاطر التطبيع مع الكان الصهيونيّ، ولعل الكل يعي جيدا أنّه لم يأت إلا في إطار استراتيجية جديدة للكيان الصهيونيّ مؤداها التوسع الاستراتيجي بدلا من التوسع الجغرافي، وذلك بالتغلغل والتوغل والتغول داخل الجسد العربي والإسلامي، والتمكن من كل مواقع التأثير ومراكز صنع القرار، ولعله لا يغيب عن عاقل أنّ التطبيع قائم منذ زمن بعيد، أمّا الذي يجري فهو الإفصاح عنه وحسب، غير أنّ الإفصاح هذا خطير جد خطير؛ حيث يشرعن له وينقله من كونه عملا مستهجنا يفعل من وراء ظهر الشعوب إلى واقع طبيعيّ، فهو تطبيع لعملية التطبيع.
وفي ظل هذه الأحداث المؤسفة نرى أنفسنا بحاجة إلى الدعاء بأن يثبتنا الله على الحق وأن يقينا الفتن.