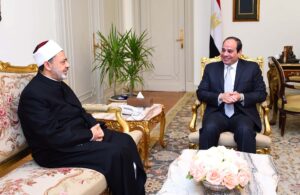الحمد لله .. والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد ..
عجيب أمر هذه الأمة في هذا الزمان! أَمِنْ كثرة الأحزان لم يعد لديها القدرة على أن تفرح؟ أم لكثرة ما وقعت في فخاخ الشِّعاب المهلكة صارت تتلفت حولها وهي تمضي في الطريق الآمن اللاحب؟! أم إنّه كما يقول المثل المصريّ البسيط: (اللي اتلسع من الشربة ينفخ في الزبادي)؟! وبرغم ما ينتابني من عجب ويصيبني من دهشة أتفهم الوضع الاستثنائيّ هذا وأتقبل ما يجري على أنّه حالة مرضية لن تطول وعمّا قريب سوف تزول، لكنّ الذي يبعث على القلق ويثير الاشمئزاز هو ذلك الانزعاج الذي يبديه ولا يخفيه بعض “مثقفي الإسلاميين!” ممن يسطرون بأقلامهم أشعارا في الهيام بالنموذج الغربيّ؛ كأنّهم يخشون على المكتسب الحضاري الإنساني الذي تحقق للبشرية من أولئك البدو الخشنين الذين أسقطوا “حضارة كابل!” وصاروا يهددون ب”راديكاليتهم” حرية المرأة وقواعد اللعبة الديمقراطية!
يقولون: صفقةٌ! فلتكن صفقةً، وما العيب في ذلك؟! ومَنْ لي بصفقة كهذه نتمكن بها – ليس من حكم مصر أو سوريا أو ليبيا أو اليمن أو العراق أو لبنان أو تونس – وإنّما – فقط – إخراج المعتقلين، ورد المغيبين، واستنقاذ المحكوم عليهم بالإعدام، وعودة الدعاة إلى مساجدهم، والمطاردين إلى بلادهم، إنّ عالم السياسة سوق كبير تتصارع فيه السباع والضباع، ويقوم كله على صفقات تتلاقى فيها المنافع، ويكون التبادل فيها بالصلحة لا بالدرهم والدينار، ولقد كان صلح الحديبية صفقة رآها جُلُّ الصحابة تنازلاً وإعطاءً للدَنِيَّة، قبل أن تكشف الأحدداث عن حجم المكاسب التي كانت كامنة وراء غشاء رقيق من المفاسد والتنازلات التي غطت على المشهد آنذاك.
لست أخشى من الطالبان، وإنّما أخشى عليهم، لست أخشى من الطالبان على أفغانستان ولا على مستقبل وسمعة العمل الإسلاميّ، لست أخشى منهم؛ لأسباب عديدة، أولها: أنّهم محلٌّ لإحسان الظنّ بهم؛ فهم الذين تخرجوا جميعا من المدارس الشرعية الديوبندية المشهورة باستقلالها وعبقرية سياساتها التعليمية وحسن تربيتها واستقامة مناهجها، وهم أحناف ماتُريدية ليسوا أهل بدعة ولا ضلالة، نختلف أو نتفق معهم في فروع من الفقه والعقيدة كما سائر الناس من أهل السنة، لكن لا نبدعهم ولا نضللهم، وثاني هذه الأسباب أنّ جهادهم ورباطهم وثباتهم صار حديث الركبان، من جهة القوة والتأثير ومن جهة المثابرة وطول النفس ومن جهة النظافة وعدم التدنس، ومن جهة الوعي الحركي والنضج العسكريّ، والقدرة الخارقة على المناورة وحسن إدارة الصراع، وثالث هذه الأسباب أنّهم ظهروا بما كان متوقعا منهم، حيث بسطوا يد العفو وترفعوا عن الانتقام والتشفي، وأشاعوا الأمن والطمانينة الحقيقية في البلاد.
وأمثال هؤلاء لا نخشى منهم على شيء من الحق والخير، أمّا أنّ أمريكا لم تخرج إلا في إطار صفقة، وهذه الصفقة ستكشف الأيام عنها، وأمريكا لا تقبل أن ينكسر أنفها أمام تنظيم جبليّ، وما إلى ذلك من التوجسات والتوجعات التي تشبه أنين المتمارضين؛ فإنّها ليست بشيء، فالواقع أنّ أمريكا نفسها تعلم أنّ أنفها قابل للكسر وأنّه قد كُسِرَ كثيرا من قبل، ولكنّها تعرف – كما كل كبير – كيف تخرج الهزيمة بشكل لا يكسر كبرياءها ولا يدمر سمعتها، لكن لنسلم بأنها لم يكسر أنفها ولم تنهزم أمام الطالبان – مع أنّ ذلك ليس بعيدا – فالصراعات الآن ليست بهذه الحدية التقليدية: إمّا نصرٌ ساحق وإما انهزامٌ ماحق، هناك صفقات يتم بها إنهاء الصراع عند نقطة معينة، يحقق فيها كل طرف من الأطراف أقصى ما يمكن تحقيقه من المكاسب بالنسبة له، ولا يلزم من كونها صفقة أن تكون خيانة أو تنازلا عن مبدأ، ولاسيما إذا كان الطرفان يملكان أوراق ضغط حقيقية.
وإنّما أخشى على الطالبان، أخشى عليهم أولا من ذلك القفص الحديدي المسمى بالنظام الدوليّ أن يطبق على عظامهم ونظامهم؛ فيختنقون ويعجزون عن الحركة، فمما لا شك فيه أنّ الدول في محيط ما يسمى بالمجتمع الدوليّ كقوارب صيد في بحر ملئ بالقراصنة، إن تآمر البحر بما فيه على قارب منها وهاجت عليه أمواجه وتكالبت عليه القراصنة وأتباعها فكيف له السبيل إلى النجاة فضلا عن اكتساب القوت الذي لا سبيل إليه إلا بخوض هذا البحر وخوض الصراع أيضا فوق أمواجه، وها هو العالم المنافق اليوم يتنادى ويتداعي ويقوم ويقعد ويتربص ويتلبط؛ ويتسائل: ماذا سنصنع مع الطالبان؟
وأخشى عليهم ثانيا من ثقل التبعة التي يمكن أن تقتلهم وتفنيهم دون أن توجه ضدهم رصاصة واحدة، إنّنا لطول انتظارنا للحظة النصر على عدو طال قهره لنا نتصور أنّ النصر العسكريّ هو آخر التحديات، فننسى في غمرته ما وراءه من التحديات الجسام، إنّ هذا النصر العسكريّ الذي حققته طالبان برغم عظمته وأهميته لا يمثل إلا قدرا يسيرا من التحديات، إنّ التحدي الأكبر يتمثل في إقامة الدولة وتأسيسها على أنقاض نظام لم يبق منه إلا ركام وحطام، تحته تسكن الأفاعي في جحور كالفخاخ، ويتمثل في تأمين بلاد شاسعة ممتدة وبيئة قبلية خشنة قد طال عهدها بالعصابات المسلحة والصراعات التي لا تفتر ولا تهدأ، ويتمثل في إطعام شعب استبد به الفقر والجوع والحرمان على مدى أربعة عقود أو يزيد، ويتمثل في علاج أدواء الجهل والفقر والمرض والقبلية والعصبية وغير ذلك.
إنّ الطالبان اليوم في عالم السياسة وإدارة الدولة كطفل ولد عبقريا فذا، ولكنه في النهاية طفل يحبو؛ بحاجة إلى من يأخذ بيده ويمضي معه في الطريق الوعر وسط أدغال المجتمع الدوليّ، وأن يسلك به في بداية عهده بالحياة السياسية السبل الوعرة الملية بالفخاخ وقطاع الطريق، فإن لم يجد هذه الصحبة فلا شك سيتعثر سيره وتتبعثر في الطريق خطاه، وهنا يكون لزاما على الطالبان أن تفتح علاقات طيبة مع أصدقاء في هذا المحيط المطلاطم المسمى بالمجتمع الدوليّ، ويكون لزاما على بعض الدول المسلمة كتركيا وباكستان وماليزيا أن تمد لها يد العون، وأن تبادر إلى عقد الشراكات معها في ميادين عديدة.
وخطورة التجربة الطالبانية المقبلة تتمثل في حاجة الساحة الإسلامية إلى نموذج يحتذى، فالأمة – وإن كانت تعيش الآن حالة من الهزيمة غير مسبوقة – ينتظرها زمان وشيك تستعيد فيه ثورتها وتعيد بها مكتسباتها، لتبدأ مسيرة البناء، بناء الدولة، وبناء الاقتصاد، وبناء المنظومات الحضارية كافّة، وإنّنا متفائلون بهذه التجربة، ومستبشرون لها، وعمّا قريب ستأتي الأنباء من كابل بالخير الكثير، ولا ننسى أنّ الله تعالى وليّ المؤمنين المحسنين الصابرين، (إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ) (النحل: 128).