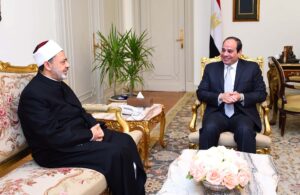شهدت القرون الوسطى التي امتدت من القرن الخامس إلى القرن الخامس عشر واقعين مختلفين أشد الاختلاف، بينهما كما بين الظلماء والضياء، الواقع الأول هو واقع أوروبا تحت السلطان الكنسي، الواقع الثاني هو واقع العالم العربي الإسلامي تحت سيادة الشريعة الإسلامية الغراء وفي ظل الحكم الإسلامي الرشيد.
أوربا في العصور الوسطى:
فأما أوربا فشهدت طغياناً سياسياً، تمارسه الكنيسة باسم الدين، يقابله ويمضي معه على التوازي طغيان يمارسه الأباطرة والملوك والإقطاعيون، وتنازع طغيان الكنيسة وطغيان القصر الأمر والحكم والسلطان؛ حتى نشأ ما سمي بـنظام السلطتين (السلطة الدينية والسلطة الزمنية) وتم التقعيد للسلطتين بالنظرية التي سميت بعد ذلك بنظرية (السيفين)، وهي النظرية التي تنظم عمل السلطتين، وتحدد سلطات كل منهما.
ولم يقع هذا هكذا بين يوم وليلة، وإنما استغرق زماناً شهد معارك باردة بين الجانبين، ففي البداية – كردٍّ للجميل – دعت المسيحية إلى طاعة الحاكم، واعتبرت أن عصيان الحاكم عصيان للرب، ونسبت إلى المسيح قوله:” دعوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله ” وفي العهد الجديد كتب بولس:” لتخضع كل نفس للسلاطين؛ لأنه ليس سلطان إلا من الله، والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله؛ حتى إن من يقاوم السلطان فهو يقاوم ترتيب الله”، وبهذه الجبرية بدأت فكرة الحق الإلهي والحكم باسم السماء، والاعتقاد بأن الملك ظل الله في الارض، بدأت هذه الأفكار تصبغ الفكر السياسي الذي صاغته يد الكنيسة.
وتأكيداً على هذا المسلك ذهبت الكنيسة إلى أن الناس لا يجوز لهم نقد الحكام باللسان؛ “فما ينبغي أن تكون أعمال الحكام محلاً للطعن والتجريح بسيف اللسان، حتى لو ثبت أن هذه الأعمال تستحق اللوم، ومع ذلك فإن أقل ما ينبغي – إذا انزلق اللسان إلى استنكار أعمالهم – أن يتجه القلب في أسف وخشوع إلى الندم والاستغفار؛ التماساً لعفو السلطة العظمى التي ما كان الحاكم إلا ظلاً لها في الارض ”
هذا هو المهر الذي قدمته الكنيسة في نكاح المصالح المشتركة بينها وبين الإمبرطورية الرومانية؛ فإذا كانت فكرة الإمبراطورية العالمية مستعصية التحقيق لافتقارها إلى رابط قويٍّ يجمع شتات الخلق المختلفين في أجناسهم ولغاتهم وعرقياتهم؛ فإن المسيحية – كدين يعطي ما لقيصر لقيصر ويلزم الرعية بطاعة السلطان الذي اكتسب من السماء حق طاعة هذه – هي ذلك الرابط القويّ، ولا مانع – من ثمَّ – أن تترك الإمبراطورية ما لله لله؛ لتقوم الكنيسة جنباً إلى جنب بجوار الدولة.
ومن هنا نشأ الولاء المزدوج في حس المسيحي، وصار خاضعاً لنوع من الالتزام الثنائي؛ ثم تطور الأمر حتى ” أصبح الطابع المميز للفكر المسيحي – كما تطور واستقر في عصر الآباء – هو القول بوجود ازدواج في تنظيم الجماعة الإنسانية ومراقبتها؛ بغرض المحافظة على أعظم مجموعتين من القيم الخلقية؛ فشئون الروح والخلاص الأبديّ هي اختصاصات الكنيسة ومجال تبشيرها وتعاليمها، ويقوم بها القسس، أما مجريات الأمور الدنيوية اليومية والمحافظة على السلام والنظام والعدالة فهي اختصاص الحكومة المدنية … وكثيراً ما أشير لهذا التصوير الفكري لعلاقة هاتين المجموعتين من القيم الخلقية باسم نظرية (السيفين) أو (السلطتين) “. ([1])
وكان من أبرز المفكرين السياسيين في العصور الوسطى: إمبروز وأوغستين وجريجوري، الأول في النصف الثاني من القرن الرابع والثاني في القرن السادس والثالث هو الذي كان يطلق عليه أبا البابوية في العصور الوسطى، وفكر هؤلاء الثلاثة أصل للآتي: الولاء المزدوج، وسيادة الكنيسة واستقلالها في الشئون الروحية، وأن طاعة الحاكم تستمد من كونه ظل الله في الأرض، وأن دول الكومنولث يجب أن تكون مسيحية.
والذي ينسب إليه التأطير الفلسفي للولاء المزدوج هو (جلاسيوس) الذي وضع نظرية السيفين، ونص فيها على وجود سلطتين: السلطة الزمنية والسلطة الروحية، فالروحية لشئون الدين والزمنية لشئون الدنيا، وكلتاهما تخضع للقانون السماوي والقانون الطبيعي، ومرد هذا كله إلى الله الذي قضى بأن يكون للمجتمع المسيحي رأسان: البابا والملك، وأن يكون لكل منهما مجال سلطانه، الذي لا يتداخل مع الآخر.
غير أن هذا التعايش السلمي بين السلطتين لم يدم طويلاً؛ وما كان له أن يدوم، فما إن كشرت السلطة الزمنية عن أنيابها وحاولت التوسع على حساب السلطة الروحية؛ حتى رأينا الأخرى تسعى بجد – مستخدمة سلطانها الروحي الكبير على شعوب غلب عليها الجهل، ومستحضرة شبح الماضي الذي عانت منه في ظل الاضطهاد – تسعى إلى الاستحواذ على السيادة، على حساب قرينتها، وها هي الكنيسة التي قالت في بداية أمرها مع القياصرة: دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، ها هي لم تدع ما لقيصر لقيصر ولم تجعل ما لله لله، فما لله – على الحقيقة بقطع النظر عن فهمهم الخاطئ – هو أن تتحقق سيادة شريعته؛ بأن تكون هي المرجعية العليا للجميع، وما لقيصر – على الحقيقة بغض النظر عن قصور فهمهم له – هو أن يسوس الناس على وفق هذه المرجعية الربانية، ويكون له الطاعة بذلك على رعيته، لم يحدث شئ من ذلك على الإطلاق حتى نفسح في نفوسنا مساحة لحسن الظن بذلك الشعار الذي نسبوه إلى المسيح عليه السلام، فلا قيصر ساس الناس على وفق شريعة من الله، ولا الكنيسة كان عندها – من حيث الأصل – شريعة تقدمها لتجعل الأمر لله، ولا أحداً منهما وقف عند حده فيما جعله هو لنفسه، وإنما كان التدافع والتنافس والتواثب الذي انتهى ببغي الكنسية وتجاوزها كل الحدود.
لم تدع الكنيسة ما لقيصر لقيصر، ولم تجعل ما لله لله – حتى على الفهم الخاطئ لهذه القسمة – ولكنها اغتصبت ذلك كله؛ فحكَّمت أهواء رجال الكنيسة، وجعلت حكمهم هو حكم السماء، ومن خرج عنه كان كافراً مرتداً مهرطقا، فالويل لمن وقف في وجهها أو عارض حكمها.
واستطاعت بما لها من سلطان روحي أن تضلل العامة وأن تكسبهم لصفها، وأن تستقوي بهذا السلطان الروحي على الملوك والأباطرة، فأذلتهم وأسجدتهم لجبروتها؛ كيف لا ورجال الكنيسة هم الذين لهم السيادة العليا؛ لكونهم ممثلي الله في الأرض؟!
أصدر البابا (نقولا الأول) بيانا قال فيه: «إن ابن الله أنشأ الكنيسة بأن جعل الرسول بطرس رئيساً لها، ثم ورث أساقفة روما سلطات بطرس في تسلسل مستمر متصل، ولذلك فإن البابا ممثل الله على ظهر الأرض، يجب أن تكون له السيادة العليا والسلطان الأعظم، على جميع المسحيين حكاماً كانوا أو محكومين» ([2]).
وبدأت الكنيسة بالفعل تمارس هذا السلطان على الملوك والأباطرة، ومن أمثلة ذلك في التاريخ ما رواه (فيشر) في كتابه: (تاريخ أوربا) ([3])، عن الصراع بين البابا (هلدبراند)، و(هنري الرابع) إمبراطور ألمانيا، حيث استطاع البابا أن يؤلب الأمراء على الإمبراطور عن طريق ما سمى بالحرمان، فعقد الأمراء مجمعاً قرروا فيه أن الإمبراطور عرشه مرهون بالمغفرة من البابا، مما استدعى الإمبراطور أن يتنازل عن كبريائه ويهرول إلى البابا طالبا المغفرة، حتى ظفر بها بعد أن وقف في البرد والثلج ثلاثة أيام مرتديًا حنوط الرهبان.
وعندما أصدر هنري الثاني ملك انجلترا دستوراً ألغى فيه كثيرا من امتيازات رجال الدين فيما تتعلق بالضرائب، أصدرت الكنيسة ضده حكما بالحرمان، مما اضطره أن يعلن ندمه وتوبته، ويسافر إلى مقر الأساقفة، ويمشي في ختام سفره إليهم ثلاثة أميال على قدميه حافي القدمين، حتى إذا وصل إليهم استلقى على الأرض وطلب من الأساقفة أن يضربوه بالسياط حتى ينال الرضا ممن غضبوا عليه.
ولما رأى الملوك أن الذي يتحدث باسم الإله هو الذي يكسب خضوع العامة له، بدأوا ينازعون الكنيسة سلطانها الروحي؛ بأن يعلنوا أنهم يحكمون في الأرض بمقتضى الحق الإلهي المقدس، وأنهم ظل الله في الأرض، وكان لهم بذلك جولة على حساب الكنيسة.
وفي القرن العاشر الميلادي حينما ساءت حالة البابوية إلى درجة غير عادية تدخل الأباطرة – ابتداء من أوتو الأول إلى هنري الثالث – واتخذوا إجراءات إصلاحية واسعة، وصلت إلى حدِّ خلع البابا جريجوري السادس والبابا بندكت التاسع الذي اشتهر بسوء السمعة، وذلك باتباع إجراءات اتسمت بطابع ديني، وفي الحقيقة كان للأباطرة في هذه الفترة القدح المعلى في القضاء على الفساد الذي استشرى في مرحلة استحكم فيها الفساد الكنسي، إلى حد صارت فيه انتخابات البابوية ألعوبة في يد مجموعة من الساسة التافهين في روما.
وفي محاولة لرد هيبة الكنيسة سعى جريجوري السابع الذي تولى عرش البابوية سنة 1073م، سعى في اتجاه نزع دور الحكام في تنصيب القساوسة، فأصدر قراراً بعد توليه بعامين بتحريم ومنع هذا الحق، ورد الإمبراطور هنري الرابع في العام التالي بخلع جريجوري؛ الذي ردَّ بحرمان هنري الرابع من رحمة الكنيسة وإعفاء تابعيه من يمين الخلاص له، وعلى أثر ذلك كان للكنيسة علو على السلطة الزمنية، دعمه المنظرون لها أمثال ( إيجيديوس كولونا ).
إلا أن الصراع هذا تحول إلى جدل كلامي يلبس ثوب العلم، ففي القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين احتدم الصراع الفلسفي حول فهم كل فريق لنظرية السيفين، وتمسك كل من الفريقين بأوجه مختلفة من نفس النظرية، وخرج منها بحجج تساوي في قوتها حجج الفريق الآخر، فتمسك البابويون بجلال قدر السلطة الروحية، وتمسك الملكيون باستقلال كل سلطة عن الأخرى … واحتاج الأمر – فقط – إلى دستورية وتشريعية محددة حتى تنقلب مطالب الكنيسة من الاعتراف بفضلها إلى المطالبة بالسيادة التامة مدعمة بالأسانيد القانونية؛ وما إن بدا هذا الموقف حتى لقى معارضة شديدة تستهدف قصر الواجبات الروحية على الوعظ والإرشاد دون إلزام.
وإزاء هذا التحكم الكنسي الذي فرض للكنيسة سلطاناً بغيضاً – طاب لتوماس هوبز بعد ذلك أن يصفه بأنه شبح الإمبراطورية الرومانية الميتة يجلس متوجاً فوق قبرها – انتفضت مجموعة من الكتاب المفكرين أمثال: وليام أكام وجون باريس ومارسيليو بادوا؛ وهاجموا الكنيسة ونظروا ضدها لصالح السلطة الزمنية، ففي أوائل القرن الرابع عشر ألف (جون باريس) كتاباً انتصر فيه لسلطة الملك، ودحض فيه آراء (إيجيديوس كولونا) واجتهد في ردِّ وتفنيد اثنين وأربعين سبباً قيلت في وجوب خضوع السلطة الزمنية للسلطة الروحية.
وألف (مارسيليو بادوا) كتابه (المدافع عن السلام) الذي تأثر فيه بفكر ابن رشد وبفلسفة أرسطو، وقد اعتبر أن المسيحية دين إعجازيٌّ غير قابل للمناقشة العقلية؛ ومن ثمَّ فلا يصح الزجُّ به في مسائل العقل والمنطق ولا في شئون السياسة والحكم، (أما وليام أكام) فكان يقول بان سلطة البابا المطلقة بدعة وإلحاد؛ لكونها خروجاً على القاعدة المقررة في القانون الإلهي والقانون الطبيعي، وهي التمييز القديم بين السلطتين الزمنية والدينية.
ولم يكن للناس نصيب من هذا الصراع الدنس الدامي إلا العبودية المستمرة والمترددة بين إلهين: السلطة الروحية والسلطة الزمنية، وكل هذا جرى باسم الدين، باسم الدين استعبدت السلطتان (الدينية والزمنية) العباد، وحكمتهم حكما دينياً ثيوقراطياً، استبدادياً، ولم تكن نظرية السيفين سوى محاولة للتنسيق بين سلطتين طاغيتين؛ تنازعتا الإلوهية على الناس، وتقاسمتا الربوبية على الخلق.
وظلت أوربا طوال هذه العصور غارقة في ظلمات يعلو بعضها بعضاً ويركب بعضها بعضاً، ولم يسطع في سمائها طوال تلك العصور المديدة المظلمة شعاع من نور، سوى ذلك البصيص الذي كان يلمع على اســتحياء في القرون الأخيرة من العصور الوسـطى، وكان من أهم رجـال الفكر في هذه المرحـلة: (تومـا الإكويني) و (ألبرت الأول) و (وجون ساليسبري) و (روجر بيكون) ثم أخيراً الشاعر (دانتي).([4])
واشتهر توماس الإكويني بتقسيم القانون إلى أربعة أقسام: القانون الأزلي ( الحكمة ) والقانون الطبيعي (تجلي أثر الحكمة على المخلوقات) والقانون الإلهي (ما اشتملته أسفار التوراة والإنجيل) والقانون الإنساني (قانون الشعوب والقانون المدني)، أما جون ساليسبري فكان من أشهر المؤلفين في السياسة، فوضع سنة 1159م كتابأ في السياسة والقانون كان من أهم أفكاره: أن القانون يجب أن يحترم من الراعي والرعية، وكان من أبرز أقواله: “إن من يغتصب السيف خليق أن يموت به” مشيراً إلى خطورة اغتصاب السلطة ووجوب مقاومة من يصنع ذلك. ([5])
أما دانتي الشاعر فقد جاء على مفرق الطريق من العصور الوسطى إلى عصر النهضة، وكان من أشهر مؤلفاته: ( الكوميديا الإلهية ) كتبها باللغة الإيطالية، وسخر فيها من كل المستبدين، سواء من الملوك أو القساوسة والباباوات، ثم وضع رسالة في السياسة سماها (الملكية) دعا فيها لدولة عالمية ولسلام عالمي.([6])
وظلت أوربا هكذا حتى جاء عصر النهضة، حيث انطلقت بعد جهاد وجلاد مع الكنيسة والملوك، انطلقت وشبح الماضي يطاردها، انطلقت لا تلوى على شيء؛ حتى ألقت بنفسها في أحضان العلمانية، وهناك في التربة العلمانية والمناخ الليبرالي أنبتت أنظمتها الجديدة ونظرياتها الحديثة في السياسة، ولو كانت الأمة الإسلامية آنذاك يقظة فاعلة لأخذت على أوربا طريقها ولهدتها سبيلها، ولكن كان ما قدره الله تعالى؛ لتبقى أوربا على الجانب الآخر موقعاً ومعتقداً؛ ليقضي الله تعالى أمراً كان مفعولاً.
النظام السياسي الإسلامي:
عندما كانت أوربا غارقة في ظلمات العصور الوسطى كانت الأمة الإسلامية تشيد حضارتها العظمى على دعائم الدين الحق، فأنشأت – فيما أنشأت – نظاماً سياسياً عادلاً رشيداً، كان نظاماً إسلامياً، ولم يكن نظاماً دينياً بالمعنى الذي عرفته أوربا في القرون الوسطى ولم تعرف غيره، لم يكن نظاماً دينياً ثيوقراطياً يعطي الحاكم الحق في أن يحكم باسم السماء؛ فيكون بذلك فوق المساءلة، وإنما كان نظاماً سياسياً إسلامياً يقوم على أسس ودعائم وأصول منافية تماماً لما قامت عليه النظم الدنية الثيوقراطية في أوربا في العصور الوسطى.
والذي أقام هذا النظام ووضع دعائمه ورفع بناءه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أول أساس لهذا النظام هو ذلك العقد الذي عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأنصار عند العقبة، وكانت بنود العقد واضحة وصريحة: «تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومةَ لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا أقدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسك وأزواجكم وأبنائكم؛ ولكم الجنة» ([7]).
وعلى هذا العقد قامت الدولة الإسلامية بالمدينة، وفي مطلع مسيرتها أصدر النبي صلى الله عليه وسلم ما يشبه الإعلان الدستوريَّ وهو تلك الوثيقة الغراء التي سميت بصحيفة المدينة، والتي نظمت الحقوق والواجبات وعلاقات الدولة رعاياها من المسلمين وغير المسلمين؛ فكانت مثالاً يحتذى في العدل والرحمة والتنظيم الدقيق للدولة، ومن أهم ما ورد فيها: ” بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم، أنهم أمة واحدة من دون الناس … وأن ذمة المؤمنين واحدة يجير عليهم أدناهم، وأن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس … وأنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين، ولا متناصر عليهم … وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء، فإن مرده الله وإلى محمد … وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم، فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته … وأن على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم، وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم … وأن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة … وأن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة، وإن البر دون الإثم لا يكسب كاسب إلا على نفسه، وإن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره … وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم، وأنه من خرج آمن، ومن قعد آمن بالمدينة، إلا من ظلم وأثم ” ([8])
وكانت الشورى هي منهج الحكم في جميع شئون الدولة العامة، ولم يرو لنا التاريخ حدثاً هاماً من أحداث السيرة لم يشاور فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ولم يرو لنا حدثاً شاور فيه أصحابه فخالف مشورتهم.
ومن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الخلفاء الراشدون، فأكملوا بناء النظام السياسي الإسلامي بما مارسوه من بيعة وتولية وغير ذلك، وممارستهم تعتبر دليلاً من الأدلة التي يعرف بها شكل النظام السياسي في الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على سنتهم وأوصانا أن نعتصم بها، والمقصود بسنتهم في حديث العرباص بن سارية هو سنتهم في الحكم والسياسة؛ لأن سياق الحديث يدل على ذلك؛ إذ ذكر الصفة السياسية لهم وهي صفة الخلافة، وأوصى بالسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشياً؛ وهذا أمر من أمور السياسة؛ فدل هذا على أن السياق كله في الحديث عن السياسة، وأن المقصود الأول بالسنة هنا: الطريقة المثلى في الحكم والسياسة.
ولم يوص رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستخلف؛ ليترك الأمة الإسلامية تمارس حقها في التولية، وتمارس سلطانها؛ لأن الأمة هي صحابة السلطان ومصدر السلطات، فقامت الأمة بذلك خير قيام، واختارت أبا بكر وبايعته بالخلافة، وقدمت ذلك على تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنه؛ لعلمها أن هذا العمل واجب كبير.
ومضت الأمة في عهد الراشدين تمارس سلطانها في التولية والبيعة؛ إما بالاختيار ابتداءً، وإما بالاختيار بعد ترشيح من الخليفة السابق، بمشورة كبار الصحابة، فيما عرف بالاستخلاف، ومضت كذلك تشير على الحاكم ويستشيرها الحاكم، ومضى الحكام في حكمهم وكلاء عن الأمة ونواب لها وموظفون لديها.
ولقد اشتملت خطبة أبي بكر على قواعد الحكم العادل؛ مما جعلها تعكس صورة صادقة عن النظام السياسي الإسلامي، الذي قام على أسس عظيمة، منها: سيادة الشريعة، وسلطان الأمة، والشورى، والمحاسبة للحكام، وغير ذلك، فقال أبو بكر في خطبته: «أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة، القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع عليه حقه. ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، وما فشت الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم».
واستطاعت الدولة الإسلامية بهذا الرشد السياسي أن تحقق العدل في حياة الناس، وأن تحقق الأمن والسعادة لكل رعاياها، وأن تقود الأمة من فتح إلى فتح ومن نصر إلى نصر، وأن تندفع في الكيان البشري اندفاع عصارة الحياة في الشجرة الجرداء؛ لتخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة.
وسوف أكتفي بهذه النبذة المختصرة؛ لكوننا سنعود حتماً إلى الحديث عن شكل النظام السياسي الإسلامي بشيء من التفصيل.
لكن الذي أودُّ ألا أبرح حتى أُذيّل به الحديث هنا عن النظام السياسي الإسلامي هو ما حدث بعد ذلك من تطور أو تغير في الأوضاع السياسية، بما لا يحسب على النظام السياسي الإسلامي.
لقد بدأ خط الانحراف عن النظام السياسي الإسلامي مبكراً، بدأ مع نهاية حكم الخلفاء الراشدين وبداية عهد الدولة الأموية، ولقد تمثل هذا الانحراف في زحزحة الأمة شيئاً فشيئاً عن ممارستها لسلطانها في التولية والعزل، وهذا الانحراف الذي جعل الخلافة بالوراثة لا يحسب على النظام السياسي الإسلامي، وإن كان يحسبب على الأمة الإسلامية، فالإجماع منعقد على أن الخلافة لا تورث، وممن نقل الإجماع (ابن حزم)، حيث قال: «لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام على أنه لا يجوز التوارث فيها» ([9]).
وبعد حدوث الانحراف، وبرغم اتساعه بمرور الزمن، لم ينس العلماء ولم يغفلوا الأصل المتقرر بحكم الشرع: أن الأمة هي صاحبة القرار: تولي وتعزل، وتحاسب وتراقب، وتعتبر الحاكم موظفاً لديها وكيلاً عنها، وموقعه منها كموقع أمرائه منه، يقول الإمام عبد القاهر البغدادي: «فإن أقام في الظاهر على موافقة الشريعة كان أمره في الإمامة منتظماً، ومتى زاغ عن ذلك كانت الأمة عياراً عليه في العدول به من خطأه إلى صوابه، أو في العدول عنه إلى غيره، وسبيلهم معه كسبيله مع أمرائه وقضاته وسعاته وعماله؛ إن زاغوا عن سننه عدل بهم أو عدل عنهم» ([10]).
ولم يكن الأمر مع ذلك سهلا؛ فمعاوية عندما أراد أن يأخذ البيعة لولده يزيد بالمدينة قام إليه بالمعارضة سادات الصحابة آنذاك: عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن أبي بكر والحسن والحسين جميعا، واشتدوا عليه، حتى قال عبد الرحمن بن أبي بكر له: «لوددتَ أنا وكلناك في أمر ابنك إلى الله، وإنا والله لانفعل، والله لتردَّنَّ هذا الأمر شورى في المسلمين أو لنعيدَنَّها عليك جذعة» ([11]).
وقال عبد الله بن عمر: «إنه قد كانت قبلك خلفاء لهم أبناء، ليس ابنك بخير من أبنائهم، فلم يروا في أبنائهم ما رأيت أنت في ابنك، ولكنهم اختاروا للمسلمين حيث علموا الخيار» ([12]).
مما اضطر معاوية أن يجتمع بقادة المعارضة ويحاول تهدئتهم بقوله: «إنما أردت أن تقدموه باسم الخلافة وتكونون أنتم الذين تنزعون وتؤمرون…» ([13]).
وإذا كان خط الحياة السياسية قد انحرف عن المسار الصحيح بعد عهد الراشدين؛ فإن ذلك لم يكن بسبب نقص في الهيكل النظري لنظام الحكم في الإسلام، ولا بسبب عجز النظرية السياسة الإسلامية عن تقديم الحلول لكل ما يعرض لمسار الحياة السياسية، وإنما كان ذلك راجعاً إلى عدة عوامل، أكبرها الفتنة التي أحاطت بالأمة واغتالت استقرارها في وقت مبكر؛ ولم تكن الأمة على حذر منها، برغم تحذير الرسول صلى الله عليه وسلم؛ بسبب انشغالها بالفتوح الكثيرة، وما ترتب على تلك الفتوح من مسئوليات ممتدة.
ويكفي للدلالة على ذلك أن ثلاثة من الخلفاء الأربعة – على التوالي – قتلوا غيلةً على أيدي أشخاص يحسبون على أهل الدسيسة والفتنة من المجوس والسبأيين والخوارج.
هذه الفتن شغلت الأمة عن وظيفة هامة – بدأها عمر بإنشاء الدواوين ولكن لم يتسنَّ لم بعده إكمالها- وهي مهمة نقل مؤسسات النظام السياسي الإسلامي من الطور البسيط الذي كان يناسب الحياة البسيطة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخليفته أبي بكر إلى الطور الحضاري المعقد المتشابك، الذي يناسب عصر الفتوح وعهد الانفتاح والاتساع؛ ولا أعنى بذلك إلا الجانب المادي الذي يشتمل على الآليات والأدوات والأمور الفنية التقنية.
هذه الأمور ليست هينة، وهي موكولة كلها إلى الاجتهاد البشري، وأياً ما كان الأمر فقد بدأ خط الانحراف، وأخذ يبتعد مع مرور الزمن شيئا فشيئا عن النظام السياسي الإسلامي الذي جاء به الإسلام؛ حتى وقعت الأمة في آخر عهدها في جب الحكم الجبري، وهو عين ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: « تكون النبوة فيكم ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها إذا شاء ان يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله ان يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها إذا شاء ان يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة»([14])
لكننا نعود فنؤكد على أمرين، الأول: أن هذا الانحراف لا يعكس ولا يصور الشكل الصحيح الذي جاءت به الشريعة الإسلامية للنظام السياسي الإسلامي، الثاني: أن هذا الانحراف لم يكن لقصور في النظام الإسلامي وإنما كان لتقصير من الأمة الإسلامية.
وعندما نتحدث عن النظام السياسي الإسلامي فإننا نتحدث عن حقيقة شاخصة متكاملة الأركان، نتحدث عن نظرية في الحكم استوفت جميع الأسس والمبادئ، واستكملت كل المؤسسات والأجهزة، والأمر الفذَ الذي تميزت به هذه النظرية وتفردت به من بين كل النظريات قديمها وحديثها على السواء هو أنَّ الدّال عليها لا يردُّ الناس إلى مؤلف أو جملة من المؤلفات، أو إلى مفكر أو مجموعة من المفكرين، وإنما يردهم إلى ذات المصدر الذي تُستَقى منه كل أحكام الإسلام، إلى الكتاب والسنة ( قولية وعملية )، ثم إلى ما دلَّ الكتاب والسنة عليه كسنة الخلفاء الراشدين المهديين.
فمن أراد أن يطلع بنفسه على صورة النظام السياسي الإسلامي فما عليه إلا أن يخلع رداء التعصب، ويشمر عن ساق الجد، ويقوم بعملية استقراء شاملة لنصوص الكتاب والسنة ولأحداث السيرة وتاريخ الراشدين، مستصحباً مقاصد الشريعة الكلية وقواعدها العامة؛ عندئذ ستتبدى له الصورة الكاملة بلا غبش، ولا يمكن أن يكون هذا التفرد بربانية المصدر ذريعة لتصنيف هذا النظام ضمن النظم الحتمية؛ لأن تصنيف أيَّ نظام ضمن النظم الحتمية أو النظم الإرادية يجب أن يعتمد على محتوى هذا النظام من الأسس والمبادئ لا على مجرد نسبته إلى مصدر سماوي أو أرضيٍّ، والنظم الحتمية التي سادت أوربا في العصور الوسطى لم تكن منسوبة إلى المسيحية الحقة وإنما كانت – على وجه الدقة – منسوبة إلى رجال الكنيسة ومن تواطأ معهم من الملوك والأباطرة، ولم يعرف الفقه السياسي الإسلامي – من لدن الصحابة إلى يومنا هذا – أن الحاكم يستمد سلطانه من السماء أو أنه ظل الله في الأرض لا يسائل إلا أمام الله وحده.
ولا يشوش على هذا التفرد بربانية المصدر أن هناك مساحات واسعة متروكة لاجتهاد العقل البشري؛ لأن وجود هذه المساحات في أي باب من أبواب الشريعة لا ينقص من كونه داخل في هذه الخاصية؛ لأنَّ المسكوت عنه إن كان من قبيل الأدوات – وهو أكثر ما يقع – فهذا من أمور الدنيا التي تركت لاجتهاد الناس ” أنتم أعلم بأمور دنياكم “، وإن كان من قبيل الأحكام الفرعية فهذا غير خارج عن وصف الشرعية ولا عن سمة الربانية؛ لأن اجتهاد العقل فيه يكون في إطار من القواعد والمقاصد التي قررها الشرع.
ولقد اجتهد العلماء في استخلاص هذه النظرية وبلورتها، من لدن الصحابة إلى يومنا هذا، ففي البداية كانت الأمة تنحو إلى التطبيق العمليِّ دون أن تشغل بالها بالتأطير والتنظير، وتلك كانت صفتها في مهد الإسلام، فكان التطبيق العملي في عهد الراشدين هو التدوين الحقيقي للنظرية في القرن الأول من القرون المفضلة، وكان تدوينهم هذا سنة تقوم بها الحجة على الأمة.
ثم جاءت المرحلة الثانية مع تدوين الفقه الإسلامي والعلوم الإسلامية الأخرى، فدونت الأحكام التي ترسم في مجموعها هيكل النظام السياسي الإسلامي، لكنها وردت مفرقة في أبواب الفقه كأبواب الإمامة والجهاد والمهادنات والموادعات وغيرها، وفي كتب أصول الفقه، وفي مواضع متفرقة من التفاسير وشروح السنة ودوواين السيرة.
ثم جاءت المرحلة الثالثة، وهي المرحلة التي أفرد فيها هذا العلم بالتأليف؛ فظهرت الكتب التي تخصصت في رسم الشكل العام لنظام الحكم في الإسلام، واشتهر بذلك أعلام كبار، كان منهم: الإمام أبو يوسف صاحب كتاب (الخراج)، والإمام القاسم بن عبيد صاحب كتاب (الأموال)، والإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب أول مؤلف في القانون الدولي والعلاقات الدولية (السير الكبير) وهو الكتاب الذي شرحه بعد ذلك الأمام السرخسي، ومن بعدهم جاء الجويني الشافعي صاحب كتاب (غياث الأمم في التياث الظُلَم) والإمام الماوردي الشافعي صاحب (الأحكام السلطانية) ومثله من الحنابلة أبو يعلى صاحب كتاب (الأحكام السلطانية) والقلقشندي صاحب كتاب (مآثر الإنافة في معالم الخلافة) وابن الازرق صاحب (بدائع السلك في طبائع الملك) وابن فرحون صاحب كتاب (تبصرة الحكام) وابن خلدون صاحب (المقدمة) وغيرهم.
وبعد فترة من الركود أغلق فيها باب الاجتهاد جاء العصر الحديث ليشهد حركة تجديد واجتهاد شملت فيما شملت السياسة الشرعية، وتم وضع كتب عديدة كان من بينها: (الخلافة) للإمام محمد رشيد رضا، وكتاب ( فقه الخلافة وتطورها ) للعلامة عبد الرزاق السنهوري، وكتاب (الإسلام وأوضاعنا السياسية ) للشهيد عبد القادر عودة، وعشرات الكتب التي تحدثت عن نظام الحكم، إضافة إلى مئات الكتب والأبحاث والرسائل العلمية التي تناولت بالبحث مسائل متفرقة من فقه السياسة الشرعية.
ولا يزال الاجتهاد الإسلامي يقلب صفحات المسائل اللامتناهية في هذا الباب، ويرُدُّ ما استجد إلى ما تقرر، ولا يزال المخلصون من أبناء الأمة الإسلامية يسعون لإعادة الخلافة الراشدة وتحقيق وعد الله لهم بالتمكين في ظلها النديِّ الرخيِّ.
” وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً؛ يعبدونني لا يشركون بي شيئاً، ومن كفر بعد ذلك فأولائك هم الفاسقون”
([1]) تطور الفكر السياسي ك2 ص 94
([2]) قصة الحضارة، وول ديورانت، نقلا عن مذاهب فكرية معاصرة – محمد قطب – دار الشروق الطبعة: الأولى 1403هـ-1983م (ص45).
([3]) تاريخ أوربا – فيشر (1/60)، نقلا عن مذاهب فكرية معاصرة، (ص46).
([4]) راجع تطور الفكر السياسي ك2 ص 155 – 157
([5]) راجع تطور الفكر السياسي ك2 ص 157 – 165
([6]) راجع تاريخ أوربا من النهضة حتى الحرب الباردة – د. شوقي عطا الله وزميله – ص 230 وما بعدها ط المكتب المصري 2000 م
([7]) رواه أحمد، (14358)، وابن حبان، (6409)، وأبو يعلى، (2557) وصححه الألباني.
([8]) مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة – محمد حميد الله الحيدر آبادي – دار النفائس – بيروت – ط 6 – 1407 ه – (ص59-62)
([9]) الفصل في الملل والأهواء والنحل – أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم – مكتبة الخانجي – القاهرة – (4/167)
([10]) أصول الدين – الإمام عبد القاهر البغدادي – ط مدرسة الإلهيات بدار الفنون التركية باسطنبول – ط أولى 1928م – (ص278).
([11]) تاريخ خليفة بن خياط – أبو عمرو خليفة بن خياط الشيباني البصري – ت : د. أكرم ضياء العمري – دار القلم , مؤسسة الرسالة – دمشق , بيروت (ص213).
([12]) تاريخ ابن خياط، (ص203)
([13]) تاريخ ابن خياط، (ص216)
([14]) رواه أحمد في مسنده (18406) ط الرسالة – وصححه الحافظ العراقي وتابعه الألباني، انظر السلسلة الصحيحة 1/34