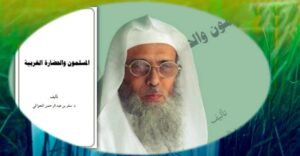كان لابد لكي تنهض أوربا أن تثور على أوضاعها التي سادت في القرون الوسطى، بما في ذلك الكنيسة بطغيانها الديني والسياسي والعلمي، وكان لابد كذلك من فكر جديد يؤسس لعهد جديد، على رأس هذا الفكر وفي مقدمته: الأفكار والنظريات والفلسفات التي تنهى استبداد الملوك والكنيسة وتقضي على ازدواج السلطة.
بداية النهضة
في منتصف القرن الثاني عشر كانت موجات من التَّغَيُّر الجذريِّ في طبيعة الحياة قد ضربت مدن شمال إيطاليا؛ حيث انتهى الإقطاع؛ فانتهت بانتهائه طريقة في حكم تلك المدن كانت تكرس لسلطة الإمبراطور المطلقة، وظهر في تلك المدن فكر يدعو إلى الحرية ويراها متمثلة قبل كل شيء في الاستقلال السياسي عن الإمبراطور، وفي الحق الأصيل لكل مدينة أن تضع لنفسها نظام الحكم الذي ترتضيه، صاحب هذا الفكر ممارسات عملية واقعية لحكم ذاتي في تلك المدن، وكان أبرزها (ميلان) وسائر مدن (لومبارديا)، مما استدعى الإمبراطور (فريدريك بارباروسّا) أن يهاجم تلك المدن بغرض إخضاعها له، وقد شجعه على ذلك الطمع فيما كانت تتمتع به تلك المدن الصاعدة اقتصادياً، وقد نجح في بداية الأمر، ثم ما لبثت المدن أن تحالفت ضده؛ ونجحت في هزيمته بعد ذلك، ولما جاء (فريدريك الثاني) قام بنفس ما قام به سلفه، وانتهى أمره إلى ذات المصير بعد أن توسع الحلف وانضمت إليه مدن أخرى أبرزها في الصراع (فلورنسا)، وقد ساهم الفيلسوف القانوني (بارتولوس) في إضفاء الشرعية على ما قامت به تلك المدن؛ حيث خرج من الجدلية العقيمة لمفسري القانون الروماني إلى أفق قانوني جديد، وذلك بنظريته القاضية بأنَّ القانون يجب أن يتكيف مع الوقائع الجديدة التي أخذت حكم الواقع المستقر؛ ومن ثمَّ أعطى الحقَّ كاملاً للمدن الجديدة أن تضع لنفسها القانون الذي ينظم حياتها؛ استناداً على كونها واقع فرض نفسه من زمن، وقرر ذلك في تعليقه على قانون (جستنيان) الذي يفرض من الإمبراطور الروماني حاكماً للعالم؛ ومن هنا ولدت فكرة مدنية الحكم تابعة وتالية لحكم المدن المستقلة التي قامت في شمال إيطاليا، تلك الفكرة التي مثلت الشرارة التي انطلقت بعد ذلك إلى غرب أوربا كلها.([1])
وواكب ذلك بداية الفكر الحداثيِّ على يد مبدعين جدد، أمثال (بترارك) الذي اعتبره مؤرخون كبار أبا النهضة، كان (بترارك) محاميا في إحدى المدن الإيطالية، ونفي منها على أثر خلاف قضائيّ، وفي منفاه درس القانون ثم درس فكر (شيشرون) وغيره من القدماء، وبرع في الشعر وتغزل في محبوبته (لورا)، ووصف الطبيعة، وانتقد الكنيسة ورجال الدين، ودعا إلى الحداثة وإلى حق الإنسان في الاستمتاع بالحياة الدنيا، وتنقل من بلد لآخر في فرنسا وألمانيا وإيطاليا؛ فكان لشعره الرقيق أثر بالغ في النهضة.([2])
ومن الأمور التي مهدت لانتشار الفكرة في غرب أوربا أن النسيج الاجتماعي في أوربا في خلال القرن الخامس عشر طرأ عليه تطورات ملحوظة؛ لاسيما في انجلترا وفرنسا، إذ في الوقت الذي بدأت فيه هيبة البابا تتضائل أمام حملات التحقير ظهرت طبقة وسطى من رجال يملكون المال والإقدام بسب التجارة بين المدن والمقاطعات في ظل الإقطاع الذي ساد في أوربا، هذه الطبقة كانت معادية لطبقة النبلاء الإقطاعيين، فساعدت هذه التغيرات على نمو سلطان الملك على حساب البابا وعلى حساب ما كان يسمى بالمدن الحرة التي كانت خاضعة للإقطاعيين، وبدأ من ذلك العهد النداء بالملكية المطلقة، أما إيطاليا فقد كانت على موعد مع ميكيافيللي. ([3])
(ميكافيلي) والحكم المطلق:
كان من أوائل الذين خرجوا على نظرية السيفين وعلى سلطان الكنيسة واستبدادها (ميكافيلي) الذي أسس لفكرة الدولة القومية، والذي دعا إلى الوحدة القومية، وإلى الخلاص من سلطان الكنيسة التي كانت سبباً – بنظره – في ضعف إيطاليا وتمزقها إلى دويلات خمس: نابلي وميلان، والبندقية، وفلورنسا، ودولة البابا([4]).
ومن رحم المشكلة الإيطالية ولد الفكر الميكيافيللي، ” فمشكلة إيطاليا – إذاً – هي إقامة دولة في مجتمع فاسد، وفي أمثال هذه الظروف اقتنع ميكيافيللي أنه – فيما عدا الملكية المطلقة – ليس في الإمكان قيام حكم فعال وقادر، وهذا يفسر السبب الذي من أجله كان معجباً بالجمهورية الرومانية ومدافعاً في الوقت ذاته عن الحكم المطلق ” ([5])
وكان ميكافيلي معجباً بكل من: فرديناند ملك أسبانيا، ولويس الحادي عشر ملك فرنسا وهنري الثامن ملك انجلترا؛ لكونهم من الحكام الأقوياء واسعي الحيلة، وإن خلوا من وازع الضمير؛ فتأثر بهم ووضع كتابين، الأول: كتاب (الأمير) الذي تناول فيه بحث الدولة الملكية والحكومات المطلقة، والثاني: كاتب (الدراسات) الذي تناول فيه توسيع الدولة الرومانية، وفي كلا الكتابين ظهرت معتقدات ميكافيلي الخاصة التي اشتهر بها، من مثل: تجاهله لقواعد الأخلاق، وفصله بين الأخلاق والسياسية، واعتقاده أن الحكومات تقوم على القوة والخديعة ([6]).
ويعتقد ميكافيلي أن الإنسان شرير بطبعه، وأن سلوكه يتميز بالخبث والأنانية، ويعبر ميكافيلي عن هذا في كتابه الأمير، فيقول: «وقد يقال عن الناس بصورة عامة: أنهم ناكرون للجميل، متقلبون مراءون، ميالون إلى تجنب الأخطار، شديدو الطمع، وهم إلى جانب ذلك طالما أنك تفيدهم يبذلون لك دماءهم وحياتهم وأطفالهم… ومصير الأمير الذي يركن على وعودهم دون اتخاذ أية استعدادات أخرى إلى الدمار والخراب» ([7]).
وهذه النظرة هي التي ألصقت التهم بصاحبها، وجعلته صاحب نظرية (الغاية تبرر الوسيلة)، وربما لم يقصد ميكافيلي تعميم هذه النظرية، ولم يقصد كذلك أن يدعو إلى اللاأخلاقية، وإنما قصد إلى واقعية في الممارسة السياسة توصل إلى المقصود الأكبر وهو المحافظة على قوة الدولة ووحدتها، ولكن غلوه في هذه الدعوة – الناتج عن ردة فعل ضد الكنيسة وسلطانها الروحي – هو الذي أدَّى على تفحش نظريته تلك.
وعلى الرغم من أهمية ميكافيلي بالنسبة لعلم السياسة يمكن القول بأن الواقعية التي تغيَّاها لم تكن واقعية مجردة عن الأغراض الذاتية؛ فغالباً ما كان يهدف من خلال وصفه للواقع إلى دعم موقفه السياسي([8]).
لكن هذا الإتجاه – وإن كان متماشياً في ظاهر الأمر مع مصلحة أوربا آنذاك – لم يرق لأرباب الفكر ورجال الفلسفة؛ لذلك كانت هناك أصوات تنادي بالمقاومة للاستبداد وبالدعوة للدولة المثالية، وكان من هؤلاء توماس مور الذي ألف كتابه الشهير ( اليوتوبيا ) أي العالم الكامل أو مدينة المثل، ولقد كان إقبال الناس على قراءة كتابه عظيماً؛ لكونه كان مناضلاً معارضاً للملك هنري الرابع ملك انجلترا. ([9])
حركة الإصلاح الديني:
وفي أوائل القرن السادس عشر الميلادي ظهرت حركة الإصلاح الديني على يد (مارتن لوثر) الذي دعا إلى الخلاص من السلطان السياسي والديني للكنيسة، ولكن ليس بالنظرية الميكيافيلية المعتمدة على قوة الملك وسياسته الخالية من الأخلاق، وإنما عن طريق إصلاح الأفكار الدينية ذاتها، فقاد حملة ضد صكوك الغفران، ودعا إلى إخضاع رجال الدين للسلطة المدنية، وإلى نزع اختصاص رجال الدين بالنظر في تفسير الإنجيل ([10]).
نادى (مارتن لوثر) بأن ألمانيا للألمان، وضرب على وتر القومية، لذلك حظيت حركته في بدايتها بحماس شعبيٍّ شديد، وفهم كثير من الألمان أن حركة مارتن لوثر ليست حركة إصلاح ديني وحسب، بل هي قبل ذلك حركة قومية ([11]).
وهي كذلك حركة داعمة للحكام على حساب الكنيسة، فمن أقوال مارتن لوثر: ” ليس من الصواب – بأيِّ حال – أن يقف المسيحي أمام حكومته؛ سواء كانت أفعالها عادلة أم جائرة، وليس من الأفعال أفضل من طاعة من هم رؤساء لنا وخدمتهم، ولهذا السب أيضاً فالعصيان خطيئة أكبر من القتل والزنى والسرقة وخيانة الأمانة ” ([12])
وعلى منهج اللوثرية وفي ذات الاتجاه – مع قدر قليل من الاختلاف – كانت الكلفنية، وكان من آراء ( كلفن ) السياسية وجوب الطاعة العمياء للملك؛ لكون السلطة الزمنية – في فلسفته – وسيلة الخلاص الظاهرية، والحاكم – بنظره – نائب الله في الأرض، ومقاومته مقاومة لله، حتى ولو كان هذا الحاكم منحرفاً أو ظالماً، فإنه يكون عندئذ عقوبة من الله لعباده على خطاياهم. ([13])
ولقد ترتب على حركة الإصلاح الديني تلك نشوء قوتين متنازعتين: البروتستانية بمذاهبها المختلفة والمنتشرة بأنحاء كثيرة في أوربا، والكاثيولوكية المتمركزة في روما وبعض البلدان، وأدَّى التطاحن بين القوتين إلى الزج بأوربا في حرب دينية عنيفة، استمرت من أوساط القرن السادس عشر إلى نهاية الثلث الأول من القرن السابع عشر. ([14])
الصراع بين الحكم المطلق والحكم الدستوري:
وفي النصف الثاني من القرن السادس عشر كان الجدل محتدما بين الؤيدين والمعارضين للملكية المطلقة والحكم المطلق، وانقسم الأدب السياسي إلى قسمين أو اتجاهين: اتجاه دافع عن قدسية المنصب الملكي، تبلور في نهاية القرن بنظرية الحق الإلهي والسيادة الكاملة الكامنة في الملك، وفي المقابل كان الإتجاه الثاني الرامي إلى التقليل والتقييد من سلطة الملك وإعطاء حق المقاومة للشعب، وكان الاتجاه الأول غالب في فرنسا أما الثاني فكان غالباً في إنجلترا، ومن أشهر الكتب التي ألفت في في اتجاه الدولة الدستورية التي تقيد فيها سلطات الملك كتاب: (دفاع ضد الطغيان) الذي قسم أربعة أجزاء للإجابة على أربعة أسئلة: الأول: هل الرعايا مجبرون على طاعة الملك وإن خالف القانون الإلهي ؟ والثاني: هل يجوز مقاومة الملك الذي يرغب في إلغاء قانون الرب ؟ الثالث: هل يجوز مقاومة الملك الذي يجور على الدولة ؟ الرابع: هل يصح قانوناً أن يساعد أمراء رعايا آخرين ضد أميرهم ؟ وأسهب الكتاب في بيان وضع الملك والرعية بشكل كبير وبصورة منطقية، فأقر بعقدين: الأول: بين الله من طرف والملك والرعية من طرف آخر، والثاني: بين الملك من طرف وبين الرعية من طرف آخر، فبمقتضى العقد الأول يكون الملك والرعية مسئولين أمام الله عن استقامة الدين ونقاء المذاهب، وتقصير الملك يلقي العبء على كاهل الرعية إذا لم تقاومه، وبمقتضى الثاني يكون للرعية حق مقاومة الملك؛ إذ إنه برغم أن الله أقام الملوك إلا أنه يتصرف في دفع طغيانهم عن طريق الناس. ([15])
(جان بودان) ونظرية السيادة:
وبرغم تأخر دور الكنيسة الملحوظ في القرن السادس عشر جاءت الضربة القاضية، التي أنهت إلى الأبد مبدأ ازدواج السلطة ونظرية السيفين، وأنهت كذلك كل سلطان للكنيسة، وهي نظرية السيادة، وكان أول من أنشأ فكرة السيادة في أوربا (جان بودان) في كتاب (الجمهورية) الذي وضعه سنة 1576م([16]).
وصفة السيادة مقتضاها أن سلطة الدولة سلطة عليا، لا يسمو عليها شئ ولا تخضع لأحد، ولكن تسمو على الجميع وتفرض نفسها على الجميع، ومقتضاها كذلك أن سلطة الدولة سلطة أصلية، أي لا تستمد سلطتها من سلطة أخرى([17]).
كما تحدث بودان عن المواطنة، فعرفها بأنها الخضوع لعاهل مشترك، ويرى بودان أن ما سوى ذلك من علاقات اجتماعية ودينية أو تاريخ مشترك أو لغة أو دين أو غير ذلك قد يكفي لتكوين أمة، أما الدولة فلا توجد إلا حيث يوجد الخضوع لعاهل مشترك. ([18])
تعانق السيادة مع نظرية العقد الاجتماعي:
ثم جاء (توماس هوبز)، ومن بعده (جون لوك)؛ لتتعانق نظرية السيادة مع نظرية أخرى كان لها دور بارز في هيكلة الفكر السياسي الحديث في أوربا، ألا وهي نظرية (العقد الاجتماعي)، وهناك أوجه اتفاق في عرض كل منهما لهذه النظرية، وأوجه اختلاف، وقد استفاد بعد ذلك جان جاك روسو من هذا التراث وبني نظرية الكاملة في كتابه الشهير: (العقد الاجتماعي).
وتعتمد هذه النظرية على فرضين اثنين، الأول: حالة الفطرة الأولى التي كان عليها الناس قبل قيام الدولة، الثاني: العقد الذي بموجبه قامت الدولة ونشأت([19])، غير أن الرجلين (هوبز ولوك) اختلفا في تصورهما لها وفي التعبير عنها بحسب اختلاف غاياتهما من تدعيم للاستبداد أو معارضة له، فأما حالة الفطرة الأولى فيراها توماس هوبز أنها كانت حالة وحشية يسودها الفوضى والتأخر والشر، مما دفع الناس إلى أن يبحثوا لأنفسهم عن مخرج، فيتنازلوا عن حقوقهم من أجل قيام الدولة التي تنظم أمورهم وتدفع عنهم شر البداوة والوحشية، ويراها جون لوك حالة تسودها الحرية والمساواة؛ غير أنها تتميز بعدم الاستقرار بسبب تداخل الحقوق والحريات؛ بما استدعى أن يتنازل الناس عن بعض حقوقهم وبعض حرياتهم في سبيل الحفاظ على باقي الحقوق والحريات، وفي سبيل انتظام شمل الجميع([20]).
وأما العقد فقد ذهب توماس هوبز إلى أن الأفراد تنازلوا بموجب هذا العقد عن جميع حقوقهم ووضعوها في يد شخص واحد، أو مجموعة أشخاص يقومون مقام الشخص الواحد، بينما ذهب جون لوك إلى أن الأفراد تنازلوا – بموجب هذا العقد – عن بعض حقوقهم وحرياتهم للجماعة أو للشعب([21]).
وبذلك يكون توماس هوبز قد ركز السيادة في شخص الملك، أما جون لوك فقد ركز السلطة في الشعب إيماناً منه بسيادة القانون، وبضرورة تدعيم نضال البرلمان ضد الملك ([22]).
الطفرة الإنجليزية:
كانت العقبة الكبيرة في طريق تحرر الشعوب الأوربية من الاستعباد أن أوربا – بسبب تركز جهادها ضد طغيان الكنيسة – وقعت في جب الاستبداد الملكي، الذي أصَّلَ له فلسفة الحكم المطلق، التي أرساها ميكيافيلي ومارتن لوثر وكلفن وغيرهم؛ مما حدا بالمفكرين والمناضلين أن يوجهو اهتمامهم بمجاهدة الملوك ومجالدتهم على الحقوق والحريات وعلى الحياة السياسية الدستورية بالثورات النضالية القوية، وكان لانجلترا السبق في هذا الميدان من وقت مبكر، ففي عام 1215م اضطر الملك تحت ضغط الأشراف ورجال الدين إلى إصدار ما سمي بالعهد الأعظم، وقد نُصَّ فيه على عدم جواز القبض على أحد أو سجنه إلا بقرار من محكمة قانونية، وعلى ألا تفرض ضريبة إلا بموافقة المجلس الأعظم، وعلى عدم تدخل الملك في شئون الكنيسة.
وبمرور الزمن، وبحلول القرن الرابع عشر، وبفضل جهاد المفكرين ضد فكرة الحكم المطلق، حققت الإرادة الشعبية خطوة أكثر فاعلية، حيث أنشئ مجلسان: مجلس اللوردات وهو المجلس الذي يضم ما كان يضمه المجلس الأعظم من الأشراف ورجال الكنيسة، ومجلس العموم الذي كان يضم ممثلين عن المدن والمقاطعات، ثم أصبح يطلق على الغرفتين: ( البرلمان ) وكان يشارك الملك في السلطات التشريعية، لاسيما ما يتعلق بالسياسة المالية .
وفي أوائل القرن السابع عشر جاءت أسرة استيوارت إلى الحكم، وكانت كاثيوليكية بينما غالبية الشعب بروتستانت؛ فأساءت معاملة الشعب، وألغى جيمس الأول البرلمان وزاد في الضرائب، وسار ابنه شارل الأول على نهجه؛ مما أدى إلى اندلاع الثورة التي رسخت للحكم الدستوري، وأسست للحدث الكبير في حياة أوربا ألا وهو إعلان الحقوق.
في عام 1689 صدر في بريطانيا إعلان الحقوق، صدر عن البرلمان الإنجليزي، وكان مما نص عليه: أن الملك يستمد حقه في العرش من إرادة الشعب، وأنه لا يحق للملك إهمال قانون أصدره البرلمان، ([23]).
الثورة الفكرية التي مهدت للثورتين الأمريكية والفرنسية:
تأثر المفكرون الفرنسيون – الذين قدَّموا لأوربا فكراً جديداً كان هو الوقود للثورة الفرنسية الكبرى – تأثروا بانجلترا، ففي أواخر القرن الثامن عشر زار الشاعر والمفكر الفرنسي (فولتير) بريطانيا وأعجب بما فيها من حرية، وكتب عنها، وكتب ضد الكنيسة، وطالب بالمساواة والحرية، وطالب بإصلاح الفساد وإصلاح نظام الضرائب([24]) وكان شديد التأثر بفكر جون لوك وبعلم نيوتن، وكان ذا نزعة إنسانية عالية، وساعده أسلوبه الساخر في هزّ بنيان الكنيسة والملكية المستبدة، وصاغ الأفكار الأنجليزية في ثوب راديكالي. ([25])
ومثله (مونتسكيو) إمام المذهب الحر، وصاحب الكتاب الشهير (روح القوانين) الذي ألفه سنة 1748 وتحدث فيه عن النظرية السياسية، وأشاد بالنظام الدستوري الإنجليزي، ولكنه دعا إلى مبدأ الفصل بين السلطات؛ ليَحُول – مؤسسياً – دون استبداد أي سلطة من السلطات، وبرر ذلك بأنه ما من فرد يتمتع بسلطة إلا ويميل إلى التعسف في استعمالها، وهو مستمر في ذلك حتى يصطدم بما يوقفه، ولا يوقف السلطة إلا السلطة، ولا سبيل إلى وقف السلطة بالسلطة إلا عن طريق الفصل بين السلطات، وقد كان منتسكيو مشهوراً باعتماده على منهج الملاحظة المنتظمة، فلم يقف في تصفحه للظواهر السياسية عند حد الظواهر المعاصرة والقريبة، وإنما تعداها إلى ما وراءها مما بعد زماناً ومكاناً؛ مما هيأ له القيام باستقراء واسع المدى للتاريخ والجغرافيا وتطور الواقع السياسي والاجتماعي، ثم قارن بين ذلك كله ليخرج بنظريته.([26])
أما (جان جاك روسو) فكان أشهر فلاسفة فرنسا ومفكريها؛ فهو الذي وضع سنة 1762م كتابه الشهير:(العقد الاجتماعي) ليكون بمثابة إنجيل الثورة الفرنسية ([27])، وإذا كان مونتسكيو قد أسس للمذهب الحر فإن روسو قد أسس للمذهب الديمقراطي؛ حيث مال في كتابه (العقد الاجتماعي) إلى أن الأفراد تنازلوا عن بعض حقوقهم الشخصية لا لفرد معين وإنما للمجموع، ورتب لذلك أن لهذا المجموع سيادة وإرادة تولدتا عن هذا العقد، وأن هذا المجموع ينفرد وحده بهذه السيادة؛ وبذلك لا تكون الحكومة طرفاً في العقد؛ وإنما هي وسيط بين الطرفين؛ بين المجموع صاحب السيادة – بشخصيته المعنوية وإرادته المستقلة – وبين الأفراد الخاضعين لسيادة المجموع.
ولم يكن الفكر الإنجليزي وحده هو الذي أثر في فلسفة هؤلاء الثلاثة الفرنسيين وغيرهم، وإنما كان لفكرة القانون الطبيعي التي عادت للحياة من جديد في أوربا الحديثة، والتي أسست للحديث عن حقوق وحريات الأفراد، كان لهذه الفكرة أثر كبير في تغذية فكر فوليتر ومونتسكيو وروسو؛ لذلك خرج الفلاسفة الفرنسيون الأفكار الإنجليزية تخريجًا جديدًا، فقالوا بأن صيانة حرية الفرد هي الهدف الرئيسي لكل نظام اجتماعي، إلا أنهم اختلفوا في الوسائل التي تكفل تحقيق هذا الهدف فظهر نتيجة لذلك مذهبان: المذهب الحر، والمذهب الديمقراطي([28]).
وقامت الثورة الفرنسية معتمدة على فكر هؤلاء الفلاسفة الكبار، قامت لتعلن حقوق الإنسان والمواطن، ولتعلي من حريات الأفراد، ولتفتتح لأوربا عهدًا جديدًا، عهدًا صاعدًا واعدًا في مجال الإنسانية والحضارة القائمة على احترام الإنسان، وعلى الحرية والمساواة والكرامة، وقبلها بعقد وبضع سنين كانت الثورة الأمريكية قد حررت أمريكا من الاستعمار ومن الموروث الفكري للاستعمار، وكانت هي الأخرى متأثرة بالفكر الأوربي الجديد.
وارتباط هاتين الثورتين بالحقوق الطبيعية ظاهر وواضح، يدل على ذلك ما تضمنه إعلان الاستقلال الأمريكي (سنة1776) وإعلان حقوق الإنسان والمواطن (سنة1789) من حقوق وحريات للأفراد.
التطور في مناهج دراسة الظاهرة السياسية:
إلى هذا الحد من الارتقاء في الدراسات السياسية كانت المناهج القياسية هي المعتمدة؛ حتى لدى المتأخرين من المفكرين أمثال هوبس ولوك وروسو، وإذا كان منتسكيو قد حقق طفرة كبيرة باعتمادة منهج الاستقراء الشامل والملاحظة المنتظمة فإن الطفرة الحقيقية في منهج تناول الظواهر السياسية حدثت في أوائل القرن التاسع عشر؛ حيث خطت الدراسات السياسية خطوتين كبيرتين، الأولى هي اعتماد وضعية تجريبية، والثاني هو استقلال العلوم السياسية عن الفلسفة، مع بداية تمايز العلوم الإنسانية والاجتماعية، فصارت العلوم السياسية علماً مستقلاً بذاته.
ويعتبر ( أوجست كونت ) رائد الإتجاه القائل بأن الظواهر السياسية يجب أن تكون موضع تحليل علميَّ؛ شأنها في ذلك شأن الظواهر الطبيعية، وهو الذي أطلق على العلوم الاجتماعية اسم ( علم الفيزياء الاجتماعية ) وتصور أنه بالإمكان تحديد قوانين طبيعية ذات قيمة أزلية تنطبق على نمط من النظام الاجتماعي دائم لا يتبدل، مشابه للنظام الفلكي، ويعتبر كونت صاحب قانون ( الأطوار الثلاثة ) حيث اعتقد أن الفكر الإنساني تطور تدريجياً من الحالة (التيولوجية) التي اتسم فيها الفكر بالطابع اللهوتي، إلى الحالة (الميتافيزيقية) التي ساد فيها الفكر المثالي، ثم أخيراً إلى الطور (الوضعي) الذي يغلب عليه الطابع العلمي التجريبي.
والواقع أن أوجست كونت لم يأت بجديد فيما يتعلق بقانون الأطوار الثلاثة إلا مجرد النقل إلى العلوم الاجتماعية، فهذا القانون – برغم ما فيه من تحكم غير مبرر – كان سائداً قبل كونت؛ إذ كان يعتقد أن العلوم كلها مرت بتلك الأطوار الثلاثة، ولكن كونت يفسر الفارق بدرجة التطور وبتأخر العلوم الاجتماعية في سباق التطور.
أما ألكسسي دي توكفيل صاحب كتاب ” الديمقراطية في أمريكا ” فقد انتقل بالفكر السياسي إلى قلب المنهج التجريبي حيث اعتمد أسلوب الرحلات العلمية الكشفية بغية التوصل إلى تفسير للوقائع والأحداث، فسافر إلى أمريكا، ووضع الفروض على طريقة المنهج التجريبي العلمي، فافترض أن عصراً تظلله الديمقراطية القائمة على المساواة يولد وشيكاً، وأن ميلاده سيكون في أمريكا، وذهب إلى هناك حيث يختبر صحة الفروض التي وضعها، ولم يعتمد على دراسة الوثائق وإنما أجرى المقابلات وتحرك بين الناس، وبرغم أنَّ فكرة الدراسة المعملية للظواهر السياسية والاجتماعية فكرة غلب عليها هاجس السباق مع العلوم الطبيعية؛ مما جعلها في كثير من الأحيان حبيسة المختبرات المادية الضيقة؛ إلا أنَّ البعض من أمثال مرسيل بريلو اعتبر توكفيل رائد البحث العلمي السياسي في العصر الحديث.
الليبرالية:
في خضم هذه الأحداث المتتالية، وفي ظل التطور الملحوظ في الفكر الغربي على وجه العموم وفي الفكر السياسي على وجه الخصوص، واتكاءً على نظرية الحقوق الطبيعية، وعلى التطور الذي طرأ على نظرية العقد الاجتماعي على يد روسو، نشأ ما يسمى في الفكر المعاصر بالليبرالية؛ فما هي الليبرالية؟
اختلف المنظرون لليبرالية في تحديد مفهومها؛ مما دعا كثيرًا من الكتاب أن يصرح بحيرته وعدم استطاعته الوقوف على تعريف محدد لها، فهذا – على سبيل المثال – (رونالد سترومبرج) يقول « والحق أن كلمة ليبرالية مصطلح عريض وغامض.. ولا يزال حتى يومنا هذا على حاله من الغموض والإبهام»
ولكن مع ذلك هناك تعريفات لليبرالية أحسبها كافية لإعطاء نبذة عنها، وإن كانت غير كافية للدراسة الوافية التي تطلع الدارس على مميزاتها وعيوبها بشكل عادل؛ فمن هذه التعريفات تعريف (لاشلييه): « الليبرالية هي الانفلات المطلق» وعرفها تومس هوبز بأنها:(غياب العوائق الخارجية التي تحد من قدرة الإنسان على أن يفعل ما يشاء)([29]).
ومهما حدث لليبرالية من تطور أو تغير تبقى خصائصها الأصلية معبرة عن حقيقتها شاهدة على جوهرها، وأهم خصائص الليبرالية: الفردية، والحرية، والعقلانية، ومن أبرز الذي أسسوا للفكر الليبرالي في الغرب: جون لوك وفوليتر روسو وأليكس دي توكفيل وجون استيوارت مل وآدم سميث وجيرمي بنثام.
لكن أبرزهم جميعاً آدم سميث وجون استيوارت مل، فآدم سميث هو القائل: «دعه يعمل دعه يمر» وجون ستيوارت مل هو المنظر الأكبر لهذا الفكر؛ فمن أقواله في كتابه (الحرية): « إن الإنسانية لتستفيد من ترك الأفراد أحرارًا يعيشون في الدنيا باختيارهم ويجرون في الحياة على مرادهم أضعاف ما تستفيد من إرغام كل فرد على التقيد بمشيئة من سواه والنزول على حكم غيره([30])» ويقول في كتابة: (أسس الليبرالية السياسية) «إن الفرد ليس مسئولًا عن أفعاله أمام المجتمع عندما تكون هذه الأفعال لا تمس أحدًا سواه»([31]).
والليبرالية تعتبر مذهبًا فكرياً عاماً، له تأثيره على ميادين كثيرة، ولكن تأثيره الأكبر كان على الميدانين السياسي والاقتصادي؛ ومن هنا كانت هناك ليبراليتان متعانقتان في الحياة الأوروبية: الليبرالية السياسية، والليبرالية الاقتصادية، قالليبرالية السياسية هي:«مذهب سياسي يرى أن من المستحسن أن تزاد إلى أبعد حد ممكن استقلالية السلطة التشريعية والسلطة القضائية بالنسبة إلى السلطة الإجرائية التنفيذية، وأن يعطى للمواطن أكبر قدر ممكن من الضمانات في مواجهة تعسف الحكم[32]، أما الليبرالية الاقتصادية فهي:«مذهب اقتصادي يرى أن الدولة لا ينبغي لها أن تتولى وظائف صناعية ولا وظائف تجارية، وأنها لا يحق لها التدخل في العلاقات الاقتصادية التي تقوم بين الأفراد والطبقات والأمم»([33]).
والاتجاه الفردي في الفكر الليبرالي مبنى على أن الفرد سابق للدولة والمجتمع، ورضاه بالدولة بموجب العقد الاجتماعي مبنى على تنازله عن جزء من حقوقه الشخصية لحماية الجزء الآخر؛ فيجب أن يكون تدخل الدولة في حدود تحقق المصالح للفرد؛ فالفرد هو الغاية وليس الدولة، ولا شك أن نشوء هذا الاتجاه كان بمثابة رد فعل للاتجاه المطلق الذي كان سائدًا في بداية الخلاص من سلطان الكنيسة، والذي كان يعطي الحق المطلق للحاكم في التدخل في كل شئون الأفراد([34]).
علاقة الليبرالية بالديمقراطية:
الديمقراطية مذهب أوربي الهوية، نشأ أول ما نشأ في أثينا، ثم قفز فوق القرون إلى أوربا المعاصرة، وهي تعني: حكم الشعب، وتقوم على أساس أن الشعب صاحب السيادة، وأنه مصدر السلطات، هذا هو جوهر الديمقراطية التي طبقت بصورة مباشرة في أثينا القديمة، ولما أرادت أوربا أن تأخذ بالديمقراطية – ولم تستطع أن تطبق الديمقراطية المباشرة لتعذر ذلك بسبب كثرة السكان واتساع نطاق الدولة – عملت بالديمقراطية غير المباشرة أو الديمقراطية النيابية.
لكن الديمقراطية عندما بعثت من جديد في أوربا الحديثة وجدت نفسها في بيئة جديدة، بينة مليئة بالأفكار وبالموروثات الحضارية الإنسانية، فبسطت يمينها على ذلك كله، ووضعت يدها عليه، ونسبته إليها، فأفادت بمبدأ الفصل بين السلطات، وأفادت بإعلان حقوق الإنسان.
ولا شك أن الليبرالية كان لها الأثر الأكبر في تطوير الديمقراطية، «فالفلسفة الليبرالية انطلقت في فهمها للديمقراطية من تحديد الإنسان تحديدًا مجردًا عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي الذي يعيش فيه.. فلم تأخذ بالاعتبار وضعه ككائن ضمن شكة من العلاقات الاجتماعية المميزة([35]).
وإذا كانت الديمقراطية الليبرالية قد أقرت المساواة السياسية، فألغت امتيازات الطبقة الأرستقراطية؛ فإنها – في المقابل – خلقت – تدريجيًا – حالة من اللامساواة الاقتصادية, لأنها أفضت إلى تكديس الثروات في أيدي الأغنياء على حساب سائر فئات الشعب؛ ما ترتب عليه جملة كبيرة من الآثار السلبية على الفرد الذي هو محور الارتكاز في الفلسفة الليبرالية؛ لذلك – ولأمر آخر سنذكره فيما بعد – اتجهت الليبرالية إلى مراعاة الجانب الاجتماعي، وتحورت من المذهب الفردي إلى المذهب الاجتماعي، ذلك الاتجاه المنادي بضرورة تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وبأهمية حماية الدولة لحقوق الأفراد من تفحش الرأسمالية([36]).
ونستطيع أن نقول: إن الديمقراطية الليبرالية مرت بمرحلتين تاريخيتين، امتازت الأولى بتطبيق المبادئ الديمقراطية النابعة من تحديد الديمقراطية تحديدًا نظريًا مجردًا عن الواقع المجتمعي، ومتأثرًا بالمذهب الفردي، وهذه هي الديمقراطية الكلاسيكية، بينما امتازت الثانية بالتحول الذي طرأ تحت تأثير الأزمة التي أحدثتها الرأسمالية، فتحولت إلى ديمقراطية ذات مضامين اقتصادية واجتماعية، إضافة إلى المضمون السياسي» ([37]).
لكن يبقى أن النظم الديمقراطية الليبرالية التي طبقت في أوربا الغريبة مهما تحورت تظل محتفظة بالمبادئ المشتركة بينها جميعًا» وهي: الشرعية، وسيادة الأمة، والفصل بين السلطات».
ومما تجدر الإشارة إليه أن من أهم أسباب تراجع الفكر الليبرالي عن غلوه في إقصاء الدولة عن التدخل في حياة الأفراد هو ظهور المذهب الاشتراكي الذي فضح الرأسمالية وأظهر عورات الديمقراطية الليبرالي الكلاسيكية، والمذهب الاشتراكي بشعبتيه: الاشتراكية والشيوعية قائم على نقيض المذهب الفردي الذي كرس للرأسمالية، وكان وبالًا على الأفراد المجتمعات معًا.
الماركسية والفكر الشيوعي:
كان لإرهاب الثورة الفرنسية، ولما تلاها من الحملات النابليونية التي هدمت دولاً أوربية قامت طويلاً على نظم دستورية، كان له أثره في بعث فلسفة سياسية جديدة، تكفر بالثورة الفرنسية وبالقانون الطبيعي الذي تولد منه المذهب الفردي وتولدت منه الليبرالية، ويعيد – في ثوب جديد – تمجيد الدولة القومية، وفي هذا السياق جاء فكر هيجل السياسي، الذي قام على الديالكتيك وما سماه الضرورة التاريخية، حيث يعتبر أن قوانين الفكر وقوانين الأحداث متماثلة في النهاية.
وتكمن أهمية هجوم هيجل – الألماني – على المذهب الفردي وعلى الثورة وعلى القانون الطبيعي في أنه لا يعبر – فقط – عن تجربة ألمانيا السياسية، وإنما يعبر عن تغيرات عميقة كانت آخذة في الظهور في مناخ الفكر السياسي في أوربا بأكملها؛ مما أعطى الفلسفة الألمانية في القرن التاسع عشر مركزاً قيادياً لم تتمكن من إحرازه قبل ذلك بأزمان.
وفكر هيجل يعتبر الممهد لظهور الفكر الشيوعي على يد ماركس؛ فلقد ” كان الخط المباشر للتطور يسير – بغير شك – من هيجل إلى ماركس، ثم إلى تاريخ النظرية الشيوعية فيما بعد، وهناك كانت نقطة الاتصال هي الديالكتيك الذي سلم به ماركس؛ باعتباره الكشف الذي توصلت إليه فلسفة هيجل … ولقد اعتبر ماركس قومية هيجل وتمجيده الدولة القومية تصورات صوفية أفسدت الديالكتيك، وبتأويله الديالكتيك بأنه التفسير الاقتصادي للتاريخ ظن ماركس أن بوسعه استبقاء المنهج كوسيلة علمية حقيقية لتفسير التاريخ الاجتماعي. ([38])
وبينما ظن هيجل أن التاريخ الأوربي يبلغ ذروته بقيام الشعوب الألمانية وبوصول ألمانيا إلى مركز الزعامة في القارة الأوربية؛ اعتقد ماركس أن التاريخ الاجتماعي يبلغ ذروته في قيام البروليتاريا، وتوقع أن تزحف تلك الطبقة لتشغل المكان المسيطر على العالم في العصر الحديث.
ومن هذه البذور نشأ الفكر الماركسي ثم تطور إلى النظرية الماركسية، التي صنعها: (إنجلز) و(ماركس) و(لينين)، والمفكرون والساسة الذين حذوا حذوهم في بداية القرن العشرين، أمثال: (تروتسكي) و(ستالين) و(خروتشوف) و(ماوتسيتونغ) وغيرهم.
وملخص النظرية الماركسية: أن المجتمع البشري لم يكن في مبدأ أمره بحاجة إلى الدولة، وإنما نشأت الدولة كأثر ضروري لانقسام المجتمع إلى طبقات، ولا وجود للدولة إلا مع وجود التناقضات الطبقية، وهي جهاز سيطرة وقمع طبقي، وهي انعكاس لقوة الطبقة المسيطرة (البرجوازية)، والدولة البرجوازية في حقيقتها ظاهرة قهر وإكراه لحساب الطبقة البرجوازية على حساب (البروليتاريا) وكون الدولة ناتجة عن الصراع الطبقي فهي تحمل في داخلها بذور فنائها، وهي بنية فوقية مصيرها الانحلال والزوال، والذي سيتم عبر مراحل ثلاثة كبرى:
المرحلة الأولى: مرحلة ديكتاتورية البروليتاريا عن طريق الثورة، والتي ستضطر إلى إنشاء الدولة من أجل تنظيم العنف بغرض تحطيم البرجوازية وقمع مقاومة المستثمرين.
المرحلة الثانية: مرحلة الاشتراكية، وفيها تمتلك الدولة – بإسم المجتمع – وسائل الإنتاج، وتلغي الملكية الفردية لعلاقات الانتاج، وفيها يطبق المبدأ القائل: « لكل حسب عمله »، وتبقى ممارسة الدكتاتورية من قبل البروليتاريا أمراً ضرورياً من أجل الحيلولة دون رجوع البرجوازية.
المرحلة الثالثة: «مرحلة الشيوعية وزوال الدولة، وذلك عندما تزول الطبقية تماماً» ويزول بزوالها الصراع الطبقي، الذي هو المبرر الوحيد لقيام الدولة، وعندئذ يطبق مبدأ:«من كل حسب كفاءته، ولكل حسب حاجته».
وعلى هذا الفكر قامت الثورة البلشفية في الاتحاد السوفياتي، وارتكبت في سبيل ذلك المجازر تلو المجازر، وأبادت شعوباً وقبائل لا تدري فيم تقتل أو لماذا تباد!! وما إن نشأت الدولة الشيوعية (دولة البروليتاريا) وما إن شيدت وصارت قوة عظمى حتى تهاوت وانهارت لينهار معها بنيان النظرية الماركسية، في تطور سريع مفاجئ عبر ما سمي بـ (البريستوريكا).
وكان سقوطها سريعًا، وكان كذلك سقوطاً مروعاً مفزعًا، إذ أعطى المبرر لليبرالية العاتية أن تعود من جديد، وأن تحاول فرض سيطرتها على العالم، باسم التحول الديموقراطي الضروري، وفي صورة العولمة السياسية والاقتصادية.
راجع: أسس الفكر السياسي الحديث (عصر النهضة) الجزء الأول – كوينتن سكنر – ت: د. حيدر حاج إسماعيل – المنظمة العربية للترجمة – توزيع مركز دراسات الوحدة العربية – بيروت – لبنان – ط أولى 2012م صــــــــــــ 39-55
راجع: قصة الحضارة – وِل ديورَانت ت: زكي نجيب محمُود وآخرين – دار الجيل بيروت لبنان – ط: 1988م 18/4-13
راجع: تطور الفكر السياسي ج3 ص 25- 30
انظر: علم السياسة، (ص107).
تطور الفكر السياسي ج3 ص 39
انظر المدخل في علم السياسة للدكتور بطرس غالي وزميله، (ص95).
كتاب الأمير لميكيافيلي، تعريب خير حماد، المكتب التجاري بيروت، ط1، 1962، الباب السابع.
مدخل إلى علم السياسة، د. عصام سليمان.
راجع: تاريخ أوربا من النهضة إلى الحرب الباردة ص 39
راجع: تاريخ أوربا من عصر النهضة إلى الحرب الباردة صـ 47 وما بعدها
السابق (ص47).
تطور الفكر السياسي ج3 ص 64
راجع: تطور الفكر السياسي ج3 ص 70
راجع: تاريخ أوربا من النهضة إلى الحرب الباردة ص 54
راجع: تطور الفكر السياسي ج3 77-86
راجع: المدخل في علم السياسة / بطرس غالي وزميلة ص 185.
النظم السياسية. د ثروت بدوي ص 38، دار النهضة العربية ط سنة 2005م.
راجع: تطور الفكر السياسي ج3 ص 118
راجع المدخل في علم السياسية ص 176.
راجع المدخل في علم السياسة 177.
السابق ص 177.
راجع علم السياسة ص 115.
راجع: تاريخ أوربا من عصر النهضة إلى الحرب الباردة صـ 77
راجع: تاريخ أوربا من بداية عصر النهضة إلى نهاية الحرب الباردة ص 83- 84
راجع: تطور الفكر السياسي ج4 ص 36-37
راجع: فصول روح الشرائع ل منتسكيو – ترجمة: عادل زعيتر – دار المعارف – مصر – ط 1953م
راجع: تاريخ أوربا من بداية عصر النهضة إلى نهاية الحرب الباردة صـ 84
مدخل إلى العلوم السياسية صـ 74
موسوعة الفلسفة: د.عبد الرحمن بدوي 1/460
الحرية – جون ستيوارت مل ترجمة: طه السباعي – مكتبة الشعب – القاهرة ط أولى 1922م ص 132.
أسس الليبرالية السياسية – جون ستيوارت مل – ترجمة: إمام عبد الفتاح إمام وميشيل متياس – مكتبة مدبولي – القاهرة – ط 1996م- القسم الثاني ص 231
موسوعة لالاند 2/725 القسم الثاني ص 231.
موسوعة لالاند 2/726.
انظر: علم السياسة ص 220 – 224.
مدخل إلى علم السياسة. د عصام سليمان ص 223.
راجح علم السياسة ص 228 – 231.
مدخل إلى علم السياسة: د. عصام سليمان ص 219.
تطور الفكر السياسي ج4 ص 160